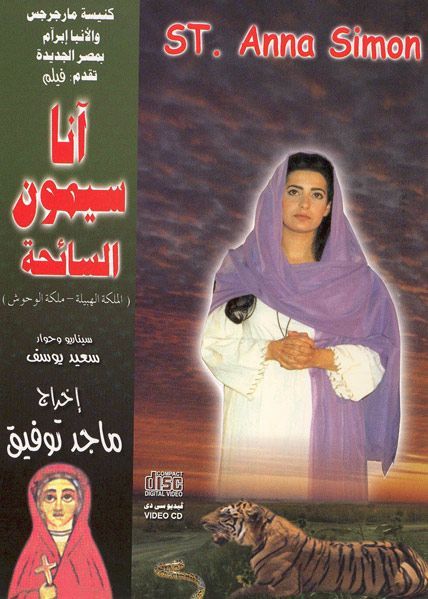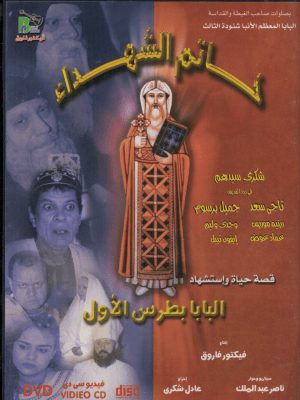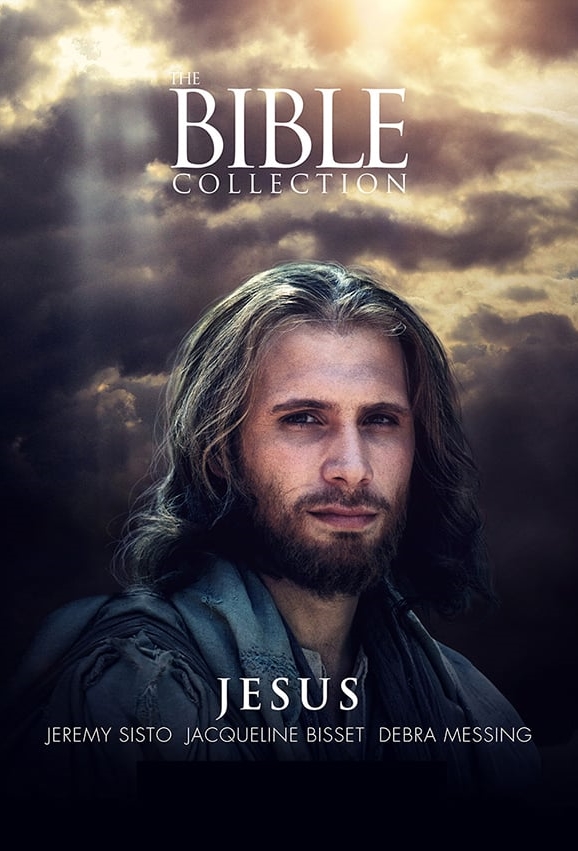10: 25- 37
من كان قريب الجريح؟ الذي عامله بالرحمة. إذهب أنت واعمل مثله.
نجد ملخصاً عن الشريعة في الحوار بين يسوع ومعلّم الناموس: “ما الذي كُتب؟ ماذا تقرأ”؟ ودعا يسوع محاوره أن يقرأ الكتاب المقدس قراءة تدلّ على فهم نصوصه. تجاوز معلّم الشريعة المحنة فربط بين نصين بعيدين الواحد عن الآخر. تث 6: 5: “أحب الرب إلهك بكل قلبك، وكل نفسك، وكل قوتك وكل فكرك”. ثم لا 19: 18: “أحبب قريبك مثلما تحب نفسك”.
إذا كان فعل “أحب” جزء من الألفاظ القانونية في العالم السامي (أحب أي أدّى للقريب ما يحق له)، فالصفات الحارة التي تزيّن هذا الفعل (من كل قلبك…) تدل على أن العدالة تؤدّى كفعلة تفيض رحمةً وحناناً. نحن أمام عبارة شهيرة: “أحبب قريبك كما تحب نفسك”. فنحن نقرأ في “مقالة الآباء” هذا القول الجميل: “إذا كنت لا أحب نفسي، فمن يحبها؟ وإذا كنت لا أحب إلا نفسي، فأي إنسان أنا”؟
ودعي معلّم الناموس الى أن يضع قيد العمل ما قاله (إعمل هذا فتحيا). ولكنه طرح سؤالاً: من هو قريبي؟ يعني: ما هي واجباتي؟ من يجب أن أحبّ؟ وتصّرف يسوع كعادته حين يريد أن ينقل تعليماً جديداً، أو أن يُسمع الناس كلمة صعبة، فاتخذ طريق الخبر ليقدّم جواباً.
دُعي يسوع لكي يلقي الضوء على حدود القريب، فقلب بالمفهوم المعروف (الكلاسيكي) ليهزّ السامع. القريب هو الأخ اليهودي، الفريسي أو الاسياني. أما يسوع فقدّم لنا رجلاً مجهولاً، لا هويّة له ولا إسم. وجهه يتحوّل حسب الناس الذين يلتقي بهم في طريقه. في نظر اللصوص، هو إنسان هجموا عليه وتركوه بين حي وميت. في نظر الكاهن واللاوي، هو إنسان نبتعد عنه. في نظر السامري، هو إنسان نقترب منه ونقدّم له المساعدة. ما عمله اللصوص (عرّوه، ضربوه…) يقابل ما عمله السامري (أشفق عليه، دنا منه). وسيكون صاحب الفندق مساعداً للسامري في “إعادة الحياة” إلى هذا الجريح.
وإذا عدنا إلى سؤال معلّم الناموس، نلاحظ أن يسوع لم يقدّم لنا قريباً جامداً (لا يتحرّك)، بل وضع أمامنا أناساً يبتعدون أو يقتربون. بدأ يسوع فتحدّث عن اللصوص في دورهم العدواني العنيف. ثم ظهر شخصان دينيان يُفترض أنهما متخصّصان في حبّ الله: الكاهن واللاوي. إبتعدا كلاهما، ولا نعرف سبباً لابتعادهما. أما السامري الذي يعتبره اليهود رجلاً ضلّ في حبه لله، فصار قريباً. أحبّ بالعمل والحق لا باللسان والكلام.
إذا قابلنا القسم الأول من هذا النص الذي يتوسّع في متطلّبة حبّ الله (من كل قلبك، من كل نفسك)، مع عمل السامري، نجد أن حبّه واسع كحب الله: رآه، تحنّن عليه، دنا منه، ضمّد جراحه… وهكذا فالوصيتان اللتان هما في الواقع وصية واحدة تفرضان الإلتزام عينه. والجواب على الوصية الثانية يدل على صدقنا في الأمانة للوصية الأولى.
سمعنا موسى يمتدح شريعة الله. فهي في نظره أكثر من شيء خارجي تسحقنا أو تضايقنا. إنها كلمة يوجّهها الله إلى الذين يحبّهم، فتحرّك فيهم اندفاعاً داخلياً يجعلهم يرغبون في معرفة الله. كما يدفعهم للبحث عنه دوماً، سواء تلمّسوه في الظلمة أو ساروا إليه في النور. وهذه الشريعة ليست في السماء، بعيدة عن متناولنا. وليست في البحار، بل هي قريبة منا. إنها كلمة الله في قلبنا. إنها نداء الله في ضميرنا، إنها أفضل ما في حياتنا.
ماذا تقول هذه الشريعة؟ هذا ما يشرحه مثل السامري الصالح: كن صديق الجميع وخادمهم على مثال السامري وعلى مثال المسيح نفسه. هذا هو قلب الإنجيل. هذا هو التأكيد المحوري في الإنجيل. يجب علينا أن نحبّ لأننا نستطيع أن نحبّ. إن شريعة الله تتوافق مع شخصنا في مخطّطه. الحب هو فينا. ونحن مدعوّون إلى الحب.
نحن لسنا مسلَّمين إلى الشر والضلال والصدفة والضرورة التي تفرض نفسها علينا. نحن المسيحيين متفائلون، وهذا واقع لا نتخلّى عنه مهما كانت آراء الناس فينا. فإذا كان الأمر بعيداً عنا، فهذا يعني أن شريعة الله ليست في قلوبنا كينبوع رجاء لا ينضب. وهي تقنعنا أن لله هدفاً بالنسبة إلى كل واحد منا. هو يحلم من أجلنا، وحلمه حلمُ حب، ومخطّط وحدة تجمع في الأخوّة جميع البشر.
ومخطّط الله هذا، يصوّره لنا القديس بولس محقَّقا في المسيح. فكل ما هو جميل وصالح يأتي منه. فيه خُلق كل شيء. ومعه يسير كل إنسان إلى الله. لا شك في أن خلاص البشرية يعرف الصيرورة، يسير إلى نهاية الأزمنة. ولكن الحب لا ينتظر. هو حاضر وفاعل كل يوم في العالم. وحيث يكون الحب، هناك يتحقّق مخطّط الله دون أن ينتظر.
حين صنع المسيح السلام بدم صليبه، أراد، وهو ينبوع كل حبّ، أن يجمع ويصالح اخوته جميعاً. فالسرّ المسيحي يتضمّن بُعداً مأساوياً: إنه يدلّ على جدّية عطاء الذات، وعلى حقيقة حب يريد سعادة الآخر قبل سعادته الخاصة. نسير على خطى المسيح، فتصبح طريقنا تسلّقاً صعباً، ولكنها لا تكون منهكة. هذا ما قال موسى باسم الرب: “هذه الشريعة لا تتعدّى قواك ولا هي بعيدة عن متناولك”. ووعدنا يسوع فقال: “أنا أريحكم، لأن نيري ليّن وحملي خفيف”. وهكذا نستطيع أن ننشد: “شريعتك هي حق، وكلمتك خلاص”.
رب، أنت تحدّثنا بصورة مباشرة، دون لفّ ولا دوران. تندّد بكل ما فيه خبث ورياء: خبثي وخبث قريبي، خبث الكاهن واللاوي، خبث أصحاب “العبادات” الذي يقولون يا رب، يا رب، ولكن قلبهم بعيد من الرب.
رب، أنت تدفعنا لكي نطرح السؤال على نفوسنا. تدعونا إلى أن لا نخلط بين ممارسة ديانة ومتطلّبات التوبة الحقة. مزّقوا قلوبكم، لا ثيابكم. تذكّرنا أنه لا يكفي أن نؤمن بعقولنا (أي في النظريات)، بل بقلبنا وبأيدينا.
رب، إمنح كل إنسان، أكان ممارساً أم لا، أن يكون قريب كل شخص يلتقيه، كل شخص جُرح في جسده أو في قلبه، فنساه الناس على قارعة الطريق. وأعطِ كل واحد منا أن يكون سامرياً صالحاً، لتنمو مملكة الحب على الأرض، حيث لا يهودي ولا يوناني ولا وثني، بل أبناء أب واحد هو الآب السماوي