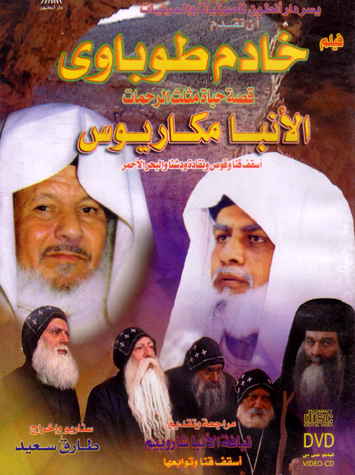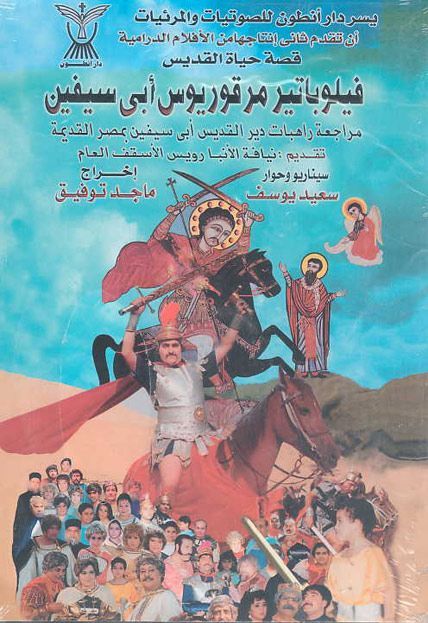المزمور الخمسون
1. المزمور 50 هو مزمور كُتب بلغة بعد الجلاء (وجود تعابير أراميّة)، ولكن الأفكار التي طرحها مأخوذة من الأنبياء (الذين عاشوا الجلاء). عرض كلامه على طريقتهم بشكل دعوى يُقيمها الله على إسرائيل بعد أن نبّهه إلى سلوكه وتصرّفاته. ينشده المرتّل، وهمّه أن يُدخل في الآذان والقلوب المعنى المتجدّد للعهد، كما ظهر في كتب موسى والأنبياء (رج خر 19:- 24؛ تث 31- 33) وخصوصًا أشعيا (1: 1 ي: “إستمعي أيتها السماوات، وأنصتي أيتها الأرض… ويل للأمة الخاطئة… تركوا الرب…”). يسمعه الحجّاج في أورشليم، في عيد المظال أو في غيره من الأعياد، فيذكّرهم بالعهد، ولكن بروح جديدة، في إطار إحتفال ليتورجي: يجتمع الشعب، ويقدّم الكهنة الذبائح، ويستمع المؤمنون إلى الكلمات النبويّة، ويشترك المتعاهدون بالذبيحة علامة وعربونًا لشركة المصالح والعواطف. وعندما يكون المتعاهدان الله السامي من جهة والانسان من جهة ثانية، فهذه الشركة تعني أن الله يحمي شعبه، وأن على الانسان أن يسير بحسب طرق الرب.
2. تعليم عن عبادة الله الحقّة.
آ 1- 6: نداء إلى الشعب خلال حفلة الليتورجيا: الله يقيم دعوى على شعبه.
آ 7- 15: وعظ للشعب وحثّه على الرجوع إلى الله. الشكوى الأولى: لأنه لم يفهم معنى الذبائح.
آ 16- 21: إسرائيل شعب شرّير وغير مؤمن. الشكوى الثانية: لأنه ينقض العهد في تصرّفه مع القريب.
آ 22- 23: الخاتمة. تنبيه أخير: إفهموا هذا أيها الناسون الله.
* ونتوقّف على بعض التفاصيل في آ 1: إله الآلهة (في الترجمة السبعينيّة: الإله القدير) هو أفعل التفضيل للألوهة. الله يدعو الأرض لتحضر وتشهد. آ 2: ظهور الرب هذا ليس على جبل سيناء، بل على جبل صهيون وفي أورشليم، حيث تقدّم الذبائح. أورشليم هي عاصمة إسرائيل، لا بل عاصمة الكون كله. أورشليم جميلة، ولكن الله أجمل. الهيكل جميل باحتفالاته، ولكنه يأخذ جماله من الله الحاضر وسط شعبه. آ 3: الله يأتي، لا ليصمت، وان غطّى على صوته غناء الشعب وطلبات الكهنة والمغنّين. لن يسكت هذه المرّة، بسم سيتكلّم، لا ليهنِّئ شعبه، بل ليدينه. فالنار الآكلة (البرق) تسبقه، والعاصفة تحيط به. آ 4: ولهذا ينادي السماء والأرض لتسمعا ما يقوله الديّان السامي (آ 5) وهو يعطي أمرًا: إجمعوا لي كلّ شعبي، كلّ الأتقياء المؤمنين (ولكنهم بالواقع غير مؤمنين) الذي قطعوا عهدًا مع الربّ، والربّ سوف يدينهم. وبالآية 6، ينتهي مشهدُ الظهور، ويتبعه الإرشاد الأخلاقي.
* ابتداءً من آ 7، يُخاصم الله شعبه، ويُقيم عليه دعوى. الله هو الله وليس كباقي الآلهة الذين يستخدمهم الوثنيون بدلاً من أن يخدموهم. وتبدأ شكوى الله على شعبه (آ 8)، لا لأنه لم يقدّم ذبائح للرب (لا أوبّخك، كلمة كلّها سخرية)، بل لأن هذه الذبائح تجعل إسرائيل يعتدّ بإيمانه بينما هو يتهرّب من ممارسة شريعة الله. فهذه الذبائح التي تهدف إلى تذكيرنا برحمة الله وتساميه، صارت وسيلة يؤكّد بها الانسان كبرياءه وخطيئته، فيحسب أنه يستطيع أن يشتري الله وسكوتَه بذبيحة يقدّمها إليه. ولكنّ الله ليس بحاجة إلى حيوانات تُذبح له (آ 9). فإن أراد ذبائح (آ 10) فهو لا يريد أن يكون تابعًا للبشر، ولهذا يأخذ من حيوان البر (لا الحيوانات الداجنة) الذي يعرفه، إذ قد خلقه وهو يقيته (آ 11). كل شيء للربّ، وكل شيء من أجل الربّ. يحسب الشعب أنه يُعطي الله شيئًا عندما يقدّم إليه ذبيحة، وينسى أنه يحصل بذلك على سبيل للتقرّب إليه. يحسب الشعب أنه يطعم الربّ من ذبائحه، بينما الرب يُغنيه بخبزه ورحمته. ونصل إلى آ 12- 13: يجب على الانسان أن يفهم أن الله لا يحتاج إلى شيء ولا يطلب شيئًا، لأنه حبّ وعطاء. وتأتي يد كاهن فيما بعد فتُقحم آ 14- 15 لتبيّن أن الله لا يرفض الذبيحة كذبيحة، بل تصرّفَ الانسان خلال الذبائح التي تتكوّن من ذبيحة حمد وإيفاء نذور.
* ويتابع الله حديثه إلى الشرير (رمز الشعب المنافق) الذي يعشّر النعنع والسذاب وكل البقول، ويتعدّى محبّة الله (مت 23: 23؛ لو 11: 42). يردّد الشريعة، يتحدّث بها، يكتبها (آ 16)، ولكنه لا يعمل بها (آ 17). والخطايا هي: السرقة والزنى وزلاّت اللسان (آ 18- 20). وتردّد آ 21 ما قيل في آ 3: حسبَت أنني سأسكت، وقد أردتَ أن ترشيَني كما ترشي القاضيَ. حسبتني أنني مثلك. كوَّنتني صورة على مثالك وصنمًا من الأصنام. بدلاً من أن تسمع لي، وتعمل بما أقوله لك، عملت لكَ إلهًا يسمع لك ويعمل بما تعلّم. لن يسكت الله تجاه هذه الوثنيّة، لأن خدمته تعني قبل كل شيء خدمة الآخرين. نحن أمام إله لا يريد من الناس عبادة لا ترتبط بممارسة واجبات العدالة والمحبّة. ويعود في آ 22 إلى التهديد قبل أن تأتي يدُ الكاهن مرّة ثانيّة (في آ 23) فتجمع بهن ذبيحة حمد يقدّمها الانسان، وحياة مستقيمة يعيشها فيرضى الله عنه ويُريه خلاصه.
3. يبدأ المزمور بذكر ظهور الله على جبل سيناء، وهذا الظهور يعيشه الشعب في احتفالاته على جبل صهيون الذي غمره الله بمجده يوم اختاره مسكنًا له. ينتظر الشعب حدثًا منظورًا سيتمّ الآن ليُعلنَ عن نهاية الأزمنة (أش 64: 1: “ليتك تشقّ السماوات وتنزل”؛ 66: 15: “هوذا الرب يأتي ومعه النار”). ويتصوّر المرتّل ظهورَ الله الذي جاء ليدين شعبه ويسترجع حقّه الذي عبثَ به الشعبُ المختار، فيدعو السماء والأرض إلى المحكمة لإدلاء الشهادة (أش 11: 2؛ تث 31: 28؛ مي 6: 1- 2: “اسمعي أيتها الجبال خصومة الرب ودعواه”).
* ما هو موضوع الدعوى؟ العهد الذي قُطع في الماضي بدأ الذبيحة (خر 24: 5 ي): أخذ موسى كتاب العهد فتلاه على مسامع الشعب. فقالوا: كلّ ما تكلّم به الربّ نفعله ونأتمر به. وهذا العهد هو حدث يتذكّره الشعب في كل ذبيحة وبالأخص في ذبيحة يُحرق فيها الشحم على المذبح، وتُعطى حصّة للكهنة، والباقي يأكله مقدّم الذبيحة مع أهله وأصحابه. ولكنّ الشعب نسي ما قاله الأنبياء، بأن جوهر العهد لا يقوم بالذبيحة، وأن الله المتسامي لا يعيش من لحوم الذبائح (كما كانوا يقولون عن الآلهة الوثنيّة). هل يظنّ الانسان أنه يعطي الله شيئًا، وهل نسي أن كل شيء هو مُلك الله الذي يعطي الانسان كل شيء؟ فليقرّ الانسان في مديحه وشكره بفضل الرب عليه.
* يقدّم الشعب في إسرائيل ذبيحة الحمد (آ 15، 23)، ولكنه ينسى أن يتوجّه إلى الربّ في صلاة شخصيّة خارجة من أعماق قلبه، تكوّن جوهر لقاء الانسان بالله من خلال الليتورجيا (هو 14: 3: “خذوا معكم كلام قلوبكم لا ذبائح عجولكم، وارجعوا إلى الرب”). ونسيَ الإنسان أيضًا أن الصلاة الحقيقيّة ليست فقط علمًا ومعرفة وإيرادًا للنصوص اللاهوتيّة (خر 24: 7)، بل ممارسة لفرائض الوصايا العشر. والمزمور يشدّد على أخلاقيّة العلاقات مع القريب، وخصوصًا في ما يتعلّق بالوصايا الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، فنقرأ في آ 18: “إذا رأيت سارقًا صاحبته، ومع الزناة جعلت نصيبك. تُطلق فمك للسوء ولسانك يختلق المكر”… وهذه الأخلاقيّة شدّد عليها الأنبياء فقال عاموس (5: 11): “بما أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه حصَّته من القمح، فأنتم تبنون بيوتًا… ولا تسكنون فيها”. وأشعيا (1: 11): “ما فائدتي من كثرة ذبائحكم”؟ وهوشع (6: 6): “أردت رحمة لا ذبيحة”. وميخا (6: 8): “بيَّن لك الربُ أيها الانسان ما هو صالح”. وإرميا (7: 21): “إجمعوا محرقاتكم إلى ذبائحكم، وكُلوا لحمها”. بهذه الروح عينها كُتبت الآية الأخيرة من المزمور: ذبيحةُ الحمد التي تمجّد الله والتي تعطي الخلاص هي أن يقوّم الانسان طريقه في علاقته مع القريب.
4. المزمور 50 يستعيد تعليم الأنبياء في جوهره، فيدلّ على إرادة الله بالنسبة إلى الذبائح وأفعال العبادة. ينطلق منها فيصل إلى تعليم المسيح حيث المحبّة تفوق الذبائح (مر 12: 33؛ مت 5: 23؛ 9: 13). إن يسوع يُعطي في علاقته مع الله الآب المكانَ الأول للعبادة والشكر (مر 5: 16؛ لو 7: 16). ولما أعطانا سرّ الأفخارستيا، أي سرَّ الحمد والشكر، طلب منا المحبّة قبل الاشتراك بقرباننا (مت 5: 23)، وعلّمنا أن لا معنى لقبول الإفخارستيا بدون محبّة القريب، لأ من لا يحبّ قريبه ليس من الله (1 يو 3: 10).
5. عيد العهد
تعود آيات هذا المزمور إلى نصوص من الخروج (ف 19- 24) والتثنية (ف 31- 33) وأشعيا (ف 1)، أي إلى كتب تُورد قصّة بني إسرائيل، وتُدخلنا في عالم ليتورجي. كل هذا دفعَ النقّاد لأن يتحدّثوا عن عيد العهد. عن عيد بدأ قديمًا وكان يتجدّد مرّة كل سنة. فالأمر واضح في سفر الخروج. فبعد أن تلا موسى الشرائع، قال الشعبُ بصوت واحد: “كل الكلمات التي قالها الرب نحفظها ونعمل بها”. ثم قدّم موسى ذبيحة. وبعد أن قرأ كتاب العهد قال: “هذا هو دم العهد الذي قطعه الرب معكم على أساس هذه الكلمات” (خر 24: 3- 9). في سفر التثنية نقرأ أن موسى كتب هذه الشريعة وأعطاها للكهنة بني لاوي الذين يحملون تابوت عهد الرب، ولكل شيوخ إسرائيل. وأمرهم موسى: في نهاية السنة السابعة، في عيد المظال، حين يأتي كل إسرائيل ليروا وجه الرب إلهك في المكان الذي اختاره، تقرأ هذه الشريعة أمام كل إسرائيل فيسمعها (تث 31: 9- 11). أما إطار كلمات أشعيا (ف 1) فهو عيد العهد. وهذا ما نجده في المزمور 50 وكذلك في المزامير 78، 81، 105.
ونشير هنا إلى أن ذكر العهد وحقيقته ظلاَّ حيّين في تقوى بني إسرائيل وشعائر عبادتهم. فالعيد وُجد، وكان قلبه تجديد العهد. يتذكّر الشعب في عيد المظال بنودَ هذا العهد ويقرأونها وكأنها تتوجّه إليهم الآن.
6. “أدعني في يوم الضيق. أخلّصك فتمجّدني”. يجب أن لا تعتدّ بقواك. فما تملك هو وهم وسراب. “أدعني في يوم ضيقك. أخلّصك فتمجّدني”. لهذا تركت الغمّ يأتي عليك. فلو لم تعرفه لما كنت دعوتني. وحين تدعوني، أستعدّ لكي أنجّيك. وحين أنجّيك تمجّدني بحيث لا تبتعد عني أبدًا. كان إنسان مخدّرًا، وبردت حرارة صلاته، عند ذاك قال: “لقيت الغمّ والحزن، ودعوت اسم الربّ” (115: 3). فمن أجل خيره لقي الغمّ، بعد أن كانت خطاياه تدخل الهريان إليه، فما عاد يحسّ بشيء. فكان الغمّ مبضعًا يُحرق ويقطع.
أيها الإخوة، هناك غمّ يراه كل واحد غمًا. وهو كثير لدى البشر. هذا تلقّى خسارة. وذاك يبقى حيًا بعد أن فقد عزيز له. وآخر يعيش في المنفى بعيدًا عن أرضه، ويوّد العودة بعد أن صار البُعد لا يُطاق. وآخر رأى البَرد يدمّر كرمه… فهل هناك وقت يكون فيه الانسان بعيدًا عن الحزن؟ لهذا ندعو الربّ، وهو وحده يعلّمنا كيف نتألّم بصبر، ويشفينا. هو يعرف أنه لا يجب أن نجرب فوق طاقتنا. فلندْعُه في ضيقاتنا.
ويبقى الحزن الأكبر، حزن المنفى الذي نعيش فيه. فهذه الحالة التي ما زلنا فيها بعيدين عن الله، حيث تتقاذفنا التجارب والصعوبات، حيث لا نستطيع أن نبعد القلق عنا، ذاك هو الغمّ الأكبر. لا شكّ في أننا لا نجد هنا هذا الاطمئنان الذي وعدنا الله به. فمن لا يحسّ بهذا الحزن الذي يتأتّى من منفاه، لا يفكّر أن يعود إلى وطنه. هذا هو غمّنا يا إخوتي.
قد نعطي خبزًا لجائع أو غريب. قد نساعد البائس والمتألّم. ولكن تبقى السعادة الكبرى أن نكون حيث لا فقير يحتاج إلى طعام، وغريب إلى مأوى، ومريض إلى زيارة، وبائس إلى لباس. ففي السماء كل شيء عظيم، كل شيء حقّ، كل شيء مقدّس، كل شيء أبدي. هناك يكون البرّ والعدل خبزنا، والحكمة شرابنا، ونرتدي الخلود ويكون مسكننا أبديًا. هل يتغلغل الحزن إلى هناك؟ والتعب المضني؟ كلا. فلا موت. ولا خلاف، بل سلام وهدوء وفرح وبرّ الله. لا وجه يُظهر المعاداة ولا صديق يتبدّل. فيا لسعادتنا عند ذاك” (أوغسطينس).