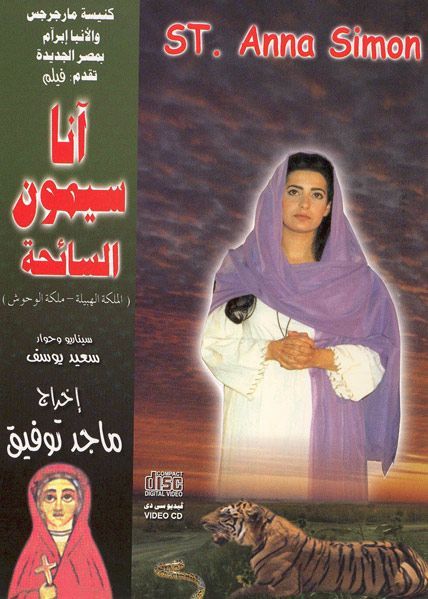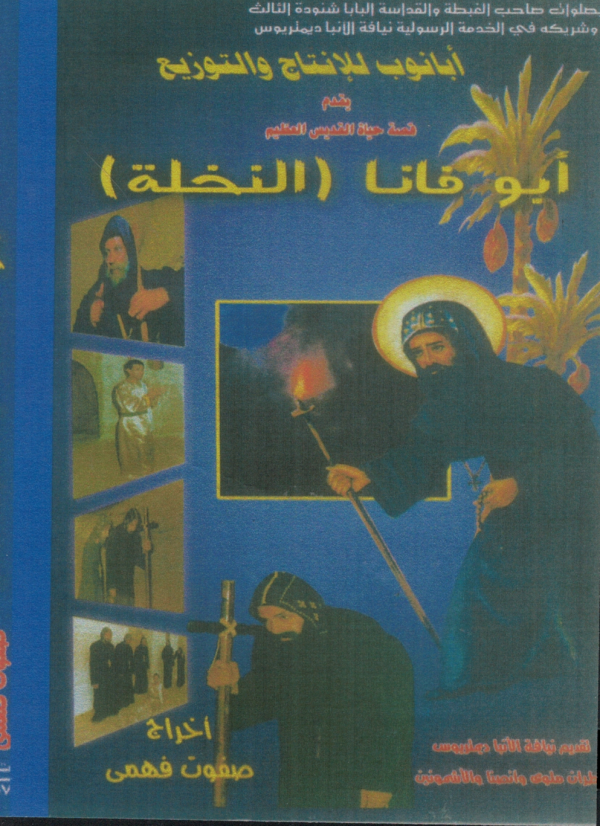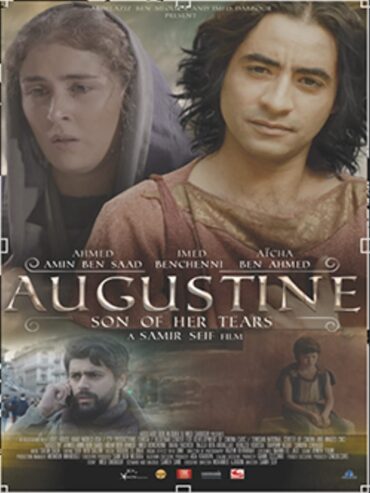القصة
الخامسة
الستارتس:
كان عام قد مضى على آخر لقاء لي بالسائح، وإذا – أخيراً – قرع مكتوم على الباب
وصوت متوسل يبشران بوصول هذا الأخ الممتلئ ورعاً.
–
أدخل أيها الأخ العزيز، ولنشكر الله معاً إذ قد بارك مسيرك وأعادك إلينا.
السائح:
المجد والحمد للآب العلي على صلاحه في كل شيء، فليأمر بما يشاء، وأمره دوماً لما
فيه خيرنا نحن السائحين والغرباء في أرض غريبة. هاأنذا، أنا الخاطئ، الذي تركك
العام الفائت والذي فكر مجدداً – بنعمة الله – أن من الخليق به لقاء ترحيبك الباش
وسماعه. ولا شك في أنك تتوقع مني وصفاً كاملاً لمدينة الله المقدسة أورشليم، التي
كانت نفسي بشوق إليها، وحيث كنت أنوي الذهاب بحزم. لكن رغائبنا لا تتحقق دائماً
وهذه كانت حالي. وليس في الأمر من عجب: فكيف يمكن التفكير – وأنا خاطئ – بأني
أستحق أن أطأ تلك الأرض المقدسة التي تركت قدما سيدنا يسوع المسيح أثرهما فيها؟
تذكُرُ
– يا أبت – أني تركت هذا المكان، في العام الفائت بصحبة شيخ أصم، وأنه كان معي
رسالة تاجر من أركوتسك إلى ابنه في مدينة أوديسا يسأله فيها أن يرسلني إلى القدس.
ولقد بلغنا أوديسا من غير عثرات، في زمن قصير، وسرعان ما حجز رفيقي لسفره إلى
القسطنطينية، ثم سافر. أما أنا، فأخذت أفتش عن ابن التاجر، على عنوان الرسالة. ولم
يطل بي الوقت حتى وجدت بيته، غير أني فوجئت وحزنت إذ علمت أن من أحسن إلي لم يعد
على قيد الحياة. فلقد توفي منذ ثلاثة أسابيع على إثر مرض لم يمهله. هبط هذا من
عزمي إلا أني سلمت أمري لقدرة الله تعالى.
كان
البيت كله غارقاً في الحزن، وكانت الأرملة، الباقية مع أولاد ثلاثة، على شيء من
الأسى كثير بحيث كانت تبكي طوال الوقت، وكان يغمى عليها مراراً في اليوم الواحد
لشدة الحزن. كان حزنها هذا شديداً بحيث بعث على الظن أنها هي الأخرى لن تعيش
طويلاً. لكنها، في غمرة هذا كله أحسنت ضيافتي، غير أنها لم تستطع إرسالي إلى القدس
بسبب ما آلت إليه أعمالها من حال. سألتني أن أمكث معها زهاء الأسبوعين حتى يجيء
حموها إلى أوديسا، كما وعد، لكي ينظم الشؤون المالية للأسرة المنكوبة، فبقيت. ومضى
أسبوع، ثم شهر، فشهر ثان، ولكن التاجر، بدلاً من أن يحضر أرسل بكتاب يقول فيه إن
أعماله هو لم تكن لتسمح له بالتنقل ونصح الأرملة بأن تصرف مستخدميها وتذهب إليه
حالاً إلى مدينة اركوتسك. فدبت في البيت الحركة والصخب. ولما لاحظت أني ما عدت
أثير الاهتمام، شكرت لهم ضيافتهم واستأذنت بالانصراف، مرة جديدة، أجول عبر روسيا.
كنت
أفكر وأعيد التفكير. إلى أين عساي أذهب بعد اليوم؟ قر رأيي، في النهاية، أنه يناسب
أن أذهب أولاً إلى مدينة كييف التي لم أزرها لسنين عديدة. وعلى هذا انطلقت في
السير. وبديهي أنه كان يزعجني، أول الأمر، عدم تمكني من وفاء نذر لي للحج إلى القدس.
ولكني رأيت، بعد تفكير، أن هذا بالذات لم يحدث بدون عناية إلهية، فهدئت آملاً أن
يقبل الله المحب البشر النية بدل العمل، وألا يترك رحلتي هذه المبتورة من غير
فائدة روحية. ولقد كان الأمر كذلك، إذ التقيت أناساً علموني الكثير مما كنت أجهله،
وأناروا جوانب نفسي المظلمة، لما فيه خلاصي. ولو لم تضطرني الضرورة إلى هذه الرحلة
لما كنت التقيت هؤلاء المحسنين إلي روحياً.
كنت
أسير نهاراً بمعية صلاة يسوع، وفي المساء، عندما أتوقف للمبيت، كنت أقرأ
فيلوكاليتي لأوطد النفس وأحثها في صراعها ضد أعداء الخلاص غير المنظورين.
في
أثناء المسير، وعلى نحو سبعين فرسخاً من أوديسا، تيسر لي مشاهدة أمر عجيب. كان ثمة
قافلة طويلة من العربات المحملة بضائع، وكان عددها ثلاثين، على أقل تقدير.
تجاوزتها. كان السائق الأول، رئيس القافلة، يسير بقرب حصانه، يتبعه الآخرون زرافات
على مسافة قصيرة منه. كانت الطريق تحاذي مستنقعاً يتخلله تيار، فكان جليد الربيع
الذائب يجيش ويتراكم على الضفة بصوت رهيب.
فجأة
أوقف السائق الأمامي – وهو فتى يافع – حصانه، فتوقفت أيضاً بقية العربات كلها.
وتراكض السائقون التابعون نحوه، ورأوا أنه أخذ يتجرد من ثيابه فسألوه ما السبب.
فأجاب بأنه يشتهي السباحة في المستنقع. فجعل بعضهم – وقد دهشوا – يسخرون منه،
والبعض الآخر يلومه وينعته بالجنون، فيما حاول أكبرهم سناً – وهو أخوه – أن يمنعه
من السباحة، دافعاً إياه ليجعله يعود إلى السير. فامتنع الفتى ورفض الانصياع إلى
ما طلب منه. وعمد كثيرون من السائقين الشبان إلى ملء الدلاء التي يغسلون بها الخيل
من ماء المستنقع، ورشقوا بها الرجل الذي كان يريد السباحة، على رأسه تارة، والظهر
طوراً قائلين: (إليك، سنقوم نحن بتغسيلك). وما إن لامس الماء جسمه حتى هتف: (آه ما
أحسنه!) وجلس أرضاً، فيما استمروا هم في إلقاء الماء عليه. ثم استلقى بسرعة ومات.
فأخذهم كلهم الخوف، وهم لا يعلمون سبب حصول ما حصل. بقيت معهم ما يقارب الساعة، ثم
عدت إلى المسير. وبعد زهاء خمسة فراسخ، أبصرت بقرية يمر بها الطريق العام، وحين
دخولي إليها التقيت كاهناً مسناً يسير في الشارع. ارتأيت أن من المناسب أن أقص
عليه ما رأيت لتوي لأسأله رأيه فيه، فاصطحبني الكاهن إلى منزله، ورويت له الواقعة
وسألته تعليل هذا الحدث.
قال:
لا يسعني أيها الأخ العزيز، إلا أن أقول إن في الطبيعة أموراً كثيرة غريبة لا
يمكننا فهمها. وأظن أن هذا من تدبير الله الذي يبرز قدرته وعنايته في الطبيعة
بإحداثه أحياناً في نواميسها تغييرات مفاجئة تخرق العادة. ولقد وقع لي ذات مرة أن
شهدت حالة مشابهة لما حدثتني به. بالقرب من قريتنا واد عميق شديد الانحدار، ليس
بعريض لكن عمقه يبلغ زهاء السبعين قدماً، أو أكثر، والمرء يخاف النظر إلى قعره
المظلم. بني عليه جسر خشبي يعبره الناس. ثارت في صدر فلاح، من أبناء رعيتي، وهو رب
عائلة وقور محترم – رغبة لا تقاوَم في أن يلقي بنفسه من أعلى هذا الجسر الصغير إلى
أعماق الهوة. فكافح هذه الفكرة وقاوم ما به من دافع طيلة أسبوع. لكنه لم يعد في
إمكانه – آخر الأمر – أن يضبط نفسه. فنهض مبكراً، وخرج مندفعاً وقفز في الخلاء.
وسرعان ما سُمعت أنّاته، وأخرج من الوادي بمشقة. كانت ساقاه مهشمتين. ولما سئل عن
سبب سقوطه أجاب إنه بالرغم مما يقاسي من ألم شديد، فقد هدأ باله إذ نفذ الرغبة
التي لا تقاوم والتي كانت هاجسه لمدة أسبوع، هاجساً خاطر من أجله بحياته.
أمضى
هذا الرجل عاماً كاملاً في المستشفى قبل شفائه الناجز. ذهبت لأعوده، وكثيراً ما
التقيت الأطباء يحيطون به. وكنت مثلك الآن راغباً في الوقوف على سبب الحادثة. أجاب
الأطباء بالإجماع أنها نوع من (الهيجان). ولما سألتهم تفسيراً علمياً لهذا (الهيجان)
وكيف ينتاب الإنسان، لم أستطع الحصول على أكثر من قولهم إن هذا من أسرار الطبيعة
التي ليس تفسيرها في متناول العلم. أما أنا فقد رأيت أنه إذا ما أخذ المرء،
المواجه لأحد غوامض الطبيعة المماثلة، يتضرع إلى الله ويطلب مشورة الروحانيين، فإن
هذا (الهيجان) – على حد تعبير الأطباء – لن يتمكن في النهاية من الفوز. والحق إننا
نجد في الحياة البشرية أموراً كثيرة لا يمكننا أن نفهمها بجلية ووضوح.
وفيما
كنا نتكلم، حل الظلام وبت ليلتي عنده. وفي صبيحة اليوم التالي، أوفد المختار أمين
سره ليطلب من الكاهن دفن الميت في المقبرة، وليقول إن الأطباء لم يجدوا، بعد تشريح
الجثة، أياً من مظاهر (الهيجان) وأن الوفاة سببها نوبة قلبية مفاجئة.
فقال
لي الكاهن: ها أنت ذا ترى أن علم الطب لا يمكنه أن يعلل هذا الدافع الذي لا يقاوم
نحو الماء بأي تعليل دقيق.
وعلى
هذا، ودعت الكاهن وعدت إلى سابق مسيري. وبعد سفر عدة أيام، بلغت – وقد شعرت بالتعب
الشديد – مدينة تجارية هامة اسمها (بييلا تسيركوف). ولما كان المساء قد أتى، جعلت
أسعى إلى وجدان مكان أبيت فيه ليلتي. والتقيت في السوق رجلاً بدا عليه أنه سائح
أيضاً كان يستعلم أصحاب الدكاكين عن عنوان إنسان يقطن هذه المدينة. ولما رآني أتى
إلي قائلاً: (يبدو أنك سائح أنت أيضاً. فلنسع معاً باحثين عن إنسان اسمه (افرينوف)
يقيم في هذه المدينة. إنه مسيحي صالح، يدير نزلاً فخماً ويحسن ضيافة السائحين.
أنظر، معي ههنا شيء مكتوب عنه). رحبت بالفكرة وسرعان ما وجدنا بيته. ومع أن رب
البيت لم يكن شخصياً في منزله، فإن زوجته – وهي عجوز صالحة – استقبلتنا ببشاشة،
وأنزلتنا مخدعاً منفرداً في الأهراء لنصيب فيها الراحة.
قال
لي رفيقي أنه كان تاجراً في بلدة (موغيليف) وأنه قضى عامين في أحد أديرة
(بيسارابيا) بصفة مبتدئ، لكن ذلك كان بجواز مؤقت. وهو الآن في طريق عودته للحصول
على موافقة هيئة التجار على دخوله نهائياً حياة الرهبنة. وأضاف: (إن الأديرة، هناك،
وقوانينها وطريقتها والحياة المتشددة للستارتس العديدين الأتقياء، كل ذلك يروق لي).
وأكد لي أن أديرة (بيسارابيا) هي، بالقياس إلى أديرة روسيا، كالجنة مقارنة بالأرض.
وألح علي لكي أحذو حذوه.
وفيما
كنا نتحدث في هذه الأمور، أحضر نزيل ثالث إلى غرفتنا. كان هذا النزيل ضابط صف
عائداً إلى بيته في إجازة. رأينا أن سفره قد أنهك قواه. فتلونا صلواتنا معاً
واستلقينا ننام. ونهضنا في فجر الغداة، وكنا نستعد للرحيل. وكنا على وشك الذهاب
لشكر مضيفتنا عندما سمعنا قرع الأجراس لصلاة السحر، فتساءلنا – أنا والتاجر – عما
عسانا نفعل. فكيف نرحل، بعد سماع الأجراس، من غير الذهاب إلى الكنيسة؟ كان من
الأفضل أن نبقى لصلاة السحر، نتلو صلواتنا في الكنيسة، وبعدئذ يمكننا الرحيل بسرور
أعظم. ولما عزمنا على هذا، دعونا ضابط الصف. لكنه قال لنا: (ما معنى الذهاب إلى
الكنيسة عندما يكون المرء على سفر؟ ما أهمية هذا عند الله؟ فلنرحل، وسنتلو صلواتنا
من ثم. اذهبا أنتما، إن شئتما، أما أنا فلست بذاهب. ففي الوقت الذي ستمضيانه في
صلاة السحر، سأكون على بعد خمسة فراسخ من هنا، أو ما يقارب. أريد أن أصل إلى بيتي
بأسرع ما يمكنني). فرد التاجر على ذلك: (يا أخي، لا تسرع بالعدو في مشاريعك من غير
أن تعلم ما هي مقاصد الله!). فذهبنا إلى الكنيسة، وانطلق هو في رحلته.
وبقينا
لصلاة السحر ولخدمة القداس الإلهي. ثم عدنا إلى مخدعنا لإعداد كيسينا والرحيل،
ولكنه وجدنا مضيفتنا في الغرفة، وفي يدها سماور. قال: (إلى أين أنتما ذاهبان؟
إليكما أولاً بفنجان شاي. أجل، وعليكما أيضاً تناول الوجبة الصباحية معنا. لا
يسعنا أن ندعكما الذهاب وأنتما جائعان). فبقينا. وما كان مضى على جلوسنا حول السماور
نصف ساعة حتى وصل صاحبنا ضابط الصف راكضاً، لاهثاً، وقال: (إني أعود إليكم بائساً،
وبسرور في آن معاً). فسألناه: (ما الخبر؟). إليكم ما قال:
عندما
تركتكما وذهبت، خطر ببالي أن أقصد المقهى لأرى إذا كان بوسعي الحصول على (فراطة)
ولكي أتناول أيضاً طعاماً يساعدني على السفر. فذهبت إليه. وحصلت على الفراطة،
وتناولت بعض الطعام وانطلقت كالطير. وبعد اجتيازي قرابة الفراسخ الثلاثة، فكرت في
عد النقود التي أعطانيها القهوجي. فجلست على حافة الطريق، وأخرجت محفظتي وفحصت
محتواها بهدوء كلي. ثم اكتشفت فجأة أن جواز سفري ليس فيها. ولم أجد إلا بعض
الأوراق. والنقود. فأصابني الهلع كأنني فقدت صوابي. وأدركت في مثل لمح البرق ما
حصل: كان الجواز قد سقط بالتأكيد، عندما دفعت ما علي في المقهى. كان علي أن أسرع
وأعود إلى المقهى. فركضت وركضت. وخطرت ببالي فكرة ثانية مرهبة: ماذا لو لم يكن
الجواز في المقهى؟! سأكون أمام مأزق! واندفعت إلى الرجل الجالس وراء الصندوق في
المقهى وطلبته منه. قال: إني لم أره! فانهرت انهياراً.
وأخذت
أفتش حولي وأبحث في كل مكان: حيث جلست، وحيث تسكعت. أو تصدقون؟ كان لي من الحظ ما
جعلني أجد جواز سفري. كان هناك ما يزال مطوياً، على الأرض بين القش والغبار وقد
وطئته الأرجل في القذارة. الحمد لله! لقد كنت سعيداً. كنت وكأن جبلاً انزاح عن
كتفي. بالتأكيد، كان الجواز متسخاً يغطيه الوحل. وسيجلب لي ذلك بعض المتاعب، لكن
لا أهمية لهذا. مهما يكن، باستطاعتي أن أذهب إلى بيتي وأعود منه نظيف اليدين. لكني
أتيت لأروي لكم الخبر. وأنكى ما في الأمر أن قدمي، لكثرة ما ركضت مرعوباً، كالنار
حرارة، وأنا لم أعد قادراً على المشي. ولقد جئت أطلب شيئاً من المرهم لتضميد رجلي.
شرع
التاجر يقول له: هكذا يا أخي. كان كل ذلك لأنك لم تشأ سماع كلامنا والمجيء معنا
إلى الكنيسة. كنت تريد أن تسبقنا بمسافة كبيرة، وبالعكس ها أنت قد عدت (مخلعاً).
لقد قلت لك ألا تتسرع في مشاريعك، والآن أنظر إلى ما أنت فيه. لم يكن عدم مجيئك
إلى الكنيسة من العظائم، ولكن ألم تقل: (ماذا يهم الله أن نصلي؟). قولك هذا، يا
أخي، كان شراً. من البديهي أن الله ليس بحاجة إلى صلواتنا نحن الخطأة، ولكنه على
هذا، لحبه إيانا، يرغب في أن نصلي. وما يرضيه ليس الصلاة المقدسة التي يساعدنا
الروح القدس ذاته على تقديمها، ويثيرها فينا، بل كل توثب فينا وكل فكرة نقدمها
لمجده. وفي المقابل تجزينا رحمة الله اللامتناهية جزاء سخياً. محبة الله تهب
النعمة ألف مرة أكثر مما تستحقه الأعمال البشرية. إن أنت أعطيته تعالى أدنى فلس
فسيدفع لك بالمقابل ذهباً. إن أنت فكرت وحسب بالذهاب على الآب فسيأتي إلى لقائك.
قل فقط كلمة صغيرة، وبلا قناعة: (تقبلني، ارحمني)، وسيندفع ويعانقك. هكذا يحبنا
الآب السماوي، مهما نكن عديمي الاستحقاق. ولمجرد هذا الحب يغتبط بكل من خطواتنا،
وإن كانت صغيرة، نخطوها نحو الخلاص.
أما
أنت فتفكر هكذا: (أي مجد لله في هذا؟ وما الفائدة لنا، إن نحن صلينا قليلاً، ثم
عادت أفكارنا إلى الضلال، أو إن نحن قمنا بعمل صالح، كأن نتلو صلاة ترافقها خمس
سجدات أو ست، أو نتنهد مخلصين ذاكرين اسم يسوع، أو نعير اهتمامنا لفكرة صالحة، أو
أن نباشر في قراءة روحية أو أن نصوم عن الطعام، أو أن نحتمل إهانة بصمت؟). كل ذلك
لا يبدو لك كافياً لخلاصك، ويظهر لك بالتالي أن لا جدوى من ممارسته. كلا! إن أياً
من هذه الأفعال الصغرى لا يفعل سدى، فإن الله الذي يرى كل شيء سيدخله في الحساب
ويجزيك عليه مئة ضعف، لا في الحياة الثانية وحسب، بل في هذه الحياة. يؤكد القديس
يوحنا الذهبي الفم أن (أي عمل صالح مهما كان نوعه ومهما كان صغيراً لن يرذله
الديان الإلهي العادل. إن كانت الخطايا يبحث عنها بدقة كبرى إلى حد أننا نُسأل عن
كل كلمة وكل رغبة وفكرة. فكم بالأحرى الأعمال الصالحة، مهما تكن صغرى، فستؤخذ
بالاعتبار ويكون لها حساب أمام دياننا الممتلئ محبة!).
سأحكي
لكم حادثة رأيتها بنفسي في العام الماضي: كان في دير بيسارابيا الذي كنت أعيش فيه
ستارتس راهب يحيا حياة قداسة. في ذات يوم جابهته تجربة: اشتهى أكل السمك المجفف
شهوة كبرى. ولما كان من المستحيل الحصول عليه في الدير، في تلك الفترة، خامرته
فكرة الذهاب إلى السوق لشراء شيء منه. كافح هذه الفكرة طويلاً، وأعمل عقله مفكراً
أن على الراهب أن يكون قانعاً بالطعام العادي المهيأ للإخوة، وأن عليه بكل الوسائل
تجنب إرضاء شهواته. أضف أن التجول في السوق وسط جمهور من الناس قد يكون، لراهب،
مصدر تجارب، وما هو أكثر: أمراً غير لائق.
وفي
النهاية تغلبت أكاذيب الشيطان على اعتراضاته، فاستسلم لرغبته وذهب ليشتري سمكاً.
وبعد أن غادر الدير، وفيما هو يسير في الشارع، لاحظ أن سبحته لم تكن في يده وأخذ
يفكر: (أتراني أمضي كجندي من غير سيفه؟). وهم بالعودة لجلبها، وإذ بحث في جيبه
وجدها فيه. فأخرجها، ورسم إشارة الصليب، ومضى بهدوء وسبحته في يده. وعند اقترابه
من السوق رأى حصاناً أوقف قرب دكان مع عربة محملة براميل ضخمة. وفجأة أجفل هذا
الحصان لسبب لا أدري ما هو، فانطلق على حين غرة وعدا متجهاً صوب الراهب، ملامساً
كتفه بحيث ألقاه أرضاً دون أن يؤذيه كثيراً. ثم انقلب الحمل، على خطوتين منه،
وتحطمت العربة قطعاً قطعاً. فنهض بخفة ونفض عنه جزعه متعجباً كيف أبقى الله على
حياته، إذ لو أن الحمل وقع نصف ثانية قبل وقوعه لمزقه إرباً كالعربة. وبدون أن
يطيل التفكير، اشترى السمك وعاد إلى الدير، وأكله، وتلا صلواته واستلقى لينام.
نام
نوماً خفيفاً، وفي منامه هذا ظهر له ستارتس سمح المحيا لم يكن هو يعرفه، وقال له: أنا
شفيع هذا الدير وبودي أن أعلمك لكيما تفهم وتذكر العبرة التي أعطيتها. إن عدم
جهادك ضد فكرة المتعة، وتكاسلك في تمييزها وضبط نفسك أعطى الشيطان فرصته لمهاجمتك.
لقد كان هيأ لك هذه الهزيمة. لكن ملاكك الحارس شعر بها وأوحى إليك بالصلاة وبتذكرك
سبحتك. ولأنك استمعت لإيحائه وطبقته عملاً، فإن هذا خلصك من الموت. أرأيت حب الله
للبشر، وجزاءه السخي لأدنى نظرة تلتفت إليه تعالى؟
وعلى
هذه الكلمات، اختفى ستارتس الرؤيا بسرعة من الحجرة. وركع الراهب، وبركوعه استيقظ
ليجد نفسه لا على فراشه بل على ركبتيه ساجداً على عتبة الباب. وروى قصة رؤياه لما
فيه الفائدة الروحية للكثيرين غيره، وأنا منهم.
إن
محبة الله لهي بلا حدود لنا نحن الخطأة. أو ليس من الرائع أن عملاً صغيراً كهذا –
نعم، مجرد إخراج السبحة من جيبه وحملها في يده وذكر اسم الله مرة واحدة – قد يعيد
الحياة لإنسان، وإن فترة قصيرة تقضى في ذكر اسم يسوع يكمن أن تكافئ، في ميزان
الدينونة، ساعات عديدة من الكسل؟ الحق إن هذا هو الدفع بالذهب مقابل الفلس الحقير.
أنظر، يا أخي، سلطان الصلاة، وسلطان اسم يسوع عندما نذكره. يقول يوحنا الكرباتي في
الفيلوكاليا إن في صلاة يسوع، حينما نذكر الاسم المقدس قائلين: (ارحمني أنا
الخاطئ)، على كل نداء يجيب صوت الله سراً: (يا بني مغفورة لك خطاياك). ويضيف: إننا
حين نتلو صلاة يسوع، لا شيء يميزنا عن القديسين والمعترفين والشهداء. وذاك، على ما
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: (مهما كانت الخطايا تكسونا، فإننا، عندما ننطق
بالصلاة، تطهرنا للحال. إن رحمة الله نحونا عظيمة، بالرغم من أننا، نحن الخطأة، لا
مبالون، بالرغم من أننا لا نريد حتى منح الله ساعة واحدة للشكر، وأننا نستبدل
بالمشاغل ومتاعب الحياة الصلاة وهي أهم من أي شيء آخر، ناسين الله وواجبنا. ولذا
فكثيراً ما نصطدم بالمصائب والشدائد التي تستعملها المحبة اللامتناهية للعناية
الإلهية، في أي حال، لإرشادنا ورفع قلوبنا نحو الله).
عندما
انتهى التاجر من الكلام إلى ضابط الصف، قلت له: (يا للراحة التي جلبتها أيضاً إلى
نفسي الخاطئة، سيدي. بإمكاني الانطراح بطيبة خاطر على قدميك). ولما سمع هذه
الكلمات أخذ يحدثني. قال: يبدو أنك هاو كبير للنوادر الدينية. انتظر، سأقرأ لك
نادرة ثانية كالتي رويتها لتوي. معي هنا كتاب يصحبني في سفري، عنوانه (أغابيا) أو
(خلاص الخطأة). وهو يحوي العديد من الأمور المذهلة.
وأخرج
الكتاب من جيبه وبدأ بقراءة قصة رائعة حول (اغاثونيس) الذي كان والداه التقيان قد
علماه منذ طفولته أن يتلو كل يوم أمام أيقونة والدة الإله الصلاة التي تبدأ هكذا
(افرحي أيتها العذراء، يا من تلد الإله). وكان دوماً يفعل هذا. وفيما بعد، وقد كبر،
استغرق في مشاغل الحياة واضطراباتها ولم يتل تلك الصلاة إلا نادراً، ثم تخلى عنها
في نهاية الأمر.
وفي
ذات يوم، آوى لليل سائحاً قال له أنه ناسك في صحراء مصر وأنه رأى رؤيا تلقى فيها
أمراً بالذهاب إلى إنسان يدعى اغاثونيس لتأنيبه على تخليه عن صلاة والدة الإله.
فاعتذر اغاثونيس أنه تلا الصلاة خلال سنوات كثيرة من غير أن يحصل على أية نتيجة،
فقال له الناسك:
–
أذكر أيها الأعمى ناكر الجميل كم مرة ساعدتك هذه الصلاة وأنقذتك من الكارثة. أذكر
أنك في شبابك أنقذت بأعجوبة من الغرق. ألا تذكر أن وباء قضى على الكثيرين من
أصدقائك فيما احتفظت بعافيتك؟ أتذكر أنك كنت توصل صديقاً فسقطتما من العربة وكسر
هو ساقه أما أنت فبقيت سالماً؟ ألا تعرف أن شاباً من معارفك كان معافى قوياً هو
الآن مستلق ضعيفاً مريضاً، فيما تنعم أنت بالصحة الجيدة بلا آلام؟
وذكّر
اغاثونيس بكثير من الأمور غيرها، وقال له آخر الأمر: اعلم أن هذه الشدائد جميعاً
قد صرفت عنك بحماية أم الله الكلية القداسة بسبب هذه الصلاة القصيرة التي كانت
يومياً تصل قلبك بالله. فاحترس الآن، وعد إليها ولا تتخل عن مديح ملائكة السموات،
خوفاً من أن تتخلى هي عنك.
لما
انتهى من القراءة، نادونا للغداء، وبعده شكرنا مضيفنا، وقد استعدنا قوانا، وبدأنا
المسير. وافترقنا، فذهب كل من ناحية، كما حلا له.
سرت
خمسة أيام تقريباً وقد سدد عزيمتي ذكرى القصص التي سمعتها من تاجر بييلا تسيركوف
الطيب، وصرت قريباً من مدينة (كييف). وفجأة، ومن غير سبب بدأت أشعر بالحزن والثقل،
وامتلأت أفكاري عتمة وخوراً في العزيمة. وأتت الصلاة بصعوبة واستولى علي شبه نعاس.
ورأيت غابة ملآى بأدغال العليق الكثيفة على حافة الطريق، فدخلتها لأصيب فيها شيئاً
من الراحة باحثاً عن مكان منعزل يمكنني الجلوس فيه تحت علية وقراءة فيلوكاليتي
وذلك لتشديد نفسي المستضعفة ومحاربة خوري. ووجدت مكاناً هادئاً وأخذت بقراءة
كاسيانوس الروماني {القديس يوحنا كاسيانوس هو راهب روماني عاش في الشرق وتتلمذ على
أيدي رهبانه الكبار ونقل تعاليمهم إلى الغرب (أواخر القرن الرابع – أوائل القرن
الخامس)}، في الجزء الرابع من الفيلوكاليا حول الأفكار الثماني. كنت أقرأ بمتعة من
زهاء نصف الساعة لما لاحظت بصورة غير منتظرة بالمرة طيف رجل على نحو مئة متر مني،
في داخل الغابة، كان راكعاً، بلا حراك. أسعدتني رؤيته، إذ استنتجت أنه كان يصلي
وعدت إلى القراءة. وبقيت أقرأ مدة ساعة أو أكثر، وعدت إلى إلقاء نظرة. كان الرجل
ما يزال هناك راكعاً، ودون أدنى حركة. أثر هذا فيّ بالغ الأثر وفكرت: (ما أكثر
عبيد الله الأوفياء!).
وفيما
كنت أفكر في هذا، فجأة سقط الرجل على الأرض وظل مستلقياً بهدوء. فدهشت. وإذ كنت لم
أر وجهه – لأنه كان يدير لي ظهره عندما كان راكعاً – شعرت بفضول يدفعني إلى
الاقتراب منه لأرى من كان. لقد كان فتى من الريف، شاباً في حوالي الخامسة والعشرين.
وكان صبيح الوجه، جميل الهيئة، غير أنه شاحب. وكان يلبس (غنباز) فلاح يشده في
الوسط حبل من ألياف الزيزفون بمثابة الحزام. ولم يكن معه أي شيء آخر ذو طبيعة خاصة.
ولم يكن يحمل جراباً ولا حتى عصا. نبهه صوت اقترابي فنهض. وسألته من هو، فقال لي
أنه فلاح من فلاحي الدولة، من مقاطعة (سمولنسك)، وأنه آت من (كييف). فسألت: وإلى
أين أنت الآن ذاهب؟
أجاب:
لا أعرف هذا أنا نفسي، إلى حيث تسوقني يد الله.
–
هل مضى زمن طويل على تركك بيتك؟
–
نعم، أكثر من أربع سنين.
–
وأين عشت خلال هذه الفترة الطويلة؟
–
ذهبت من مزار إلى مزار في الأديرة والكنائس. ولم يكن من معنى لبقائي في بيتي. أنا
يتيم ولا أقرباء لي. زد أن لي رجلاً شوهاء ولذا فأنا ماض أضرب في الأرض.
فقلت:
يبدو أن إنساناً يخاف الله قد علمك ألا تتجول أينما اتفق، بل أن تزور أماكن مقدسة.
أجاب: حسناً، ترى، بما أني بلا أب ولا أم، كنت أذهب، وأنا طفل مع رعاة القطعان،
وكنت سعيداً حتى سن العاشرة. ثم، في ذات يوم، عدت بالقطيع إلى البيت، من غير أن
ألاحظ أن أفضل خروف من خرفان المختار لم يعد معي. كان مختاراً فلاحاً قاسياً لا
إنسانياً. عندما عاد إلى بيته في ذلك المساء ورأى أن خروفه قد ضاع، انهال علي
شاتماً مهدداً، وأقسم أنه سيضربني حتى الموت إن أنا لم أجده وقال: (سأكسر لك يديك
ورجليك). ولعلمي بمبلغ شراسته، انطلقت باحثاً عن الخروف، عائداً إلى الأمكنة التي
رعى فيها أثناء النهار. وبحثت، وبحثت أكثر من نصف الليلة، ولكني لم أقع على أي أثر
له في مكان.
وكانت
الليلة حالكة السواد أيضاً، إذ كنا نشارف على الخريف. ولما توغلت في داخل الغابة –
والغابات شاسعة في مقاطعتنا – هبت عاصفة على حين غرة. فكأن الأشجار لهب في مهب
الريح، ومن بعيد، أخذت الذئاب تعوي. فأخذني الرعب بحيث وقف شعر رأسي. وكان كل شيء
يتعاظم هولاً حتى بت على وشك الانهيار خوفا ورعباً.
وعندئذ
خررت على ركبتي ورسمت إشارة الصليب وقلت من كل قلبي: (أيها الرب يسوع المسيح
ارحمني). وما إن قلت هذا حتى شعرت بسلام تام، للحال، كما لو كنت لم أشعر بأدنى
قنوط. وزال كل ما كان بي من رعب وشعرت بالسعادة في قلبي، كما لو رفعت إلى السماء.
أو ترى: كان بي فرح كبير، ولم أتوقف لحظة عن ترداد هذه الصلاة. وحتى اليوم أنا لا
أعرف إن كانت العاصفة قد دامت طويلاً، ولا كيف مضى الليل. رأيت نور النهار يرتفع،
وكنت ما أزال هنا، راكعاً في المكان. ونهضت بهدوء، وفهمت أنني لن أجد الخروف أبداً،
وعدت إلى البيت. ولكن كل شيء في قلبي كان على ما يرام، وكنت أتلو صلاة يسوع لما
فيه مسرة قلبي.
ومذ
بلغت القرية، رأى المختار أني لم أرجع الخروف، فضربني حتى أصبحت نصف ميت، وخلع هذه
الرجل كما ترى. وبقيت في الفراش أكاد لا أستطيع الحراك مدة ستة أسابيع، بعد ذلك
القصاص. وكل ما كنت أعرفه هو أني كنت أتلو صلاة يسوع وأنها كانت تشدد قواي. ولما
شعرت بتحسن، أخذت أضرب في الأرض. ولما كنت لا أعنى بمصاحبة الجمهور بصورة مستمرة،
وهي فرصة ارتكاب الكثير من الخطايا، عقدت النية على الرحلة من مكان مقدس إلى مكان،
وفي الغابات. هكذا أمضيت مدة ستبلغ الخمس سنين قريباً.
عند
سماعي هذه القصة، امتلأ قلبي فرحاً إذ اعتبرني الله مستحقاً للقاء رجل بهذا الصلاح،
وسألته: وهل تستعمل صلاة يسوع الآن كثيراً؟ فأجاب: لن أستطيع العيش بدونها. ترى: إن
أنا تذكرت كيف سقطت على ركبتي في تلك المرة الأولى، في الغابة، حسبت وكأن أحداً
يدفعني مجدداً على ركبتي، وأباشر في الصلاة. وأنا لا أعرف إن كانت صلاتي الحقيرة
ترضي الله أم لا. وذلك لأني أشعر أحياناً. إذ أصلي، بغبطة كبرى، كأنها خفة في
الروح، شبه ملء فرح. ولكني، في أحيان أخرى، أحس بثقل حزين وضعف روحي. وفي أي حال
أنا راغب في الاستمرار في الصلاة حتى الموت. فقلت له: لا تكتئب يا أخي العزيز. فكل
شيء يرضي الله ويفيد لخلاصنا، كل شيء بلا استثناء مما يطرأ أثناء الصلاة. هذا ما
يقوله الآباء القديسون. إن كانت خفة القلب أو تثاقله، فهذا حسن. وليس من صلاة،
جيدة كانت أو سيئة، غير كافية في نظر المجهود، أما الثقل والظلمة والجفاف فتعني أن
الله يطهر النفس ويقويها، وبهذه المحنة يفديها، مهيئاً إياها، في التواضع، لتقبل
المسرات الآتية. إثباتاً لذلك، سأقرأ لك شيئاً كتبه القديس يوحنا السلمي.
ووجدت
المقطع وقرأته، فاستمع إليه بانتباه وسر به. ثم شكرني عليه كثيراً. وعلى هذا
افترقنا. فاتجه مباشرة نحو أعماق الغابة وعدت إلى الطريق. وتابعت المسير شاكراً
الله اعتباره إياي، على كوني خاطئاً، مستحقاً لتلقي تعليم كهذا.
وفي
اليوم التالي، وصلت إلى (كييف) بعون الله تعالى. وكان أول ما أردت فعله في هذه
المدينة المقدسة وأهمه الصيام قليلاً، والاعتراف والمناولة. ونزلت على مقربة من
القديسين {أي في دير الكهوف حيث يدفن الرهبان القديسون} لأن ذلك كان أنسب للذهاب
إلى الكنيسة. اصطحبني شيخ من الكوزاك، ولما كان يعيش وحيداً في كوخ، وجدت عنده
الهدوء. وبعد أسبوع قضيته في الاستعداد للاعتراف، خطر ببالي أن أقوم باعتراف مفصل
قدر المستطاع. فجعلت أتذكر كل ما ارتكبت من خطايا منذ صباي وأتفحصها، بدقة: ولكي
لا يفوتني شيء منها دونت كل ما استطعت تذكره مع أدق التفاصيل، مما ملأ، ورقة كبيرة
بكاملها.
وبلغني
أن في (كيتاييفا بوستينا) على قرابة السبعة فراسخ من (كييف)، كاهناً متزهداً ذا
تمييز وعمق نظر كبير. من ذهب يعترف إليه وجد لديه جواً من الرفق الرقيق، وعاد
بتعليم مفيد لخلاص النفس وسلامها. كنت شديد السعادة لمعرفتي الأمر، وانطلقت حالاً
نحوه. وطلبت منه مساعدته، وتجاذبنا الحديث فترة، ثم أعطيته ورقتي. قرأها بكاملها
وقال لي:
يا
صديقي العزيز، إن قسماً كبيراً مما كتبت لهو لغو. اسمع: أولاً، لا تعترف بخطايا
سبق لك أن ندمت عليها وغفرت لك. لا تعد إليها، فإن هذا يعني التشكك في سر التوبة.
وثانياً، لا تعد إلى ذاكرتك الأشخاص الآخرين الذين شاركوا في خطاياك، لا تدن إلا
نفسك. وثالثاً، يحرم الآباء القديسون علينا ذكر كافة ظروف الخطايا وملابساتها،
ويقولون لنا أن نقر بها بعبارات عامة بحيث نبعد التجربة عنا وعن الكاهن في آن معاً.
ورابعاً، أتيت لتقوم بفعل الندامة وأنت لا تندم على عدم معرفتك الندم، أعني أن
ندامتك فاترة مهملة. وخامساً، تبسطت في هذه التفاصيل كلها، ولكن الأهم لم تحفظه: لم
تبح بأخطر خطاياك، لم تقر ولم تكتب أنك لا تحب الله، وأنك تمقت قريبك، وأنك مجبول
بالتكبر والطمع. إن جذور الشر متأصلة في هذه الخطايا الأربع التي يكمن فيها
انحلالنا الروحي كله. إنها الجذور الرئيسية، التي منها تنبع كل الخطايا التي نتردى
فيها.
دهشت
جداً لسماعي هذا وقلت: سامحني يا أبت، ولكن كيف يكون من الممكن عدم حب الله خالقنا
ومخلصنا؟ وبأي شيء يمكن الإيمان ما لم يكن في كلمة الله، الذي فيه كل حقيقة وكل
قداسة؟ إني أتمنى الخير لكل الناس فلماذا أكرههم؟ وليس لي ما يمكنني من التكبر.
وعلى كل، ليس لي، وقد امتلأت بالعديد من الخطايا، ما يستحق المديح. وماذا عساي
أشتهي مع حقارتي وصحتي الضعيفة؟ من المؤكد أنني لو كنت متعلماً وغنياً، لكنت – بلا
شك – مذنباً بالخطايا التي حدثتني عنها. فقال: من المؤسف يا عزيزي أن تكون أسأت
فهم ما قلت إلى هذا الحد. فلنر! ستتعلم بصورة أسرع فيما لو أعطيتك هذه الملحوظات.
إنها كتابات أفيد منها دوماً لاعترافي الشخصي. أقرأها بكاملها، وسترى بوضوح الدليل
على صحة ما قلته لك لتوي.
أعطاني
الملحوظات وأخذت في قراءتها. ها هي ذي:
تم نسخ الرابط