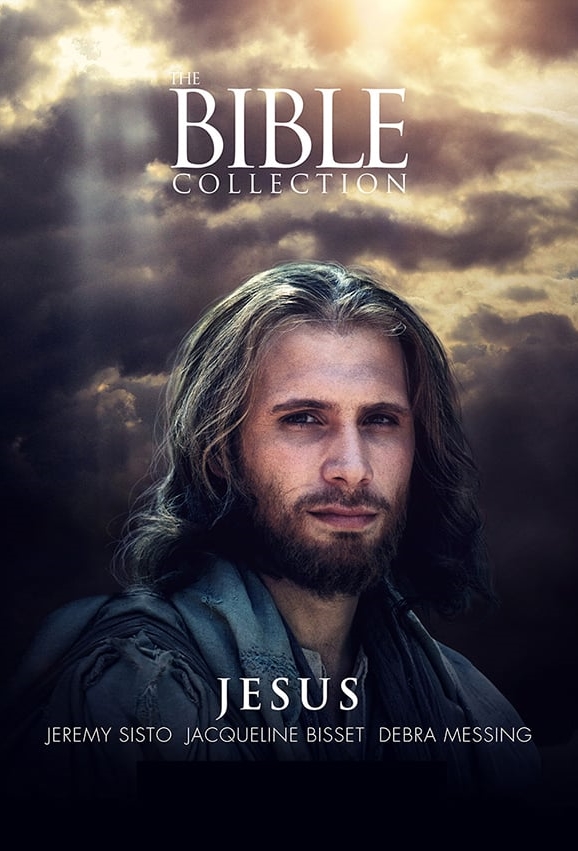[pt_view id=”aa2d703e20″ tag=”تأملات فى حياة وخدمة السيد المسيح – المسيح مشتهى – الأنبا بيشوي مطران دمياط و البراري” field=name]
أحداث الصلب
“جمعوا عليه كل الكتيبة” (مت27: 27)
بعد أن أصدر بيلاطس الحكم على السيد المسيح بالصلب بالرغم من إعلانه لبراءته، وبعد أن كان قد جلده جلداً رومانياً قاسياً، “أخذ عسكر الوالى يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة” (مت27: 27).
لم يتخلف جندى واحد فى الكتيبة عن الاستهزاء بالسيد المسيح. وكأنهم يحتفلون بهذه الشخصية الفريدة وبهذه الذبيحة النادرة.
كان المعتاد أن يرافق المحكوم عليه أربعة من العسكر لحراسته، وتتغير الوردية كل ست ساعات، بحيث تتناوب أربعة أرابع من العسكر على هذه الحراسة الهامة.
ولكن العسكر أقاموا احتفالاً للكتيبة كلها.. لأن المحكوم عليه هو المدعو “ملك اليهود”، الذى رفضه شعبه وأسلموه إلى قضاء الموت. وكأن العالم كله قد قام على السيد المسيح..
صار السيد المسيح منظراً للكثيرين، يشاهدونه فى آلامه ومعاناته لأجلنا. وهذا يذكرنا بحال شمشون حينما جمع عليه الوثنيون جمعاً هائلاً وهم يحتفلون بعيد إلههم داجون فى معبده الكبير، وصاروا يستهزئون به وبإلهه، ولكن شمشون كان قد أخطأ ثم تاب. أما السيد المسيح فلم يفعل شيئاً ليس فى محله، ولكنه حمل خطايا كثيرين وشفع فى المذنبين.
عروه من ثيابه
بعد أن أخذ عسكر الوالى يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، “عرَّوه وألبسوه رداءً قرمزياً. وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة فى يمينه. وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه، ومضوا به للصلب” (مت27: 28-30).
حينما خلق الله الإنسان، لم يكن يلبس ثياباً، لأنه كان مكتسياً بثوب البر، بثياب النعمة، ولم يكن يشعر أنه عريان لأنه لم يكن عرياناً من النعمة.
ولكن بعد السقوط شعر آدم وحواء بالعرى و”انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان” (تك3: 7). وقال آدم للرب: “سمعت صوتك فى الجنة فخشيت، لأنى عريان فاختبأت” (تك3: 10). وسأله الرب: “من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك أن لا تأكل منها؟” (تك3: 11).
الخطية جعلت الإنسان يشعر بالعرى، لأنه تعرى من البر الذى فى المسيح، وانفتحت عيناه وعرف أنه عريان، بعد أن فقد براءته وبساطته الأولى، تلك التى اختبرها قبل معرفة الخير والشر.
وصار الإنسان -فى إحساسه بالعرى- يبحث عن وسيلة يستر بها عريه “فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر” (تك3: 7). ولكن أوراق التين لا تلبث أن تذبل وتكشف عريهما مرة أخرى.
“وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما” (تك3: 21). ليستر عريهما بطريقة سليمة. وكان ذلك إشارة إلى عناية الرب فى الفداء بتقديم جسد يسوع كذبيحة. لأن ورق التين من الشجر، أما أقمصة الجلد فمن جلد الذبيحة.
كان الإحساس بالعرى هو نتيجة الخطية.. وهكذا صنع البشر الخطاة بالسيد المسيح، حينما عروه من ثيابه للهزء والسخرية من ملك اليهود وقد قَبِلَ السيد المسيح هذا العرى من يد البشر، ليؤكد أن الذى يحمل الخطية لابد أن يتعرى. ولكن السيد المسيح لم يكن عرياناً من البر على الإطلاق.. بل هو ملك البر الذى كهنوته على رتبة ملكى صادق. “لأن ملكى صادق هذا ملك ساليم كاهن الله العلى.. المترجم أولاً ملك البر ثم أيضاً ملك ساليم أى ملك السلام” (عب7: 1، 2). وكان ملكى صادق هذا رمزاً للسيد المسيح ملك البر الحقيقى. وقد قيل أن السيد المسيح قد تعرى من ثيابه، ليلبسنا ثوب بره، لأنه أخذ الذى لنا وأعطانا الذى له..
لقد جهل هؤلاء العسكر الخطاة أن الذى قاموا بتعريته من ثيابه، هو نفسه الذى ستر عرى آدم ببره الكامل، وبذبيحته المقدسة، التى تمت بواسطتها المصالحة بين الله والإنسان “متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله” (رو3: 24، 25).
لقد حمل السيد المسيح عار خطايانا، وكلما رأيناه معلقاً على الصليب بعد أن قاموا بتعريته من ثيابه للمرة الثالثة ( )، نتذكر فى خجل وانسحاق ذلك العرى الذى لحق بنا بسبب الخطية.. ولسان حال كل منا يقول للسيد المصلوب:
كلما طافت بك العين انزوت نفسى الخجلى يغطيها بكاها ( )
هكذا فى اتضاع عجيب احتمل السيد المسيح المحقرة والمذلة، ليخلّص شعبه من خطاياهم. وقد تنبأ إشعياء النبى عن احتقار النـاس للسـيد المسيح فى وقت آلامـه فقال: “محتقر ومخذول من الناس. رجل أوجاع ومختبر الحزن. وكمستّر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به” (إش53: 3).
“ألبسوه رداء قرمزياً” (مت27: 28).
بعد أن خلع العسكر ثياب السيد المسيح فى دار الولاية “ألبسوه رداءً قرمزياً. وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة فى يمينه” (مت27: 28، 29).
كان الرداء القرمزى هو لباس الملوك. وأراد عسكر الوالى أن يسخروا من السيد المسيح، فألبسوه لبس الملوك “وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود” (مت27: 29).
الرداء القرمزى كان رمزاً لملابس الملوك المعتادة، وإكليل الشوك كان رمزاً لتاج المملكة، والقصبة فى يمينه كانت رمزاً لقضيب الملك.
بالفعل كان اللباس الذى يليق بالسيد المسيح هو الرداء القرمزى، باعتبار أنه هو الذى ملك بدمه المسفوك ذى اللون الأحمر القرمزى..
أى ملك آخر يلبس الرداء القرمزى، فليس لملابسه معنى يخصه.. أما السيد المسيح فهو الملك الوحيد الذى يجب أن يتزيا بلون الدم، لأنه اشترى شعبه بدمه، وخلّصهم من براثن الموت الأبدى..
لو استخدم أحد الملوك اللون القرمزى لملابسه، لكان هذا فقط تشبهاً بالمسيح الملك الحقيقى، الذى لن يزول ملكه إلى الأبد.. وعلامة ملكه هى الدم المسفوك.
وكيف لا؟ وعروس النشيد تتغنى وتقول “حبيبى أبيض وأحمر، مُعلم بين ربوة” (نش5: 10).
أراد العسكر أن يستهزئوا بالسيد المسيح، ولكنهم أكملوا ما هو مكتوب عنه دون أن يدروا.. لننظر ماذا قال إشعياء النبى بروح النبوة، فى حواره مع المسيح الملك فى (إش63: 1-3):
س: “من ذا الآتى من أدوم بثياب حمر، من بُصرة، هذا البهى بملابسه المتعظم بكثرة قوته؟”.
ج: “أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص”.
س: “ما بال لباسك مُحمَرٌّ، وثيابك كدائس المعصرة؟”.
ج: “قد دُست المعصرة وحدى، ومن الشعوب لم يكن معى أحد”.
لقد أبرز إشعياء النبى فى هذه النبوة كيف لبس المخلّص الثياب الحمراء، كدائس معصرة العنب، إشارة إلى سفك دمه، وإشارة إلى ملكه الفريد حينما دفع ثمن خطايا البشر جميعاً، ولم يشاركه أحد فى دفع هذا الثمن.
“ضفروا إكليلاً من الشوك” (27: 29)
فى القديم قال الرب لآدم بعدما أخطأ “ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكاً وحسكاً تنبت لك” (تك3: 17، 18).
كان آدم حينما خلقه الرب هو سيد الخليقة التى على الأرض، كما هو مكتوب عنه “بالمجد والكرامة توَّجْتَه، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شئ أخضعت تحت قدميه” (مز8: 5، 6).
ولكنه بعد السقوط لم يعد يجنى من الأرض الراحة بل التعب. ولهذا فقد حمل السيد المسيح على رأسه المقدس إكليلاً من شوك الأرض وحمل نتيجة اللعنة.
كان الشوك المغروس فى الرأس، إشارة إلى ما ملأ رأس الإنسان من أفكار لا ترضى الله، وهى السبب فى تنغيص حياة الإنسان.
الآن ننظر السيد المسيح وقد تعرى من ثيابه، وحمل على رأسه إكليلاً من شوك، ألا يذكِّرنا هذا المشهد العجيب بآدم عند سقوطه فى الخطية، وآثار الخطية بادية عليه، إذ شعر بأنه عريان، وصارت الأرض بسببه تنبت له شوكاً وحسكاً..
أليس المسيح هو آدم الثانى كما هو مكتوب “صار آدم الإنسان الأول نفساً حية، وآدم الأخير روحاً محيياً.. الإنسان الأول من الأرض ترابى. الإنسان الثانى الرب من السماء” (1كو15: 45، 47).
إن الرب لم يفعل بآدم عند خروجه من الفردوس، ما فعلته البشرية بالمسيح عند خروجه إلى الصليب!!.
فقد ستر الرب برفق عرى آدم بقميص من جلد، وأبقى الرب فى الأرض شيئاً من خيراته لطعام الإنسان.
أما البشر فقد نزعوا فى قسوة ملابس السيد المسيح وجلدوه، ثم نزعوا ثيابه ثانية وكللوه بالشوك، ثم نزعوا ثيابه مرة ثالثة وصلبوه بلا شفقة، وفى عطشه سقوه خلاً، واستمروا فى تعذيبه إلى أن حكموا عليه بالموت، وهو غير مستوجب الموت.
وبالرغم من كل هذا الظلم، فقد استمر الرب فى محبته للإنسان، ساعياً لخلاصه بصبر واتضاع عجيبين إذ حمل لعنة خطايانا وكل أوجاعها، لكى ينقلنا من الموت إلى الحياة.
هذا هو الملك الذى تُوِّج بإكليل من شوك، لأن مُلكه هو فى آلامه.. وبالفعل ملك بمحبته الباذلة وأعاد إلى آدم كرامته الأولى.
وحول هذا المعنى تنبأ سفر نشيد الأناشيد عن الملك المسيح “اخرجن يا بنات صهيون وانظرن الملك سليمان بالتاج الذى توجته به أمه فى يوم عرسه وفى يوم فرح قلبه” (نش3: 11).
عجيب هو هذا العرس الذى وضع فيه إكليلاً من الأشواك على رأس العريس.. ولكن كان هذا هو المهر أو الثمن الذى دفعه العريس ليشترى عروسه الكنيسة مخلِّصاً إياها.. وصار بهذا مثلاً لكل عريس حقيقى. كقول معلمنا بولس الرسول: “أيها الرجال أحبوا نساءكم، كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكى يقدسها” (أف5: 25، 26).
“قصبة فى يمينه” (مت27: 29)
يقول المزمور عن السيد المسيح “كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. قضيب استقامة هو قضيب ملكك” (مز44: 6، عب1: 8).
فى هذا المشهد العجيب: المسيح الملك يلبس الرداء الأحمر القرمزى، وإكليل الشوك يتوج رأسه المقدس، وقضيب الاستقامة الخاص بملكه هو قصبة فى يمينه.
كانت هذه القصبة رمزاً إلى قضيب الملك، كما كانت رمزاً لعصا الراعى. وها هو المسيح الملك الراعى .. الراعى الحقيقى الذى بنى مُلكه على رعايته الباذلة.. وأسس عرشه على الحق “العدل والحق قاعدة كرسيه” (مز97: 2)
لم يكن قضيب ملكه مصنوعاً من الذهب الثمين، بل مصنوعاً من البر والحق (dikaiosu,nh “ذيكيؤسينى” باللغة اليونانية).
“بصقوا عليه” (مت27: 30)
بعد الجلد احتقر عسكر الوالى الرومانى السيد المسيح “وبصقوا عليه” (مت27: 30)، ولطّخوا وجهه المقدس بهذا البصاق الذى يقزز النفس، وذلك ليتم ما قيل بإشعياء النبى القائل “بذلت ظهرى للضاربين وخدى للناتفين. وجهى لم أستر عن العار والبصق” (إش50: 6).
من كان يستحق خزى البصاق إلا الإنسان الذى أخطأ!!.. ولكن هكذا فى اتضاع عجيب حمل السيد المسيح عار خطايانا.كقول القداس الغريغورى }لأجلى يا سيدى لم ترد وجهك عن خزى البصاق{.
“ضربوه على رأسه” (مت27: 30)
” أخذوا القصبة، وضربوه على رأسه” (مت27: 30). هذه القصبة التى وضعوها فى يمينه كانت ترمز إلى قصبة ملكه.
وكان قضيب ملكه هو قضيب الاستقامة والعدل. ولأن السيد المسيح قد أوفى العدل الإلهى حقه، لهذا ضُرب بهذا القضيب على رأسه أى ضرب بقضيب العدل الإلهى.
والرأس إذ هى مركز القيادة فى كيان الإنسان.. وآدم قد قادته رأسه إلى العصيان ومخالفة الوصية.. لهذا ضُرب السيد المسيح على رأسه.. وكان ذلك ليتم ما قيل بإشعياء النبى: “أنه ضُرب من أجل ذنب شعبى” (إش53: 8).
“ثم خرجوا به ليصلبوه” (مر15: 20)
“وبعدما استهزأوا به. نزعوا عنه الأرجوان، وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه” (مر20:15).
“فخرج وهو حامل صليبه” (يو19: 17).
خرج السيد المسيح من أورشليم وهو حامل أداة موته وهو الصليب، حاملاً عار خطايانا..
لهذا قال معلمنا بولس الرسول: “فإن الحيوانات التى يُدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة، تُحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضاً لكى يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذاً إليه خارج المحلة حاملين عاره” (عب13: 11-13).
وحينما ظهر موسى وإيليا يتكلمان مع السيد المسيح على جبل التجلى “تكلما عن خروجه الذى كان عتيداً أن يكمله فى أورشليم” (لو9: 31).
وحينما طرد الإنسان من الفردوس بسبب الخطية، ومُنع من الأكل من شجرة الحياة. فإنه قد واجه الموت، والمصير المظلم فى الجحيم. وبقى منتظراً الفداء والخلاص من الخطية ومن الموت.. وحينما جاء السيد المسيح، وحمل خطايانا فى جسده. فإنه قد تألم خارج الباب.. خارج المحلة.. كما خرج آدم من الفردوس “لأنه جعل الذى لم يعرف خطية- خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه” (2كو5: 21). أى أن الرب قد “وضع عليه إثم جميعنا” (إش53: 6).. فكما خرج آدم من الفردوس لسبب الخطية، هكذا خرج السيد المسيح من مدينة الله أورشليم حاملاً صليب خطايانا..
بعد خروج آدم أقام الرب شرقى الفردوس “الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة” (تك3: 24).
كان لهب هذا السيف المتقلب رمزاً للعدل الإلهى الذى ينبغى أن يوفيه الإنسان، قبل أن يصل إلى شجرة الحياة ويأكل منها. وهيهات أن يوفى الإنسان العدل الإلهى حقه بدون موت القدوس البار الذى بلا خطية وحده، الذى تجسد وتأنس لأجل خلاصنا. مقدماً فداءً غير محدود بذبيحته المقدسة على الصليب..
هكذا اجتاز السيد المسيح نار العدل الإلهى، واحتمل آلام الصليب، لكى يصل بنا إلى أفراح القيامة، وإلى شجرة الحياة الأبدية التى حرمنا منها بسبب خطايانا.
وكما خرج السيد المسيح من أورشليم حاملاً الصليب، هكذا عاد ودخلها بعد القيامة بمجد، وظهر لتلاميذه فى العلية حيث كانوا مجتمعين. وكان ذلك بعد أن صنع الخلاص، ورد آدم وبنيه إلى الفردوس.
كانت أورشليم – مدينه الله، ترمز إلى كورة الأحياء.. ترمز إلى الفردوس، وترمز إلى أورشليم السمائية.. وترمز إلى حياة الشركة مع الله.
فى أسبوع الآلام تترك الكنيسة (كجماعة) الهيكل، والخورس الأول الخاص بالمتناولين، وتجتمع خارج الباب (أى خارج الخورس الأول)، فى صحن مبنى الكنيسة. لكى نتذكر مع آلام السيد المسيح، أن الخطية قد أخرجتنا من الفردوس وحياة الشركة مع الله، اللذين تعيشهما الكنيسة على الأرض فى الهيكل المقدس، والخورس الأول.
وبعد صلاة الساعة الحادية عشر من يوم الجمعة العظيمة، تدخل الكنيسة إلى الهيكل، لنتذكر أن الفداء قد تم على الصليب بموت السيد المسيح، وأن العداوة القديمة قد زالت بذلك بين الله والإنسان.
وحتى القديسون الذين كانوا قد رقدوا، وكانت أجسامهم تُدفن خارج المحلة، أى خارج أورشليم، قاموا ودخلوا إلى المدينة احتفالاً بعودتهم إلى الفردوس، واحتفالاً بقيامة السيد المسيح.
وقد سجّل القديس متى الإنجيلى هذه الواقعة الفريدة فى إنجيله فقال: “قام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين” (مت27: 52، 53).
وقد أجمل القديس يوحنا فى رؤياه كثيراً من معانى الخلاص والفداء التى ذكرناها، وطبيعة مُلك السيد المسيح الفادى المنتصر فقال: “ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض، والجالس عليه يدعى أميناً وصادقاً، وبالعدل يحكم ويحارب. وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويُدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين فى السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزاً أبيض ونقياً. ومن فمه يخرج سيف ماضٍ لكى يضرب به الأمم. وهو سيرعاهم بعصاً من حديد. وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شئ. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب” (رؤ19: 11-16).
فى ليلة السبت الكبير تعيش الكنيسة مع أحداث الخلاص العظيم، حينما كان السيد المسيح بجسده المقدس فى القبر، وكانت روحه تعمل عملاً هائلاً بقدرته الإلهية فى تخليص أرواح الذين رقدوا على الرجاء ونقلها من الجحيم إلى الفردوس، وذلك بعد أن فتح الفردوس باستحقاقات دمه الذى سفك على الصليب.
وحسناً تقرأ الكنيسة المقدسة سفر الرؤيا بكامله فى هذه الليلة.. وهو السفر الذى يتحدث عن الأبدية والعالم الآخر، أو عن علم الآخرة (إسخاطولوجى).. الكنيسة كعروس للمسيح؛ تتأمل فى عمله الخلاصى وتنتظر مجيئه من السماء.. تحتفل بموته وتحتفل بقيامته.. تحتفل بصعوده وتنتظر مجيئه.. تعيش بالإيمان وتعيش بالرجاء.. تعيش العبور وتنطلق بقوته المتجددة نحو أمجاد الأبدية.
سمعان القيروانى
بعد الجلد الرومانى العنيف، واستكمال المحاكمة، خرج السيد المسيح وهو حامل صليبه من قلب مدينة أورشليم، متجهاً إلى أعلى جبل الجلجثة خارجاً عن أورشليم.
وكان طريق الجلجثة طويلاً ومتصاعداً، كما كان الصليب ثقيلاً ومتعامداً.
وقد حمل الرب هذا الصليب الثقيل الذى هو نفسه أداة موته، كما حمل بإرادته خطايانا فى جسده وهى سبب موته.
وقع السيد المسيح على الأرض تحت الصليب، وهو صاعد فى طريق الجلجثة، وذلك لكى نفهم بوضوح أنه لم يستخدم قدرته الإلهية ليمنع الألم والمعاناة عن جسده. فبالرغم من اتحاد اللاهوت والناسوت معاً فى طبيعة واحدة اتحادًا تاماً طبيعياً وأقنومياً يفوق العقل والإدراك، إلا أن اللاهوت لم يتغير بسبب الاتحاد من جهة كونه غير متألم، والناسوت لم يتغير بسبب الاتحاد من حيث كونه قابلاً للألم.. ولكن لأن جسد أقنوم الكلمة هو الذى تألم، لأجل هذا ننسب إليه آلام جسده الخاص. فنقول إن كلمة الله قد تألم لأجل خلاصنا.
ولأن جسده قد نزف كمية كبيرة من الدماء فى الداخل والخارج.. فى الداخل من جراء تمزق الشرايين المحيطة بالقفص الصدرى نتيجة الجلد بكرباج من أعصاب البقر، تنتهى أطرافه بقطع معدنية أو أجزاء مدببة من عظام البقر. والكرباج تنغرس نهايته فى داخل الجلد مع كل جلدة بسيوره الثلاثية، وتمزق فى الداخل الشرايين المحيطة بضلوع القفص الصدرى وتُحدِث نزيفاً داخلياً.
وفى الخارج كان الدم ينزف من رأسه المتوج بالشوك، ومن الجراحات السطحية الناتجة عن الجلد العنيف بأعصاب البقر على الطريقة الرومانية( ).
ومع هذا النزيف الذى استمر منذ وقت الجلد أثناء المحاكمة، بدأ السيد المسيح يشعر بالإعيـاء، وعدم القدرة على بذل المجهـود المعتـاد، فكم بالأولى حمل هذا الصليـب الثقيل، وهو يزحف بثقله من خلفه على أرض غير مستوية وصاعدة، تلاحقه كرابيج من العسكر الرومان بغير شفقة ولا رحمة.
لهذه الأسباب إلى جوار الآلام النفسية الناشئة عن إحساسه بالجحود ونكران الجميل من البشرية التى أخطأت فى حقه وهو يسعى لأجل خلاصها، ومن الأمة اليهودية التى طالبت بموته بيد الوثنيين، ومن تلميذه الخائن يهوذا الإسخريوطى الذى باعه مقابل ثلاثين من الفضة بعد أن عاش معه فى صحبة طويلة، لهذا كله كان السيد المسيح يقع على الأرض، ومن فوقه صليبه الخشبى الثقيل الذى كان يرتطم بجسده المقدس، حتى شعر قائد المئة أنه لا فائدة من تكرار المحاولة للوصول إلى قمة الجلجثة على هذا الوضع.
ففكر قائد المئة فى تسخير شخص كان عائداً من الحقل “هو سمعان القيروانى أبو ألكسندرُس وروفس” (مر15: 21). ليحمل صليب الرب يسوع ويسير معه فى موكب الصلب إلى أعلى الجلجثة.
طوباك أنت يا سمعان يا من استحققت أن تحمل صليب فاديك وتسير معه إلى الجلجثة..
يا من أوضحت بمثال مسيرة كل قديس يتبع السيد المسيح حاملاً الصليب، الذى ليس هو سوى صليب السيد المسيح نفسه. كقول معلمنا بولس الرسول: “لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته” (فى3: 10).
إن من يتألم من أجل السيد المسيح فله الطوبى.. وهو لا يتشبه بالمسيح فقط، بل يشترك معه فى حمل صليبه المحيى.
كثيرون يحملون الصليب للزينة على صدورهم، ولكن ليتهم يحملونه فى قلوبهم.. ليتهم يعانقونه.. ليتهم يصعدون مع السيد المسيح إلى الجلجثة، مرددين قول معلمنا بولس الرسول: “إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه” (رو8: 17).
قد تأتى علينا التجارب والآلام ونظن أن الرب قد تخلى عنا، ولكن هذه الآلام تكون هبة وعطية من الله كقول الكتاب: “لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضاً أن تتألموا لأجله” (فى1: 29).
لقد سخَّروا سمعان القيروانى ليحمل الصليب فأطاع، ونال هذه البركة. والسيد المسيح نفسه أوصانا قائلاً: “من سخرك ميلاً واحداً، فاذهب معه اثنين” (مت5: 41). فهل نقبل أن نحمل الصليب الذى يسخرنا الرب نفسه لحمله؟ يا له من شرف عظيم، تغنى به بولس الرسول قائلاً: “كما تكثر آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً” (2كو1: 5).
إن صليبى الذى أحمله يا رب، هو نفسه صليبك أنت، الذى حملته لأجل خلاصى.. أنت حررتنى من الهلاك الأبدى بموتك المحيى، وأنا لا يمكننى أن أدفع ثمن خلاصى، لأنه هو دمك الإلهى.. ولكنى على الأقل يمكننى أن أشارك طريق الصليب، وأن أحمل صليبك الذى هو ينبوع خلاصى وفدائى.
إننى حينما أحمل صليبك وأتبعك، فإننى بهذا أكون جزءاً من خطة الله لأجل خلاصى وخلاص الآخرين.. بحسب قول الآباء لى [إن الله الذى خلقك بدونك، لا يخلصك بدونك].
إن إيمانى بك بصورة حية، هو أن أقبل صليبك فى داخلى، مدفوناً معك بالمعمودية للموت، مسلّماً إنسانى العتيق ليصلب معك، حتى باتحادى بك بشبه موتك، أصير أيضاً بقيامتك. فأعطنى يا رب أن أحسب نفسى ميتاً عن الخطية، مجاهداً فى ذلك لكى أحيا لله بك؛ أنت حياتى ومخلصى.
ما أعجب اتضاعك يا إلهى لأنك قبلت أن تقع تحت ثقل الصليب مُظهراً ضعفاً خارجياً، لكى تجتذبنى إلى مشاركة آلامك، حتى لا تفوتنى مشاركة قوة قيامتك.. هكذا يا رب باتضاعك غير الموصوف رسمت لنا طريق الحياة..!!
العود الرطب” (لو23: 31)
فى مسيرة السيد المسيح نحو الجلجثة شرح معلمنا لوقا الإنجيلى حوارًا هاماً حدث فى الطريق بين السيد المسيح والنسوة اللواتى كن يلطمن وينحن عليه.
فبعدما توصّل رؤساء اليهود إلى غرضهم فى إحراج الوالى واستصدار حكم ظالم ضد السيد المسيح إذ “كانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب. فقويت أصواتهم.. فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم.. وأسلم يسوع لمشيئتهم” (لو23: 23-25). بعد ذلك خرج يسوع وهو حامل صليبه بعدما علا صوت الباطل أمام الوالى.
“ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلاً قيروانياً كان آتياً من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتى كن يلطمن أيضاً وينحن عليه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين علىّ، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. لأنه هوذا أيام تأتى يقولون فيها طوبى للعـواقر والبطـون التى لم تـلد، والثّدِى التى لم تُرضـع. حينئذ يبتدئـون يقولون للجبال اسقطى علينا وللآكام غطينا. لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فماذا يكون باليابس” (لو23: 26-31).
كان للسيد المسيح شعبية كبيرة سبق أن أزعجت رؤساء اليهود خاصة فى يوم أحد الشعانين، حينما استقبلته الجموع فى أورشليم كملك “فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا إنكم لا تنفعون شيئاً. هوذا العالم قد ذهب وراءه” (يو12: 19). وقد امتلأ رؤساء اليهود حسداً وغيرة، لسبب شعبية السيد المسيح الجارفة.
لذلك دبّروا المؤامرة وقبضوا عليه فى الليل خلواً من جمع، وأجروا المحاكمة اليهودية ليلاً. ثم سلّموه فى الصباح الباكر إلى الوالى، وأخذوا معهم جمهورهم الخاص الذى كان يطالب بصلب السيد المسيح..
واستيقظت أورشليم فى الصباح، لتجد أن الحكم قد صدر من قبل الحاكم الرومانى وانتهى الأمر ولم يعد فى استطاعة الجماهير التى أحبت السيد المسيح أن تفعل شيئاً، سوى أن تتبعه فى طريق الجلجثة، كما أوضح معلمنا لوقا الإنجيلى “تبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتى كن يلطمن أيضاً وينحن عليه” (لو23: 27).
كان من الطبيعى أن تبكى النسوة ويلطمن على السيد المسيح، الذى وقع عليه كل هذا الظلم وهو برئ. وكان من الطبيعى أن تنكسر قلوب الرجال وهم يبصرون ملك إسرائيل وهو يساق بهذه الصورة المهينة إلى موت الصليب؛ موت العبيد.. ومع رجلين من القتلة والسارقين المجرمين.
لو أتيحت لهم الفرصة أمام الوالى لدافعوا بشدة عن السيد المسيح. ولكن المؤامرة استبعدت الصوت الحقيقى للجماهير، وضخمت صوت الباطل، كما لو كان معبّراً عن إرادة الجماهير وإرادة الأمة. لقد حشدوا جمهوراً محدوداً أمام الوالى يطالب بصلب السيد المسيح، وتجاهلوا مشيئة الجماهير العريضة من الناس وأرادوا أن يشككوا الشعب فى صدق إرسالية السيد المسيح بتطبيق حكم الموت عليه عن طريق التعليق على الخشبة، ليؤكّدوا للشعب الذى أحبه أنه قد صار ملعوناً من الله. لأنه فى سفر التثنية يقول إن “المعلّق ملعون من الله” (تث21: 23).
إلى هذه الدرجة حَبَكَ اليهود المؤامرة حتى أنهم قدموا دليلاً كتابياً من خلال أحداث الصلب على أن السيد المسيح قد صار فى حكم الملعون من الله. وبهذا اهتز وضع السيد المسيح فى أنظار الذين لم يفطنوا إلى خطورة المؤامرة اليهودية.
حقيقة أن السيد المسيح قد حمل لعنة خطايانا على الصليب، ولكنه إذ أوفى العدل الإلهى حقه، فقد محا اللعنة إلى الأبد. وكان دليل قبول ذبيحته وزوال اللعنة، هو أن الله قد أقامه ناقضاً أوجاع الموت، إذ لم يكن للموت سلطان عليه، لأنه كان بلا خطية من جانبه شخصياً.
وقد سبق إشعياء وتنبأ عن هذا الأمر وقال: “نحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولاً. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا” (إش53: 4، 5).
دخل الشك إلى قلوب البعض.. ولكن ذوى القلوب الأمينة الواثقة لم تهزهم المؤامرة المحبوكة. بل بقيت ثقتهم فى قداسة السيد المسيح كما هى، وثقتهم فى قبول الرب لذبيحته الطاهرة كما هى..
ومن أمثلة هؤلاء الأشخاص الأمناء المريمات القديسات اللواتى أحضرن الطيب ليضعنه على جسده المبارك فى فجر الأحد ووجدنه قد قام.
ومن أمثلتهم أيضاً يوسف الرامى ونيقوديموس، اللذان طلبا جسد الرب يسوع من الوالى ولفاه بأكفان غالية وأحاطاه بالحنوط، ووضعاه فى قبر جديد، فى بستان منحوت فى صخرة لم يوضع فيه أحد قط من الناس. لقد قدّما للسيد المسيح بعدما أسلم الروح على الصليب، أغلى ما عندهما، واستحقا أن يسمعا تسابيح الملائكة، وهما يكفنان جسده المقدس وهى تقول: ( قدوس الله ، قدوس القوى، قدوس الحى الذى لا يموت ).
حينما أبصر السيد المسيح النسوة يلطمن وينحن عليه، أراد أن يوجه أنظارهن إلى الحقيقة الثمينة.. ألا وهى أن خطايا البشر هى السبب الحقيقى لآلامه. وأن مؤامرة اليهود وقساوة الرومان، ما هى إلا أدوات استخدمتها حكمة الله ومشورته، ليتحقق من خلالها إبراز حقيقة الصراع بين الخير والشر، والذى لابد أن ينتهى بانتصار الخير فى النهاية.
وقال لهم: “إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فماذا يكون باليابس؟!” وقال هذا ليتذكر كل إنسان أن السيد المسيح وهو العود الرطب، قد تألم عوضاً عنا حينما حمل خطايانا فى جسده، فما الذى يمكن أن يحدث للإنسان غير التائب حينما يتراءى أمام الله بخطاياه غير المغفورة وغير المغسولة بدم السيد المسيح؟.
إن السيد المسيح قد احتمل ظلم الأشرار، لكى يوبخ خطية الإنسان غير التائب. وسيظل صوته الإلهى يدوى فى سمع البشرية “إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فماذا يكون باليابس..؟!”
“أعطوه خلاً ممزوجاً بمرارة ليشرب” (مت27: 34)
لما وصلوا إلى المكان المعروف بالجلجثة، وهو الذى يدعى مكان الجمجمة، أعطوا يسوع “خلاً ممزوجاً بمرارة ليشرب. ولما ذاق، لم يرد أن يشرب” (مت27: 34).
كانت العادة أن يشرب المحكوم عليه بالصلب كمية كبيرة من الخل الممزوج بالمرارة، وذلك قبل أن تبدأ عملية دق المسامير الرهيبة فى يديه وقدميه.
كان المقصود بذلك هو تخدير أعصاب المصلوب لتخفيف شعوره بالآلام المبرحة، أثناء ثقب يديه ورجليه بالمسامير الضخمة التى تخترق الجلد واللحم والأعصاب، وتخترق الأربطة التى تضم عظام المعصمين والقدمين. وكذلك لتخفيف شعوره بالألم أثناء تعليقه على الصليب، إذ يصير جسده بكل ثقله محملاً على جراحات هذه المسامير..
ولما ذاق السيد المسيح هذا المزيج المخدّر، امتنع عن الشرب، لأنه أراد أن يتحمل الآلام كاملة بلا مخدر.. ليوفى العدل الإلهى حقه.. ليدين الخطية فى الجسد.. ليشفى الإنسان من لذة الخطية المهلكة.
بجراحاته شفينا من وجع الخطية، أو بتعبير أوضح من لذة الخطية التى تأسر الإنسان وتسيطر عليه. هذه الآلام التى احتملها مخلصنا هى آلام مخلصة ومحيية، وكان قد وضع فى قلبه أن يشرب الكأس -كأس الآلام- كاملة، كما استلمها من يد الآب فى البستان.
وكما وعد الآب فى طاعته الكاملة له.. هكذا فعل ولم يقبل الهروب من الآلام بكاملها بأية صورة من الصور.
إن طاعة الوصية لم تكن لتكلف الإنسان أكثر من رفضه لجاذبية الخطية -دون أن يتألم الإنسان- ولكن الإنسان انساق وراء شهوة الخطية مقتطفاً لنفسه الموت والضياع.
أما السيد المسيح فكانت طاعته للآب، ليست مجرد امتناعاً عن الشر.. لأن السيد المسيح خالياً تماماً من الشر والخطية ونوازعها، بل كانت طاعته قبولاً للألم من أجل تحرير الإنسان من شهوة الخطية ولذتها وجاذبيتها. وصار قبول الألم والموت هو وسيلة إعلان محبته الحقيقية للكنيسة كعروس له تدخل معه إلى شركة المحبة والألم فى الصليب.
صارت شركة الآلام مع السيد المسيح هى وسيلة الكنيسة فى التعبير عن محبتها له، فى جهادها ضد الشيطان ومملكته الروحية، حتى يملك السيد المسيح على حياتها كعريس محبوب قد أسرتها محبته إلى الأبد.
وصار الصليب فى حياة الكنيسة هو عنها ولها.. لأنه هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن.
فإن “الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات” (غل5: 24).. بل صاروا مستعدين للشهادة من أجل السيد المسيح مثل أولئك الشهداء الذين قد غلبوا الشيطان بدم الحمل وبكلمة شهادتهم “ولم يحبوا حياتهم حتى الموت” (رؤ12: 11).
صلبوه
صلبوه (مت27: 35)، (مر15: 24)، (لو23: 33)، (يو19: 18).
وصفت المزامير بوضوح آلام السيد المسيح، وتعليقه على خشبة الصليب، بثقب يديه ورجليه. وأبرز ما فى عملية الصلب، هو تسمير جسده بالمسامير على الخشبة “ثقبوا يدىَّ ورجلىَّ ” (مز22: 16).
الإنسان الحر يستطيع أن يحرك يديه وقدميه ويتحرك كيفما شاء. أما المصلوب فقد قيدت حريته بالكامل على الصليب.
لهذا لم يكن القانون الرومانى يسمح بتنفيذ عقوبة الموت صلباً على من يحمل الجنسية الرومانية، لأنه حر وغير مستعبد.. فالصلب كان للعبيد فقط.
عند اليهود كان الصلب علامة لعنة، حسبما هو مكتوب فى الناموس اليهودى.
وعند الرومان كان الصلب علامة عبودية، حسب القانون الرومانى.
وقد قبل السيد المسيح أن يحمل عنا لعنة الخطية “جعل الذى لم يعرف خطية، خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه” (2كو5: 21).
كما قبل أيضاً أن يصير عبداً ليأتى بنا إلى حرية مجد أولاد الله.
فالذى أعطانا الحرية على صورته ومثاله، ارتضى العبودية ليحررنا من عبودية الخطية.
وهو لم يأخذ صورة العبد فقط، بل ارتضى أن يفقد حريته على الصليب، ويُسمَّر بالكامل، فلا يستطيع أن يتحرك.
الإنسان والحرية
ادّعى بعض الملحدين مثل “سارتر” أن الله قد خلق الإنسان حُراً. ثم أراد أن يسلب منه الحرية، ويجعله مستعبداً له، فأعطاه الوصية الإلهية.
ولذلك طالب سارتر بتحرير الإنسان من الخضوع لله ولوصاياه، معتقداً أن الحرية هى أن يفعل الإنسان كل ما يريد وكل ما يشتهى.
لم يفهم ذلك المسكين أن الحرية الحقيقية هى أن يتحرر الإنسان من الشر، ومن عبودية الخطية، وأن المستعبد للخطية لا يستطيع أن يفعل ما يريد. بل غالباً يفعل ما لا يريد. وأن الإنسان المحب لله هو الذى يحقق بالفعل الهدف من وجوده، كصورة لله فى القداسة والحق والحرية الحقيقية.
فالحرية هى أن يصل الكائن إلى المثالية، لا أن ينحدر إلى الحضيض..
لهذا قال السيد المسيح: “إن حرركم الابن، فبالحقيقة تكونون أحراراً” (يو8: 36).
إننا نقف متعجبين أمام الصليب :
فالله الذى ادعّى عليه البعض أنه يريد أن يسلب الإنسان حريته، قد ارتضى أن يفقد حريته -بحسب الجسد- على الصليب ثمناً لحرية الإنسان.
هل هناك حب أعظم من هذا؟!.. وهل هناك رد أبلغ من هذا علىكل افتراءات الشيطان والملحدين من أعوانه؟.. إن الله حينما ظهر فى الجسد، صار مستعداً أن يفقد حريته -بل لقد وهبها بالفعل- من أجل تحرير الإنسان، لا أن يسلب من الإنسان حريته.
إن الوصية هى المجال العملى لممارسة حرية الإرادة، وإظهار المحبة الإرادية نحو الله.
لهذا قال السيد المسيح: “إن حفظتم وصاياى، تثبتون فى محبتى. كما أنى أنا قد حفظت وصايا أبى، وأثبت فى محبته” (يو15: 10). وقال أيضاً: “الذى عنده وصاياى ويحفظها، فهو الذى يحبنى. والذى يحبنى يحبه أبى، وأنا أحبه وأظهر له ذاتى” (يو14: 21). وخاطب تلاميذه قائلاً: “أنتم أحبائى إن فعلتم ما أوصيكم به” (يو15: 14).
وقال القديس يوحنا الرسول: “فإن هذه هى محبة الله أن نحفظ وصاياه. ووصاياه ليست ثقيلة” (1يو5: 3).
الله لا يرغب فى إرغام الخليقة على الحياة معه، أو على محبته.. فإننا لا نتصور عريساً يقبل أن تحيا معه عروسه بغير إرادتها.
الإنسان والحياة
المفهوم السليم هو أننا نحيا مع الله لأننا نحبه، ولأننا نعجب بصفاته الجميلة، ولأننا به “نحيا ونتحرك ونوجد” (أع17: 28). وكما قال معلمنا بولس الرسول: “لى الحياة هى المسيح” (فى1: 21).
والسيد المسيح نفسه قال: “أنا هو القيامة والحياة” (يو11: 25)، وقال أيضاً: “أنا هو الطريق والحق والحياة” (يو14: 6) فبقوله: “أنا هو الحياة” أظهر بالفعل أننا به نحيا ونتحرك ونوجد.
الله الآب هو ينبوع الحياة، هو مصدر الحياة.. والله الابن هو الحياة التى نحيا بها، والتى قال عنها القديس يوحنا الإنجيلى “فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس” (يو1: 4).. والله الروح القدس هو روح الحياة، كنز الصالحات ومعطى الحياة، الرب المحيى المنبثق من الآب.
لا يستطيع أحد أن يقول “أنا هو الحياة” إلا الله وحده.. قالها السيد المسيح وأكّدها فى حديثه عن التناول من جسده بقوله: ” أنا هو خبز الحياة.. أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذى أنا أعطى، هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم” (يو6: 48، 51).
كيف نحيا بدون الله إن كان هو مصدر الحياة؟ كيف نتذوق طعم الحياة إلا مع الله؟ الذى وهبنا كل النعم والخيرات فى المسيح يسوع، وسكب فينا روحه القدوس.
لقد جاء السيد المسيح لكى يكشف لنا سر الحياة الحقيقية، وهى أن الله هو ذلك الأب الذى يحب أولاده ويسعى لخيرهم. وقال فى مناجاته للآب قبل الصلب: “أنا أظهرت، اسمك للناس الذين أعطيتنى من العالم” (يو17: 6). أى أنه أظهر لتلاميذه حقيقة الأبوة فى الله. وقال أيضاً: “أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك. أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتنى. وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فيهم” (يو17: 25، 26).
إن لقب “الآب” هو الاسم الثمين الذى اعتز مخلصنا الصالح بأن يعلنه لتلاميذه عن أبيه السماوى القدوس.
“أحصى مع أثمة” (مر15: 28)
استكمل معلمنا لوقا البشير حديثه عن طريق الصليب فقال: “وجاءوا أيضاً باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه” (لو23: 32).
وذكر معلمنا مرقس الإنجيلى أمر هذين المذنبين فقال: “وصلبوا معه لصين واحداً عن يمينه وآخر عن يساره. فتم الكتاب القائل: وأحصى مع أثمة” (مر15: 27، 28).
لم تكن مصادفة أن يموت السيد المسيح مع المذنبين لأن النبوة تقول إنه “سكب للموت نفسه، وأحصى مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع فى المذنبين” (إش53: 12).
لقد “دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع” (رو5: 12). وجاء السيد المسيح لكى يحمل خطايا كثيرين ويشفع فى المذنبين أى أنه لم يمت عن خطية نفسه –فهو بلا خطية- بل عن خطايا غيره. ولكنه تألم: البار من أجل الأثمة، القدوس عوضاً عن الخطاة. لكنه على أية حال كما اشترك الأولاد فى اللحم والدم اشترك فيهما هو أيضاً، وكما اشتركوا فى الموت اشترك فيه هو أيضاً “لكى يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية” (عب2: 14، 15).
كان منتهى الاتضاع: لا أن يقبل السيد المسيح أن يموت فقط، وهو برئ وبلا خطية، بل أن يموت مع الخطاة.. ضمن المذنبين.. وأن يحصى فى وسط الأثمة، والمجرمين.
مات مع الخطاة.. لكى يموتوا هم معه.. ولكى يتغنى كل خاطئ متمتع بالخلاص: “مع المسيح صلبت”.. كما قال معلمنا بولس الرسول: “دفنا معه بالمعمودية للموت” (رو6: 4). “عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه، ليبطل جسد الخطية” (رو6: 6).
كان عارًا كبيراً أن يسير السيد المسيح فى موكب الأثمة، وهو القدوس البار الذى بلا خطية، وكان عارًا أكبر أن يصلب فى الوسط بين لصين، الواحد عن يمينه والآخر عن يساره، وكأنه هو رئيس العصاة والمذنبين .!!
ما هذا العرش يا إلهى البار، الذى علقوك عليه كملك؟!.. هل هو عرش الخزى والعار؟!.. إنه عار خطيتى لكى تملك على عرش قلبى فى الوسط..
إن العالم يتطلع نحوك يا قدوس، وأنت معلق على الجلجثة بين لصين، لكى يرى كل إنسان نفسه هناك فوق الجلجثة مصلوباً معك بصورة رمزية عجيبة.
على يمينك الخطاة التائبون، وعن يسارك الخطاة غير التائبين.. عن يمينك الخراف، وعن يسارك الجداء.. وأنت يا سيدى فى الوسط رئيساً للكهنة.. شفيعاً فى الخطاة.. فأنت الحمل والراعى.. الكاهن والذبيحة.. الهيكل والقربان.
أنت يا رئيس الحياة.. كنت رئيساً بين المائتين.. لأنك أنت الذى حملت خطايا العالم كله.. وهكذا وأنت الحياة قد عبرت بالمائتين التائبين من الموت إلى الحياة.
(عندما انحدرت إلى الموت، أيها الحياة الذى لا يموت. حينئذ أمتَّ الجحيم ببرق لاهوتك. وعندما أقمت الأموات من تحت الثرى. صرخ نحوك جميع القوات السمائيين أيها المسيح الإله معطى الحياة المجد لك) (من ألحان قداس القديس يوحنا ذهبى الفم).
فى تواضعه قبل السيد المسيح أن يحمل عار خطايانا فى جسده.. ولكن هذا قد تألّق بمجد المحبة والفداء، كقول معلمنا بولس الرسول: “ولكن الذى وضع قليلاً عن الملائكة يسوع، نراه مكللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكى يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. لأنه لاق بذاك الذى من أجله الكل، وبه الكل، وهو آتٍ بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام” (عب2: 9، 10).
كان رئيساً للحياة، وصار رئيساً للخلاص.. رئيساً فى الآلام.. هو الرأس المكلل بالأشواك لأجل الكنيسة التى هى جسده، والتى تحمل أيضاً سمات الرب يسوع.
فى صلاة الساعة السادسة تتغنى الكنيسة بمحبة السيد المسيح وتقول (صنعت خلاصاً فى وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب)
هكذا كان السيد المسيح معلقاً فى الوسط بين اللصين، وقد بسط يديه نحو الكل يدعوهم للخلاص. وسوف يبقى منظر الجلجثة الخالد، يهتف نحو الأجيال جميعاً يدعوهم إلى الخلاص بالإيمان به والميلاد الجديد بالمعمودية، يدعوهم إلى شركة آلامه والتمتع بمجده.. يدعوهم إلى العبور بدمه.. يدعوهم نحو السماء؛ وهو معلق بين الأرض والسماء؛ لأنه هو الطريق المؤدى إلى الحياة الأبدية.. فهو الوسيط.. وهو الباكورة.. وهو خادم الأقداس السمائية.. وهو السابق الذى ذهب ليعد لنا الطريق.
العذراء الأم عند الصليب
“وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه، وأخت أمه مريم زوجة كلوبا، ومريم المجدلية” (يو19: 25).. جاءت بكل الإيمان ابنة إبراهيم، لتقف إلى جوار صليب ابنها الوحيد.. نظرت العذراء وحيدها معلقاً فوق الإقرانيون، وتذكّرت كلمات الملاك حينما بشرها بميلاده: “ها أنت ستحبلين، وتلدين ابناً وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماً، وابن العلى يُدعى، ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية” (لو1: 31-33).
كان الوعد صريحاً أن ابنها سوف يملك إلى الأبد، ولن يكون لملكه نهاية..
ولم تكن فى إيمانها أقل من أبيها إبراهيم.. بل قد شهدت لها أليصابات بالروح القدس “طوبى للتى آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب” (لو1: 45).
آمنت بالميلاد العذراوى من الروح القدس وهو أمر عجيب لم يحدث من قبل وتم ما قيل لها.. وآمنت أن ابنها سوف يخلّص شعبه من خطاياهم، وأنه سوف يقوم فى اليوم الثالث كما وعد تلاميذه، وبهذا يملك إلى الأبد..
بهذا الإيمان وقفت العذراء مريم وهى تنظر السيد المسيح منهكاً، ينازع الموت على الصليب، وهو القوى الذى قهر الموت بقوة قيامته.
إبراهيم وذبيحة الابن الوحيد
لقد جاز إبراهيم امتحاناً صعباً حينما قال له الله: “يا إبراهيم.. خذ ابنك وحيدك، الذى تحبه إسحق، واذهب إلى أرض المريا، وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك” (تك22: 1، 2).
وقد شرح معلّمنا بولس الرسول كيف استطاع إبراهيم أن يعبر هذا الامتحان الصعب وذلك بالإيمان فقال: “بالإيمان قدّم إبراهيم إسحق -وهو مجرّب- قدّم الذى قَبِلَ المواعيد وحيده الذى قيل له إنه بإسحق يدعى لك نسل. إذ حَسِبَ أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً” (عب11: 17-19).
كان إبراهيم واثقاً فى صدق وعد الله، بأن النسل المقدس سوف يأتى من إسحق، الذى يتوقف عليه خلاص البشرية بمجيء السيد المسيح من هذا النسل. ولهذا فلم يشك فى صدق وعد الله، وكان متأكداً أن إسحق سوف يعود إلى الحياة من بعد تقديمه ذبيحة.. أى أنه سوف يقوم من الأموات. وبهذا الإيمان أمكنه أن يعبر الامتحان، وأن يتجاوز مشاعره البشرية كأب.. لأنه كان ينظر إلى الأمور المختصة بالأبدية، وليس إلى الأمور الزمنية.
وقد بارك الله إبراهيم وقَبِل ذبيحة محبته “وقال بذاتى أقسمت يقول الرب، إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر، ولم تمسك ابنك وحيدك، أباركك مباركة وأُكثر نسلك تكثيراً.. ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولى” (تك22: 16-18).
إيمان مريم العذراء
هكذا استحقت العذراء مريم التطويب، لأنها آمنت مثلما آمن إبراهيم، أن الله قادر على الإقامة من الأموات..
ولهذا ففى سرد الكتاب المقدس لأحداث القيامة، نرى الكل فى البداية مضطربين ومذبذبين فى تصديقهم لقيامة السيد المسيح، حتى أنه “ظهر للأحد عشر وهم متَّكِئون، ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام” (مر16: 14).
أما السيدة العذراء فلم يذكر عنها شئ من مثل ذلك، بل كانت واثقة من القيامة حتى وهى واقفة عند الصليب.. ولم تتأرجح بين الشك والتصديق مثل مريم المجدلية التى قالت “أخذوا سيدى ولست أعلم أين وضعوه” (يو20: 13)، والتى وبخها السيد المسيح حينما ظهر لها بعد ذلك، وأمرها أن تذهب وتخبر التلاميذ أنه سوف يصعد إلى السماء بعد أن يظهر لهم فى الجليل.
نحن لا ننكر أن جميع التلاميذ قد آمنوا بيقين القيامة بعد أن ظهر لهم السيد المسيح. حتى توما الذى شك فى البداية، عاد فآمن حينما وضع يده فى مكان المسامير والحربة فى جسد الرب القائم من الأموات.
ولكن السيد المسيح طوّب الذين “آمنوا ولم يروا” (يو20: 29). وبهذا طوّب العذراء مريم التى آمنت بالقيامة قبل أن تراها.. ولكنها مع هذا قد فرحت مع ولأجل الكنيسة كلها، حينما أبصرت وحيدها العريس السمائى وهو قائم منتصر مكلل بالمجد.. كما أبصرته وهو صاعد إلى السماء ليجلس عن يمين الله.
طوباك أنتِ يا من ارتفعتِ فوق جميع القديسين، فى إيمانك المتشح بالتواضع وإنكار الذات.. اشفعى فينا أمام ابنك الوحيد ليصنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
“هذا هو ملك اليهود” (لو23: 38)
“وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية هذا هو ملك اليهود” (لو23: 38).
كانت هذه رسالة موجهة إلى العالم كله؛ إلى الفلاسفة اليونان، ورجال السلطة الرومانيين، ورجال الدين العبرانيين.. إلى الأمم بأنواعهم، وإلى اليهود. إن هذا هو المسيح الرب والملك.
وتذكّرت القديسة مريم قول الملاك لها فى البشارة: “ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية” (لو1: 32، 33).
تذكّرت أيضاً ما رآه دانيال النبى فى رؤياه وسجّله فى السفر قائلاً: “كنت أرى فى رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه. فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض” (دا 7: 13، 14).
ألم تبصر السيدة العذراء المجوس الذين جاءوا من المشرق قائلين: “أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا لنسجد له؟” (مت2: 2).
هذا الذى قال عنه الملاك المبشر للرعاة: “ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب” (لو2: 10، 11).
ومدينة داود هى بيت لحم اليهودية التى قال عنها ميخا النبى: “أما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لى الذى يكون متسلطاً على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل” (مى5: 2).
كيف ملك السيد المسيح ؟
عندما اقترب السيد المسيح من الصليب فى الأسبوع الأخير، حدثت مناقشة بينه وبين الجمع الذى كان واقفًا من اليهود إذ قال السيد المسيح: “الآن دينونة هذا العالم. الآن يُطرح رئيس هذا العالم خارجًا. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلىّ الجميع. قال هذا مشيرًا إلى أيَّة ميتة كان مزمعًا أن يموت. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد. فكيف تقول أنت إنه ينبغى أن يرتفع ابن الإنسان. من هو هذا ابن الإنسان؟” (يو12: 31-34).
كان فهم اليهود لأسفار الكتاب المقدس مرتبطاً بآمال وتطلعات أرضية، لذلك كانوا ينتظرون مجيء المسيح الملك الذى سوف يملك على جميع شعوب العالم وتبقى مملكته على الأرض إلى الأبد.
كانوا يعتقدون -بحسب فهمهم الخاص- أن الله قد ميّزهم على كل شعوب الأرض وأن مملكة داود سوف تمتد لتشمل الأرض كلها وتخضع لهم كل شعوب العالم تحت رئاسة المسيح المنتظر من نسل داود.
لذلك تعجبوا من قول السيد المسيح: ” أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلـىّ الجميع” ( يو12: 32). فسواء كان المقصود بكلامه –فى نظرهم- الارتفاع على الصليب كما قصد هو نفسه أو مغادرة هذا العالم بمفارقة روحه لجسده، أو حتى بصعوده حياً إلى السماء.. فإن كل هذه الأمور قد تتعارض مع اعتقادهم بالملك الأرضى الذى كانوا يتطلعون إليه بشوق كبير جعلهم لا يفهمون طبيعة إرسالية السيد المسيح إلى العالم.
ربما اتجهت أنظارهم إلى ما ورد عن المسيح فى نبوءة دانيال النبى “كنت أرى فى رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه. فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض” (دا 7: 13، 14).
وكشعب كان يعانى فى ذلك الوقت من الاستعمار الرومانى الذى فرض عليهم الجزية وأساء معاملتهم، كانت أشواقهم ملتهبة نحو مجيء المسيح الذى يحررهم من الاستعمار ويقيم مملكة داود، ويجعل كل شعوب العالم تتعبد له وتدفع له الجزية “كل الشعوب والأمم والألسنة”. ويظل هذا الوضع قائمًا على الأرض إلى الأبد بلا زوال ولا انقراض. وبذلك يحيون فى سعادة جسدية لا تعانى من استعمار ولا من حروب ولا من جوع ولا من عوز يتفوقون فيها على كل شعوب العالم ويستعبدونهم.
كان السيد المسيح قد ذكر فى نقاشه مع تلميذيه أندراوس وفيلبس عبارة: “ابن الإنسان” إذ قال لهما رداً على طلب اليهود اليونانيين الذين صعدوا ليسجدوا فى العيد أن يروه “قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان” (يو12: 23). وبعدها قال لأبيه السماوى: “أيها الآب مجّد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجّد أيضاً. فالجمع الذى كان واقفاً وسمع قال قد حدث رعد. وآخرون قالوا قد كلّمه ملاك. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلى صار هذا الصوت بل من أجلكم” (يو12: 28-30).
ارتبك الجمع لسبب ما سمعوه من كلام السيد المسيح، وما حدث فى حديثه مع الآب السماوى. واختلط عليهم الأمر ما إذا كان هذا هو المسيح. لذلك بدأوا يقارنون بين كلام السيد المسيح وبين مفاهيمهم الشخصية فى تفسير الأسفار المقدسة وقالوا: “نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد. فكيف تقول أنت إنه ينبغى أن يرتفع ابن الإنسان. من هو هذا ابن الإنسان؟” (يو12: 34).
والمقصود هنا فى كلامهم هل أنت هو ابن الإنسان المذكور فى نبوة دانيال “مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقرّبوه قدامه. فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب.. سلطانه سلطان أبدى..” (دا 7: 13، 14). وإن كنت أنت هو فلماذا لن تبقى على الأرض وتملك إلى الأبد؟ خاصة وأنت تقول: “قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان” (يو12: 23). ودانيال يقول عن ابن الإنسان أنه قد أعطى سلطاناً ومجداً.. وسلطانه.. ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض..
لم يفهم اليهود أن ملكوت المسيح الأبدى هو ملكوت السماوات، وأن مجد المسيح هو مجد الروحيات وليس الأرضيات، وأن حرية المسيح هى الحرية من الخطية؛ الحرية التى سوف يحرر بها شعبه من عبودية إبليس ومن الهلاك الأبدى. ولكن للأسف قد أعمى الشيطان عيون اليهود لكى لا يؤمنوا به.
وقد علّق القديس يوحنا الإنجيلى على هذه الواقعة والمناقشة بقوله: “ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. ليتم قول إشعياء النبى الذى قاله: يا رب من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب. لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا لأن إشعياء قال أيضاً: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلّم عنه..” (يو12: 37- 41).
أين مَلَكَ السيد المسيح؟
قال السيد المسيح: “أنا إن ارتفعت عن الأرض، أجذب إلى الجميع. قال هذا مشيراً إلى أية ميتة كان مزمعاً أن يموت” (يو12: 32، 33).
وقال أيضاً لليهود: “متى رفعتم ابن الإنسان، فحينئذ تفهمون أنى أنا هو” (يو8: 28).
فى كل ذلك كان يؤكد أنه سوف يملك على خشبة الصليب، لأنه بالصليب سوف يجتذب إليه الجميع، ويصير ملكاً على قلوبهم. وبالصليب سوف يفهم البشر أن يسوع المسيح -ابن الإنسان- هو هو نفسه ابن الله الوحيد، الذى غلب الموت وانتصر عليه، بقيامته منتصراً من الأموات.
هذا ما قاله معلمنا بطرس الرسول مع باقى الآباء الرسل لليهود فى يوم الخمسين عن صلب السيد المسيح: “هذا أخذتموه مسلَّماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدى أثمة صلبتموه وقتلتموه. الذى أقامه الله ناقضاً أوجاع الموت إذ لم يكن ممكناً أن يُمسك منه” (أع2: 23، 24).
ثم تكلّم عن داود وملكه فقال: “فإذ كان نبياً وعلِم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلّم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه فى الهاوية، ولا رأى جسده فسادًا. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهود لذلك” (أع2: 30-32).
واستخلص معلمنا بطرس الرسول النتيجة بقوله: “فليعلم يقيناً جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذى صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً” (أع2: 36).
” لا يكون لملكه نهاية ” (لو1: 33)
مهما بلغ ملوك العالم إلى قمة المجد والعظمة والسلطان، فإن مُلكهم قد زال بموتهم.. انهزموا جميعاً أمام الموت.. ولم ينتصر أحد منهم عليه.
فكم من ممالك زالت وانقضت؟.. وكم من حضارات تبدلت وطغت عليها حضارات أخرى.
أراد ملوك المصريين القدماء أن يخلدوا مُلكهم، فاخترعوا فن التحنيط وفنون المقابر والرسوم والألوان، والتماثيل والأهرامات وغيرها.. ولكن هذه كلها لم تحفظ لهم المُلك.. بل جسدت مأساة الإنسان فى قمة حضارته وقدرته، وفى قمة هزيمته أمام الموت. كان الأمل الوحيد للإنسان هو القيامة من الأموات..
وجاء السيد المسيح ليصير باكورة للراقدين.. وليمنح الحياة الأفضل للذين قبلوه حتى للذين لم يعرفوا فن التحنيط.
هذا هو الملك الحقيقى الذى قال عن نفسه: “أنا هو القيامة والحياة. من آمن بى ولو مات فسيحيا ” (يو11: 25).
سلطاناً ومجداً وملكوتاً
تحقق قول دانيال النبى: “فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض” (دا 7: 14).
ما هو هذا السلطان ؟
إنه سلطان الحياة الأبدية الذى قال عنه السيد المسيح فى مناجاته للآب قبل الصليب مباشرة: “أيها الآب قد أتت الساعة مجّد ابنك، ليمجدك ابنك أيضاً. إذ أعطيته سلطاناً على كل جسد، ليعطى حياة أبدية لكل من أعطيته” (يو17: 1، 2). وصار له السلطان أن يمنح الحياة الأبدية للذين قبلوه وآمنوا به.
وما هو هذا المجد ؟
إنه مجد القيامة الذى قال عنه السيد المسيح لتلاميذه: “كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده” (لو24: 26).
وما هو هذا الملكوت ؟
إنه مُلك الله على قلوبنا هذا الذى اشترانا كقول الكتاب “أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم، الذى لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم. لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله فى أجسادكم وفى أرواحكم التى هى لله” (1كو6: 19، 20).
لقد صرنا هيكلاً للروح القدس.. وصار ملكوت الله داخلنا، كما وعدنا السيد المسيح.. وصرنا أولادًا لله “فإن كنا أولادًا، فإننا ورثة أيضاً. ورثة الله ووارثون مع المسيح” (رو8: 17).
إن من يملك الله على قلبه وعلى حياته، يصير مؤهلاً لميراث ملكوت السماوات فى المجد الأبدى.
“اقتسموا ثيابى بينهم” (يو19: 24)
“ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع، أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام، لكل عسكرى قسماً. وأخذوا القميص أيضاً. وكان القميص بغير خياطة، منسوجاً كله فى فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابى بينهم، وعلى لباسى ألقوا قرعة” (يو19: 23، 24، انظر أيضاً مز22: 18).
هذه الأقسام الأربعة لثياب السيد المسيح ترمز إلى الأناجيل الأربعة التى بشرت بموته وقيامته.
أما القميص (الرداء الداخلى) الذى لم يشقه العسكر، لأنه منسوج كله من فوق إلى أسفل، فهو يرمز إلى أن بشارة الخلاص هى واحدة لا تتجزأ ولا تنفصل.
ومن المعروف أن الأناجيل الأربعة ترمز إليها الأربعة الأحياء غير المتجسدين: الذى له وجه الإنسان، والذى له وجه العجل (أو الثور)، والذى له وجه الأسد، والذى له وجه النسر.
فإنجيل متى يرمز له بوجه الإنسان، لأنه يقدّم المسيح ابن الإنسان “كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم” (مت1: 1).
وإنجيل لوقا يرمز له بوجه الثور، لأنه يقدّم المسيح خادم الخلاص الذبيح “طفلاً مقمطاً مضجعاً فى مذود” (لو2: 12).
وإنجيل مرقس يرمز له بوجه الأسد، لأنه يقدّم المسيح القوى صانع المعجزات “إنجيل يسوع المسيح ابن الله” (مر1: 1).
وإنجيل يوحنا يرمز له بوجه النسر، لأنه يقدّم المسيح باعتباره الله الكلمة المتجسد. فهو يشير إلى ألوهية السيد المسيح “الكلمة صار جسداً وحل بيننا، ورأينا مجده مجداً كما لوحيدٍ من الآب” (يو1: 14).
هذه الأحياء الأربعة غير المتجسدة الحاملة للعرش الإلهى، ترمز إلى مراحل الخلاص الأربعة (الميلاد، الصلب، القيامة، الصعود) فى حياة السيد المسيح:
فالميلاد أو التجسد يرمز إليه وجه الإنسان.
والصلب يرمز إليه وجه الثور (الذبيحة).
والقيامة يرمز إليها وجه الأسد (الغالب).
والصعود يرمز إليه وجه النسر (الطائر المُحلق فى السماء).
وبالرغم من أننا نفهم هذه المراحل من حيث التفاصيل، ولكننا لا ننظر إليها من ناحية الفصل. أى لا نفصلها عن بعضها البعض. هى مراحل متلاحقة متلازمة، ضرورية لخلاص البشرية فى خدمة السيد المسيح.
فالسيد المسيح فى ميلاده ولد فى المذود فى وسط الحيوانات، التى تقدم منها الذبائح، لكى نفهم أنه قد جاء إلى العالم ليصير ذبيحة. ففى ميلاده أشار إلى صلبه.
وفى قيامته أطلقت عليه الملائكة لقب “يسوع المصلوب” (مت28: 5). فلولا الصليب لما كانت القيامة. وقد احتفظ السيد المسيح بجراحات الصليب فى جسد قيامته. ففى قيامته أشار إلى صلبه.
وعندما ظهر لمريم المجدلية بعد القيامة، حدثها عن الصعود، وطالبها أن تخبر تلاميذه بذلك “اذهبى إلى إخوتى وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم” (يو20: 17). ففى قيامته أشار إلى صعوده.
والعجيب أن حزقيال النبى فى رؤياه، قد رأى لكل واحد من الأحياء الأربعة أوجه أربعة (انظر حز1: 6) هى أوجه الأحياء الأربعة التى وصفها يوحنا الإنجيلى فى رؤياه. وهذا يعنى أن بشارة الأناجيل الأربعة لا تتجزأ وأنها كلها تتكلم عن مراحل الخلاص الأربعة، وإن كان يُرمز إليها بسمة خاصة تميزها دون أن تفصلها.
إلى هذه المعانى العميقة كان يرمز تقسيم ثياب السيد المسيح وعدم شق قميصه. فالثياب قد تم توزيعها إلى أربعة أنصبة، أما القميص فلم يستطع أحد أن يشقه لأنه منسوج كله من فوق إلى أسفل.
” منسوجاً كله من فوق ” (يو19: 23)
كان القميص (الرداء الداخلى) “منسوجاً كله من فوق” (يو19: 23).
حقاً كانت حياة السيد المسيح كلها منسوجة من فوق إلى أسفل.
فهو الكلمة المتجسد وليس الإنسان المتأله. أى أن الإله الكلمة قد صار إنساناً بالتجسد، ولكن لا يوجد إنسان قد تألّه. لأن يسوع المسيح هو نفسه كلمة الله الأزلى، الذى أخذ جسداً حياً بروح عاقلة من العذراء مريم، وولد منها متجسداً بغير تغيير. فابن الله هو هو نفسه ابن الإنسان.
كانت حياة السيد المسيح كلها بتدبير إلهى، وعمله كله بتدبير إلهى “منسوجاً كله من فوق” (يو19: 23). لهذا قال: “طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى، وأتمم عمله” (يو4: 34) وقال للآب: “أنا مجدتك على الأرض، العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته..” (يو17: 4).
وعن صلبه قال: “إن ابن الإنسان ماضٍ كما هو مكتوب عنه” (مت26: 24). وقيل أيضاً: “مسلَّماً بمشورة الله المحتومة وعِلمه السابق” (أع2: 23).
حقاً كانت حياة السيد المسيح كلها سيمفونية رائعة، تشهد لعمل الله وتدبيره وحكمته، مثل ذلك القميص “المنسوج كله من فوق”.
قال السيد المسيح لليهود: “أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق” (يو8: 23).
وقال يوحنا المعمدان عن السيد المسيح: “الذى يأتى من فوق، هو فوق الجميع. والذى من الأرض هو أرضى ومن الأرض يتكلم. الذى يأتى من السماء هو فوق الجميع” (يو3: 31).
لقد سعى الله نحو خلاص الإنسان، وكان عمله كله منسوجاً من فوق (إلى أسفل)، وقدّم محبة لخير الإنسان. وكانت محبته منسوجة من فوق (إلى أسفل)، وأعلن عن ذاته للإنسان، وكان إعلانه منسوجاً كله من فوق (إلى أسفل).
ما أجمل قول يوحنا فى إنجيله “والكلمة صار جسداً وحل بيننا، ورأينا مجده مجداً، كما لوحيدٍ من الآب، مملوءًا نعمةً وحقاً” (يو1: 14). أى أن الابن المتجسد قد أعلن مجد الآب السماوى.
كل ذلك صنعه السيد المسيح لأجلنا، لكى يرفعنا إليه من أسفل إلى فوق، لنتمتع بمجده كما خاطب الآب قائلاً: “أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتنى يكونون معى حيث أكون أنا، لينظروا مجدى” (يو17: 24).
“ثم جلسوا يحرسونه هناك” (مت27: 36)
بعد أن صلب الجند السيد المسيح، جلسوا يحرسونه فى موضع الجلجثة بحسب الأوامر الصادرة إليهم.
كان القصد من الحراسة الموضوعة، هو متابعة تنفيذ الحكم بالموت صلباً إلى نهايته. فالمصلوب يستغرق موته على الصليب وقتاً ليس بقليل ويحتاج إلى حراسة لكى لا يأتى أحد وينزله من على الصليب وينقذه من الموت.
فى الوضع العادى قد يبقى المصلوب عدة أيام، وهو يتألم ويعانى من التعليق على الصليب، ومن العطش والجوع وضيق التنفس، حتى تنتهى مقاومته تماماً ويموت فى النهاية.
ولكى يتم التعجيل بالموت تكسر سيقان المصلوبين، لكى لا يتمكنوا من التنفس ويموتوا بالاختناق. فالمصلوب يعتمد فى تنفسه على ارتكازه على قدميه على مسمار القدمين، إذ يرفع جسده إلى فوق لكى يخف الشد على الساقين، ويرتخى القفص الصدرى ويتمكن من الشهيق. أما إذا كسرت ساقاه، فلا يمكنه أن يتنفس، لأن عضلات القفص الصدرى تكون مشدودة بقوة فى اتجاه الساعدين.
أما السيد المسيح فلم يستغرق موته على الصليب أكثر من ثلاث ساعات. حيث إنه كان قد تعرض منذ الصباح للجلد الرومانى العنيف، الذى
أحدث نزيفاً داخلياً شديداً. هذا بالإضافة إلى جراحات المسامير فى اليدين والقدمين، وجراحات إكليل الشوك وسائر جراحات الضرب والجلد الخارجية، التى كانت تنزف جميعها دماً مستمراً، أدى إلى هبوط حاد فى عضلة القلب، نتيجة النزيف الداخلى والخارجى، الذى تحقق به قول الرب: “دمى الذى يُسفك عنكم” (لو22: 20).
وعلى العموم فقد كان قرار اليهود هو أن تكسر سيقان المصلوبين فى ذلك اليوم قبل غروب الشمس، وذلك لكى لا تبقى الأجساد على الصليب فى السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيماً (انظر يو19: 31). “سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقى الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات” (يو19: 31-33).
ولكن حراسة الجند للسيد المسيح المصلوب لم تكن مصادفة، لأن المشهد بذلك يقود أفكارنا للتأمل إلى الفردوس الأول، ونتذكر قول الكتاب “فطرد الإنسان وأقام شرقى جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة” (تك3: 24).
جلس العسكر يحرسون السيد المسيح المعلّق على خشبة الصليب. ولم يفهموا بذلك أنهم يذكروننا بالصورة النبوية المعلنة فى سفر التكوين عن حراسة طريق شجرة الحياة، أليس الصليب هو شجرة الحياة التى لا يموت آكلوها؟
هؤلاء العسكر يذكروننا دون أن يدروا بحراس الأسرار المقدسة؛ ولكن هل يحتاج السيد المسيح إلى من يحرسه لكى يتمم الفداء؟ لقد جاء السيد المسيح إلى العالم واضعاً الصليب نصب عينيه.. وكان الصليب هو الهدف من مجيئه فادياً ومخلصاً. فلم يكن ممكناً إطلاقاً أن يهرب من الصليب حتى يحتاج إلى حراسة. بل إن الحراس قد صاروا شهوداً للصلب وشهوداً للخلاص الذى تم حتى نهايته.
شهدوا أمام التاريخ -دون أن يقصدوا- بأن يسوع الناصرى قد مات حقاً على الصليب.. تماماً مثلما شهد حراس القبر -دون أن يقصدوا- بأن يسوع المصلوب قد قام حقاً من الأموات.. لأن وجود الحراس كان دليلاً قوياً على صدق واقعة القيامة.
“يا ناقض الهيكل وبانيه” (مت27: 40)
بعد أن قام السيد المسيح بتطهير الهيكل قال له اليهود: “أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟” (يو2: 18) . فقال لهم السيد المسيح: “انقضوا هذا الهيكل، وفى ثلاثة أيام أقيمه” (يو2: 19). وهم فهموا أنه كان يكلمهم عن هيكل الرب فى أورشليم الذى بناه أولاً سليمان، فأجابوه “فى ست وأربعين سنة بنى هذا الهيكل، أفأنت فى ثلاثة أيام تقيمه؟! وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده” (يو2: 20، 21).. عند الصليب تذكر اليهود هذه العبارة التى قالها السيد المسيح؛ “وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه فى ثلاثة أيام، خلّص نفسك” (مت27: 39، 40).
وكانوا يقصدون بذلك أنه لو كان فعلاً يقدر أن يهدم الهيكل ويبنيه بقدرة معجزية باعتباره ابن الله، فإنه من باب أولى يستطيع أن يخلّص نفسه وينزل عن الصليب بمعجزة لا تقاوم. ولهذا استطردوا قائلين: “إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب” (مت27: 40).
ولكن السيد المسيح لم يقل لهم أنه هو الذى سوف يهدم الهيكل بنفسه، بل قال: “انقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه” (يو2: 19). أى أنهم لو هدموا هيكل جسده بالموت على الصليب فإنه سوف يقيمه بعد ثلاثة أيام. وبالطبع لن يتحقق قوله هذا لو نزل عن الصليب.. لأن معجزة القيامة لا يمكن أن تتم إلا من خلال موته بحسب الجسد على الصليب.
كانت القيامة هى أعظم معجزة صنعها السيد المسيح، كقول معلمنا بولس الرسول “وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات” (رو1: 4). وحينما طلب اليهود من السيد المسيح معجزة يؤمنون بسببها فسألوه أن يريهم آية من السماء. أجاب وقال لهم: “جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تُعطى له آية إلا آية يونان النبى” (مت16: 4). وكان السيد المسيح يقصد بهذا خروج يونان حياً من بطن الحوت بعد ثلاثة أيام، فكان رمزاً لدفن السيد المسيح وقيامته.
وقال أيضاً: “متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أنى أنا هو” (يو8: 28). أى أن فهمهم لحقيقة لاهوته، سوف يتحقق بموته على الصليب وقيامته بقوة من الأموات..
فلا مجال إطلاقاً للقول: “إن كنت ابن الله، فانزل عن الصليب” لأن العكس كان هو المطلوب لإثبات ألوهيته مع إتمام الفداء فى آنٍ واحد.
الهيكل
كان اليهود يعتزون جداً بهيكل أورشليم. ولذلك بالرغم من أن ذلك الهيكل كان رمزاً لجسد السيد المسيح الذى أخذه كاملاً من العذراء مريم بفعل الروح القدس، بما فى ذلك الروح الإنسانى العاقل، حينما تجسد ببشرية كاملة، جاعلاً ناسوته واحداً مع لاهوته بغير اختلاط ولا تغيير، فقد كان كل ما فى الهيكل أيضاً يرمز إلى تجسد ابن الله الكلمة، وإلى ذبيحة الصليب الخلاصية.
فتابوت العهد كان يرمز إلى جسد السيد المسيح، وما فى داخله يشير إليه. مثل لوحى الشريعة يرمزان إلى أن الله قد كلّمنا فى ابنه. وقسط المن الذى يرمز إلى السيد المسيح باعتباره الخبز السماوى. وعصا هرون التى أفرخت بدون زرع ولا سقى، وترمز إلى ولادة المسيح من العذراء مريم بغير زرع بشر.
وهكذا مذبح البخور يرمز إلى كهنوت السيد المسيح، والمنارة ذات السبعة سرج ترمز إلى الأسرار الكنسية السبع التى تتم باستحقاقات دم المسيح، الذى قال بفم النبى: “أما أنا فمثل زيتونة خضراء فى بيت الله” (مز52: 8). ومائدة خبز الوجوه ترمز إلى جسد المسيح فى سر الإفخارستيا..
ومذبح النحاس يرمز إلى ذبيحة الصليب، حيث تقدم الذبائح والمحرقات. والمرحضة ترمز إلى التطهير بالمعمودية.
والخيمة أو المسكن كان يرمز إلى حلول الله فى وسط شعبه، وبهذا يرمز إلى التجسد الإلهى.
ورئيس الكهنة الذى يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة فى السنة، يرمز إلى السيد المسيح الذى دخل إلى الأقداس السماوية مرة واحدة بدم نفسه ووجد فداءً أبدياً.
فلماذا تتجه أنظار اليهود وأفكارهم إلى الهيكل، بعد أن جاءهم الهيكل الحقيقى الذى كانت كل هذه الأمور جميعها ترمز إليه؟
قال الرب: “سأرجع بعد هذا وأبنى أيضاً خيمة داود الساقطة وأبنى أيضاً ردمها” (أع15: 16). ما هى خيمة داود إلا جسم بشريتنا الذى سقط بالخطية فى قبضة الموت، وجاء السيد المسيح لكى يعيد خلقه مرة أخرى. كقول الكتاب “إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة” (2كو5: 17).
وقد أعاد السيد المسيح الصورة الإلهية إلى الإنسان، حينما أخذ جسداً بشرياً كاملاً خالياً من الخطية، جاعلاً إياه واحداً مع لاهوته. وبهذا الجسد افتدى الإنسان من لعنة الخطية والموت، مصالحاً إياه مع الآب، مانحاً إياه أن يصير هيكلاً للروح القدس مع سائر المؤمنين.
فكما أن الهيكل الحقيقى هو جسد السيد المسيح، هكذا منح المؤمنين أن يصيروا على صورته ومثاله هيكلاً للرب.
أما أورشليم السمائية فقد قيل عنها فى سفر الرؤيا “وتكلم معى قائلاً هلم فأريك العروس امرأة الخروف. وذهب بى بالروح إلى جبل عظيم عال، وأرانى المدينة العظيمة أورشليم المقدسة، نازلة من السماء من عند الله. لها مجد الله.. ولم أرَ فيها هيكلاً لأن الرب الله القادر على كل شئ هو والخروف هيكلها” (رؤ21: 9-11، 22).
“فليخلّص نفسه” (لو23: 35)
ابتدأ رؤساء كهنة اليهود مع الكتبة والشيوخ يسخرون ويستهزئون بالسيد المسيح قائلين: “خلّص آخرين فليخلّص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله” (لو23: 35). “وكان المجتازون يجدِّفون عليه وهم يهزّون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه فى ثلاثة أيام خلّص نفسك. إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب” (مت27: 39، 40). كان المطلوب فى نظرهم أن يخلّص نفسه من الصليب ومن الموت لكى يثبت لهم أنه هو المسيح..!!
مع أن عمل السيد المسيح الرئيسى كان هو أن يُصلب وأن يموت عوضاً عن الخطاة ليخلّصهم.
كانت عبارة “خلّص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلِّصها” (مت27: 42) والتى رددها المستهزئون به، هى عبارة استهزاء، وعبارة صادقة فى وصف الصلب فى آنٍ واحد.
نطق بهذه العبارة رؤساء كهنة اليهود بروح السخرية، ولكنهم قدّموا لنا وصفاً دقيقاً لحالة السيد المسيح وقت الصلب.
بالفعل خلّص آخرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلِّصها، أو لم يرد أن يخلِّصها من الصلب، لأنه وهب نفسه فداءً عن الآخرين الذين أراد أن يخلِّصهم.
كان باستطاعة السيد المسيح أن يدفع عن نفسه الموت والصلب.. ولكنه لو فعل ذلك لما أمكن أن يخلّص الآخرين.
نفسه لم يقدر أن يخلِّصها.. أو لم يرغب أن يخلِّصها لأنه اختار الصليب.. بل رسم لنفسه طريق الصليب.. وكان الصليب فى فكر الله منذ الأزل.
تكلّم معلمنا بولس الرسول عن مقاصد الخلاص ونتائجه التى هى فى فكر الله منذ الأزل، فقال: “وأنير الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فى الله خالق الجميع بيسوع المسيح” (أف3: 9). وقال أيضاً: “حسب قصد الدهور الذى صنعه فى المسيح يسوع ربنا” (أف3: 11).
ولكن السيد المسيح، عموماً، قد رد بصورة بالغة على افتراء اليهود بأن نفسه هو “لم يقدر أن يخلِّصها”. وذلك لأنه بعد أن بذل نفسه للموت على الصليب، فإنه قد قام منتصراً من الأموات بقدرته الإلهية. وبهذا أظهر قدرته فى الانتصار على الموت، وأنه “يقدر أن يخلِّصها” ولكن بالطريقة التى يتم بها أيضاً خلاص الآخرين.
حقاً قال معلمنا بولس الرسول إن “جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس” (1كو1: 25). والمقصود بذلك أن ما يبدو جهالة فى نظر الناس من أعمال الله هو أحكم من حكمتهم السطحية. وأن ما يبدو ضعفاً فى أعمال الله فى نظر الناس هو أقوى من القوة. ولكن المشكلة هى فى عدم فهم الناس لحقيقة الحكمة، ولحقيقة القوة.
وعلى هذا الأساس “اختار الله جهال العالم ليخزى الحكماء. واختار الله ضعفاء العالم ليخزى الأقوياء. واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود لكى لا يفتخر كل ذى جسد أمامه” (1كو1: 27-29).
وحتى معلمنا بولس الرسول نفسه الذى كان متعلّماً ومتعمقاً فى الدراسات الناموسية الدينية، فإنه لم يتكل على هذه الأمور بل ضحى بكل شئ وبدأ يكرز بقوة الروح القدس. حسبما قال هو نفسه: “لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهى قوة الله. لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء، وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم، أين الكاتب، أين مباحث هذا الدهر؟.. ألم يجهّل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم فى حكمة الله، لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلِّص المؤمنين بجهالة الكرازة” (1كو1: 17-21).
وقد شرح معلمنا بولس الرسول معنى جهالة الكرازة التى قصدها فقال إن الصليب بما يبدو فيه من ضعف ظاهرى هو منتهى القوة، وبما يبدو فيه من ضياع ظاهرى هو منتهى الحكمة، وبما يبدو فيه من أمور تدعو إلى السخرية والهزء هو منتهى المجد المتألق!!.
قال موضحاً ذلك “لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة. ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوّين يهوداً ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله” (1كو1: 22-24).
القلب البسيط يرى فى الصليب منتهى الحب، والقلب القاسى أو المتكبر يرى فى الصليب منتهى الضعف.
القلب الباحث عن الخلاص يرى فى الصليب مرساة النجاة، وقوة العبور من الخطية إلى القداسة.. أما القلب المحب للخطية فيرى فى الصليب معطلاً لشهواته، وعقبة فى تحقيق رغباته فيزدرى به ويرفضه.
الصليب صار هو أنشودة الحب التى تعزفها قيثارات قلوب القديسين، وهو موضوع الشكر والحمد والتسبيح لربوات الملائكة ولجموع المفديين.
صار ربنا يسوع المسيح هو الحب الأبدى الذى عانقته البشرية فى عرس السماء والمجد، وهو الحياة المتدفقة التى بها يحيا كل مشتاق إلى الله يترنم مع الشاعر ويقول:
أنت قصيدة شعر تنطق فـى نفســى
أنت قيثـارة حب يـعـزفــهـا قلبـــى
أنت نجوم الليــل وخيــوط الفـجــر
أنت الخبـز الحـىّ فى هيكل جسدى
كلمات السيد المسيح فوق الصليب
1) ” يا أبتاه اغفر لهم .. ” (لو23: 34)
“يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون” (لو23: 34) أوصانا السيد المسيح بمحبة الأعداء والصلاة لأجلهم، فكان جديراً به هو شخصياً أن يفعل ذلك فى أحرج الأوقات، وفى قمة العذاب والمعاناة.
لهذا صلّى وهو معلق على الصليب من أجل صالبيه طالباً لهم الغفران.
هذه الصلاة يمتد مفعولها وتأثيرها إلى كل خاطئ أراد أن يتوب. لأن السيد المسيح كان مجروحاً لأجل خطايانا. فبهذه الصلاة أعلن أنه يشفع أمام الآب من أجل غفران خطايا كل من يندم عل خطيته.
لو لم يقل السيد المسيح هذه العبارة لظن كل من اشترك فى صلبه أنه لا يمكن أن تغفر خطيته.
ولعلنا نقف أمام عبارات قائد المئة الذى قاد عملية الصلب: “حقاً كان هذا الإنسان ابن الله” (مر15: 39)، و”بالحقيقة كان هذا الإنسان بارًا” (لو23: 47). فقائد المئة قد آمن بالمسيح، والجندى لنجينوس الذى طعن البار فى جنبه ورد عنه فى التقليد الكنسى أنه آمن بالمسيح وصار شهيداً..
2) ” اليوم تكون معى فى الفردوس ” (لو23: 43)
لقد قيّد السيد المسيح الشيطان ولم يعد له سلطان أن يقتنص الأرواح، أرواح المفديين. ولم تعد الهاوية تفتح فاهها لكى تبتلع أرواح البشر حتى القديسين منهم. بل وقد فتح طريقاً إلى الفرودس وأعطى وعده الصادق للّص قائلاً: “الحق أقول لك إنك اليوم تكون معى فى الفردوس” (لو23: 43) نعم هو الحق كل الحق، هو حق يفوق التصديق أن هذا اللص يدخل فى وسط جماعة القديسين والأبرار، كان من المحال أن يتم هذا كله إلا إذا كان هناك دم زكى قد سُفك، لذلك عندما قال له السيد المسيح عبارة “الحق أقول لك” كان يقولها وهو واثق لأنه يدفع الثمن. وحينما نطق السيد المسيح بهذه العبارة للص، كان يقولها أيضاً لكل البشر الذين عاشوا تحت الخطية.
يرمز اللص اليمين إلى البشر الذين بالصليب قد تحرورا من فكر إبليس وطغيانه، الذين بالصليب قد أشرقت عليهم أنوار معرفة الله، الذين بالصليب قد اعترفوا بألوهية السيد المسيح مثلما صرخ اللص معترفاً بألوهيته قائلاً: “اذكرنى يا رب متى جئت فى ملكوتك” (لو23: 42) ومعترفاً بصلاحه وبره الكامل أيضاً. ولهذا فقد سمع صوت الرب القائل: اليوم تكون معى فى الفردوس، لأن فى ذلك اليوم صنع الرب خلاصاً عظيماً، فى ذلك اليوم رد الرب آدم وبنيه إلى الفردوس مرة أخرى، فى ذلك اليوم أعاد السيد المسيح إلى الإنسان كرامته وعزته ورفعته وصورته الإلهية التى فقدها بسبب الخطية، وقال له: اليوم تكون معى فى الفردوس، كما كنت معى على الصليب تكون معى فى الفردوس، كما كنت معى بعواطفك وبقلبك وبفكرك، بوجدانك وبلسانك، بشهادتك بموقفك، بدفاعك عنى أمام اللص غير التائب وقلت له: “أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس فى محله” (لو23: 41) سوف تكون معى فى الفردوس. لأنك كنت معى بأشواقك برجائك بصبرك بقبولك الألم بأنك قد شعرت بذلك الشرف العظيم أنك قد صُلبت معى كما قال معلمنا بولس الرسول: “مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فىَّ” (غل2: 20)، فستكون معى فى الفردوس.. فإذا قلنا أجمعنا مع المسيح صلبنا لأننا دفنا معه فى المعمودية للموت؛ فاللص اليمين قالها بالفعل، بل وهو الوحيد فى كل البشر وفى كل تاريخ البشرية من آدم إلى آخر الدهور الذى عندما يقول: “مع المسيح صُلبت” يكون المعنى بالنسبة له منطبق روحياً وفعلياً وزمنياً ومكانياً.. نحن نُصلب مع المسيح فى المعمودية بعمل الروح القدس الإعجازى لكن اللص صُلب مع المسيح فعلاً وكان بجواره على الصليب.
رتّب السيد المسيح وهو على الجلجثة أن يُصلب بين لصين محكوم عليهما بالموت ليكونا رمزاً للبشرية كلها لأن “الجميع زاغوا وفسدوا معاً ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله” (رو3: 12، 23)، قسم الرب البشر إلى قطاعين الذين عن يمينه وهم الخراف والذين عن يساره وهم الجداء “ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميّز بعضهم من بعض كما يميّز الراعى الخراف من الجداء. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار” (مت25: 32، 33).. فوق الجلجثة البشر كلهم ممثلين فى السيد المسيح واللصين: السيد المسيح يمثل البشرية من جهة أنه الوحيد الذى استطاع أن يكون بلا خطية وأن يُرضى قلب الآب وبهذا فهو الفادى والمخلّص، وعلى يمينه الذين تابوا ونالوا الخلاص، وعلى يساره الذين لعنوه أو رفضوه أو لم يقبلوا أن يؤمنوا به.
3) ” هوذا ابنك.. هوذا أمك..” (يو19: 26، 27)
“فلما رأى يسوع أمه، والتلميذ الذى كان يحبه واقفاً. قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته” (يو19: 26، 27).
على قمة الجلجثة.. فى موضع الموت.. حيث يتم تنفيذ حكم الإعدام صلباً، وبلا رحمة.. وقفت الوالدة، بكل ما يحمل قلبها من حب ورقة وحنان ومشاعر الأمومة الصادقة، لتبصر فى لوعة شديدة كل مراحل الصلب والعذاب لوحيدها المحبوب مخلّص العالم.
هكذا كان يليق بالملكة أن تقف إلى جوار الملك وهو يملك على الخشبة، وترافقه بمشاعر محبتها الأمينة والوفية فى أدق اللحظات.
لعلنا نسرح بخيالنا أمام هذا المشهد ونتذكر كلمات سفر النشيد وهو يقول “اخرجن يا بنات صهيون، وانظرن الملك سليمان بالتاج الذى توجته به أمه فى يوم عرسه، وفى يوم فرح قلبه” (نش3: 11).
إن كانت الأمة اليهودية -كأم- قد توجت السيد المسيح بإكليل من شوك فى يوم عرسه، حينما اشترى الكنيسة -كعريس- بدمه على الصليب، إلا أن العذراء مريم.. كأم حقيقية.. بإدراكها لأبعاد الخلاص وبقبولها لتقديم وحيدها نفسه ذبيحة عن حياة العالم، قد توجّته بمشاعر محبتها وهى تقترب من المشهد بكل تسليم، وقد وهبت أمومتها الشخصية لأجل الكنيسة.. فاستحقت أن تصير أماً للجميع.
وقد أكّد السيد المسيح هذه الحقيقة حينما وهب أمه ليوحنا تلميذه المحبوب.. جاعلاً إياها أماً للرسل ولجميع المؤمنين والشهداء، وصارت أماً روحية لكل من يؤمن بيسوع المسيح.. إلى جوار أنها هى العذراء الأم والدة الإله.
الصليب والعذراء ويوحنا واللصين، يعبّر هذا المشهد عن الكنيسة كلها، جانب به أناس خطاة تائبين، والجانب الآخر أناس خطاة غير تائبين، والعذراء الشفيعة المؤتمنة، ويوحنا يرمز إلى كهنة العهد الجديد وخدام الرسل والكارزين والمبشرين الذين يخدمون خدمة المصالحة وقد صارت العذراء أماً لهم لأن العذراء هى رمز للكنيسة، والكنيسة هى أيضاً رمز للعذراء التى صار بها الخلاص لجنسنا.
4) ” إلهى إلهى لماذا تركتنى؟ ” ( مت27: 46)
“ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إيلى يلى لما شبقتنى، أى إلهى إلهى لماذا تركتنى؟” (مت27: 46).. يقول قداسة البابا شنودة الثالث -أطال الرب حياته: إن هذه العبارة لا تعنى ترك الآب للابن بمعنى الانفصال أو الابتعاد بينهما، ولكنها تعنى {لماذا تركتنى فى هذا العذاب}. مثلما يأخذ أحد الأشخاص ابنه لطبيب الأسنان ويمسك بيده وهو على كرسى الطبيب أثناء الحفر فى أسنانه، وحينما يشعر الابن بالألم يقول لأبيه (يا بابا أنت سايبنى ليه؟!) فيقول له والده (أنا معك يا ابنى ولم أتركك). ويكون ممسكاً بيده طول الوقت. لقد ترك الآب السماوى ابنه الحبيب يتألم ويذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد (انظر عب2: 9).
إن عبارة “لماذا تركتنى؟” قد قالها السيد المسيح فى صيغة سؤال. وكل سؤال له إجابة. وإجابة هذا السؤال نجدها فى إشعياء النبى الذى قال: “أما الرب فسُرَّ بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم” (إش 53: 10) بمعنى؛ أن الآب ترك الابن يتعذب على الصليب لأنه قَبِل بإرادته أن يفتدى البشرية وأن يدفع ثمن عقوبة خطايا البشر. إن فى سؤال السيد المسيح الذى صرخ به على الصليب، دعوة للجميع لكى يبحثوا عن الإجابة. وهى أنه “مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا” (إش53: 5).
يضاف إلى ذلك أن السيد المسيح قد أراد تنبيه رؤساء اليهود إلى بداية المزمور الثانى والعشرين الذى يحوى نبوات كثيرة عن صلبه وعن سخريتهم به. وهو ما تمموه بالفعل وقت أن كان معلقاً على الصليب. فالمزمور الذى يبدأ بعبارة “إلهى إلهى لماذا تركتنى بعيداً عن خلاصى؟” يقول أيضاً “أما أنا فدودة لا إنسان. عار عند البشر ومحتقر الشعب. كل الذين يروننى يستهزئون بى. يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجه. لينقذه لأنه سر به” (مز22: 6-8). لقد أراد السيد المسيح أن يجعلهم يخجلون من هجومهم عليه فنطق ببداية كلمات المزمور المعروف لديهم.
وفى قول السيد المسيح فى نبوة المزمور: “أما أنا فدودة لا إنسان” هل صار بالفعل دودة وليس إنساناً؟! أم أنه يقصد أنه صار فى نظر اليهود مثل دودة محتقرة “عار عند البشر ومحتقر الشعب”. وهكذا عند قوله “لماذا تركتنى” يقصد أنه قد صار متروكاً فى نظرهم فقط لأنه صار مثل المصاب المضروب من الله كقول إشعياء النبى: “ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولاً. وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا” (إش53: 4، 5). فعبارة “ونحن حسبناه” توضح أن هذا كان فى فكر الناظرين إلى المصلوب.
أما ما يحسم القضية فى كل هذا الجدال أنه فى نفس المزمور الذى يصف آلام السيد المسيح وثقب يديه ورجليه يقول: “يا خائفى الرب سبحوه.. لأنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه إليه استمع” (مز22: 23، 24) إذن فالآب لم يحجب وجهه عن الابن على الصليب بل بالعكس لقد استمع إلى صراخه واستجاب له وقبل شفاعته الكفارية عن البشر، وهذا ما تتغنى به الكنيسة عن السيد المسيح فى لحن “Vai `etafenf فاى إيتاف إنف” {هذا الذى أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة}.
ولم يتركنى الآب وحدى
تدّعى إيلين هوايت النبية المزعومة للأدفنتست السبتيين فى كتابها المشهور بعنوان “مشتهى الأجيال” أن يسوع المسيح الابن الوحيد، الإله المتأنس، قد انفصل عن الآب وقت آلامه.
كما ينزلق البعض من الكُتّاب، ويتحدثون عن الترك الحتمى الذى تركه الآب للابن وقت الصلب لكى لا يلحق عار الصليب بالآب، ويستندون فى ذلك إلى قول السيد المسيح على الصليب: “إلهى إلهى لماذا تركتنى” (مت27: 46، انظر مز22: 1).
عدم الترك، وعدم الانفصال
يلزمنا أن نبحث فيما ورد فى الكتب المقدسة عن استحالة ترك الآب للابن بمعنى تباعده عنه، واستحالة انفصاله عنه بأى حال من الأحوال.
عدم الترك
نبدأ بما قاله السيد المسيح نفسه وسجّله القديس يوحنا الرسول فى إنجيله فى عدة مواضع:
ففى حديث السيد المسيح مع تلاميذه فى ليلة آلامه وقبل القبض عليه وصلبه مباشرة قال لهم: “هوذا تأتى ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوننى وحدى. وأنا لست وحدى لأن الآب معى” (يو16: 32).
وفى حديثه مع اليهود، أراد أن يشير إلى أن أحداث صلبه وقيامته المقبلة سوف تكشف للكثيرين أنه هو الله الكلمة المتجسد الذى قهر الموت وانتصر عليه بموته وبقيامته. وأن هذه الأمور كلها هى بتدبير إلهى واحد، وبقدرة إلهية واحدة، لا ينفصل فيها الابن عن الآب، ولا يترك فيه الآب الابن “فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان (أى متى رفعوه على الصليب) فحينئذ تفهمون أنى أنا هو. ولست أفعل شيئاً من نفسى، بل أتكلم بهذا كما علمنى أبى. والذى أرسلنى هو معى ولم يتركنى الآب وحدى لأنى فى كل حين أفعل ما يرضيه” (يو8: 28، 29).
وقد قال إشعياء النبى عن واقعة الصلب: “أما الرب فسرَّ (أى كان مسروراً) بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلاً تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح” (إش53: 10).
فقول السيد المسيح: “لم يتركنى الآب وحدى، لأنى فى كل حين أفعل ما يرضيه” (يو8: 29) ينطبق بالأكثر على واقعة الصلب التى قدّم فيها طاعة حتى الموت للآب السماوى، وصنع مسرته. بدليل قول إشعياء النبى عن الآب أنه “سر بأن يسحقه بالحزن” وعن مسرة الآب به “ومسرة الرب بيده تنجح”.
وإذا كان الآب لم يترك الابن وحده فى أى وقت منذ أن أرسله إلى العالم، لأنه يفعل فى كل حين ما يرضيه، فمن باب أولى لا يتركه حينما يفعل مسرته فى طاعة كاملة بتقديم نفسه ذبيحة من أجل خلاص العالم. ولا شك أن عبارة كل حين تشمل وقت آلامه.
عدم الانفصال
معلوم يقيناً أن الجوهر الإلهى واحد لا يتجزأ ولا ينقسم. ولذلك فإن الآب والابن والروح القدس يجمعهم معاً جوهر واحد وكينونة واحدة ولهم طبيعة إلهية واحدة، بالرغم من التمايز الأقنومى لكل منهم، إذ أن الآب له الأبوة والابن له البنوة والروح القدس له الانبثاق.
وقد تكلّم السيد المسيح كثيراً عن وحدانيته مع الآب فقال فى حديثه مع الآب عن تلاميذه: “ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحدٌ” (يو17: 22) وقال أيضاً: “ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب فىّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتنى” (يو17: 21).
وقال لليهود: “إن كنت لست أعمل أعمال أبى فلا تؤمنوا بى. ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بى فآمنوا بالأعمال لكى تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فىّ وأنا فيه” (يو10: 37، 38). وقال لهم أيضاً: “أنا والآب واحد” (يو10: 30)، بما لا يدع مجالاً للشك فى عدم الانفصال.
وقال السيد المسيح لتلميذه فيلبس ولسائر تلاميذه: “الذى رآنى فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب. ألست تؤمن أنى أنا فى الآب والآب فىّ. الكلام الذى أكلمكم به لست أتكلم به من نفسى لكن الآب الحال فىَّ هو يعمل الأعمال. صدقونى أنى فى الآب والآب فىَّ” (يو14: 9-11).
إنه من المستحيل أن ينفصل الآب عن الابن من حيث لاهوته وإلا دخلنا فى تعدد الآلهة. كما إنه من المستحيل أن ينفصل لاهوت الابن عن ناسوته، أى أن تنفصل طبيعته الإلهية عن طبيعته الإنسانية.
فمثلاً حينما قال السيد المسيح لتلميذه فيلبس: “الذى رآنى فقد رأى الآب.. ألست تؤمن أنى أنا فى الآب والآب فىَّ”، من الواضح أن الذى رآه فيلبس هو جسد السيد المسيح المتحد باللاهوت، أى هو الله الكلمة المتجسد، ولا يمكن لفيلبس أن يرى لاهوت المسيح مجرّداً، لأن الله الابن قال لموسى عن مجد لاهوته: “الإنسان لا يرانى ويعيش” (خر33: 20). وقال القديس يوحنا الإنجيلى عن الآب: “الله لم يره أحد قط. الإله الوحيد الجنس الذى هو فى حضن الآب هو خبّر” (يو1: 18). أى أن لاهوت المسيح حينما اتحد بالناسوت، أعطانا الإمكانية أن نرى الله حينما تجسد الله الكلمة. فعبارة “الذى رآنى فقد رأى الآب” تؤكد عدم انفصال الناسوت عن اللاهوت فى المسيح الواحد.
ونفس الأمر ينطبق على أعمال السيد المسيح التى عملها، وكلامه الذى قال وهو فى الجسد فهذه كلها كان يعملها وينطق بها بناسوته المتحد باللاهوت. مثل لمسه بيده للأبرص الذى شفاه “فمدّ يده ولمسه.. وللوقت ذهب عنه البرص” (لو5: 13)، وعبارة “لعازر هلم خارجاً” (يو11: 43) التى نطق بها بفمه وأقام لعازر من الموت. وعن ذلك قال السيد المسيح: “الكلام الذى أكلمكم به لست أتكلم به من نفسى (أى منفصلاً عن الآب). لكن الآب الحال فىَّ هو يعمل الأعمال” (يو14: 10).
5) ” أنا عطشان ” (يو19: 28)
فى بداية الصلب لم يقبل السيد المسيح أن يشرب الخل كمخدر يخفف عنه الآلام.. ولكنه بعد ذلك وحينما شرب كأس الآلام إلى نهايتها، ولكى يتم الكتاب قال: “أنا عطشان” (يو19: 28) فأخذ واحد من الجند الواقفين إسفنجة وملأها خلاً وسقاه..
شرب السيد المسيح الخل الذى يرمز إلى خطية البشر المحزنة إذا قيس بحلاوة خمر محبته، أو بعذوبة مياه نعمته التى تروى النفس العطشانة.
عطش السيد المسيح إلى محبة البشر من أجل محبته لهم.. ومن أجل خيرهم وسعادتهم.. ولكنهم على الصليب سقوه خلاً يزيد الجوف عطشاً والتهاباً.. وقَبِلَ هو أن يشرب لكى يتم الكتاب “فى عطشى يسقوننى خلاً” (مز69: 21).
كان آخر ما قدمته له البشرية هو ذلك الخل -غالباً الممزوج بالمرارة- ليشرب فى عطشه.. بينما قدّم هو لها خمر محبته ومياه نعمته الغزيرة.
6) ” قد أُكمل ” ( يو19: 30)
“فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل” (يو19: 30) كلمة “قد أكمل” ليس معناها أن عمل المسيح الخلاصى قد انتهى بالنسبة لنا، ولكنها بمعنى قد أكمل العمل المطابق للنبوات المختصة بالآلام وبالصليب، لأنه بمجرد أن أسلم روحه على الصليب نزل إلى الجحيم كغالب وخرج غالباً ولكى يغلب وانتصر على جحافل الظلمة وأخرج المسبيين آدم وبنيه وأصعدهم معه إلى الفردوس. وصار يعمل لساعات طويلة جداً إلى أن قام من الأموات. كان أمامه عمل جبار هائل إلى جوار المرحلة الخطيرة، مرحلة تحطيم الجحيم وفتح الفردوس ثم القيامة من الأموات، وبهذا يكمل عمل الفداء على الأرض ثم يليه صعوده إلى السماوات ليشفع أمام الآب السماوى ولكى يحضر موعد الروح القدس.
فكلمة قد أكمل ليس معناها أن انتهى عمل المسيح الخلاصى ولكن معناها أن انتهى عمله فى التألم على الصليب إلى حد الموت، بمعنى أكمل عمل الآلام إلى حد الموت ولكن ليس أكمل العمل الخلاصى كله لأن عمل الخلاص لم ينته بالصليب بل امتد إلى ما بعد الصليب أيضاً.
7) ” يا أبتاه فى يديك أستودع روحى ” ( لو23: 46)
بعد ذلك صرخ السيد المسيح بصوتٍ عظيم قائلاً: “يا أبتاه فى يديك أستودع روحى” (لو23: 46)، لقد أعلن بداية عهد جديد للبشرية تذهب بها أرواح الناس بين يدى الآب وليس إلى الجحيم، تذهب إلى القديسين. والآب الذى أعطاها هو أعظم من الكل ولا يستطيع أحد أن يخطف من يده شئ. وكانت هذه هى صرخة الانتصار على إبليس. “ونكس رأسه وأسلم الروح” (يو19: 30) خرج السيد المسيح من الجسد ليس كمهزوم ولكن كمنتصر ذهب إلى الجحيم ودمّره، أخرج الذين فى السجن ونقلهم إلى الفردوس بروحه الإنسانية المتحدة باللاهوت.
وهذه الصرخة أيضاً أفزعت الشيطان وكل مملكته لأنه لأول مرة خرجت النفس الناسوتية ولم يستطع الشيطان أن يمسكها. لأنه منذ سقوط أبوينا الأولين، لم يستطع أحد أن يقولها عند موته. فكل من مات لم يستطع أن يستودع روحه فى يدىّ الآب، بل كان إبليس يقبض على تلك النفوس، ويحبسها فى الجحيم، حتى جاء السيد المسيح وأخرج أنفس الذين رقدوا على رجاء الخلاص.
لذلك قال معلمنا بطرس الرسول عن السيد المسيح: “مماتاً فى الجسد ولكن محييً فى الروح. الذى فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن” (1بط3: 18، 19).
لقد نزل السيد المسيح إلى الجحيم من قبل الصليب بروحه الإنسانى المتحد باللاهوت وقد سحق الجحيم ببرق لاهوته عندما انحدر إليه ليخلّص الذين انتظروا مجيئه وخلاصه العجيب.
من أراد أن يستزيد بتأملات غزيرة عن “كلمات السيد المسيح السبعة على الصليب”؛ فليرجع إلى كتاب قداسة البابا شنودة الثالث –أطال الرب حياة قداسته- بهذا الشأن.
مات ذبحاً
“واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء” (يو19: 34)، لما طعن الجندى السيد المسيح فى جنبه بالحربة بعد أن سلّم الروح، كان الدم يملأ القفص الصدرى: فسال أو تفجر الهيموجلوبين الأحمر بلون الدم أولاً، ثم البلازما الشفافة والسوائل الخاصة بالارتشاح المائى الرئوى (الأوديما) بعد ذلك. وذلك لأن الهيموجلوبين يترسب لثقله أما البلازما والمياه فتكون فى الجزء العلوى لأنها أخف فى كثافتها. وكان قد مر ساعتان ما بين الوفاة والطعن بالحربة. وهذا ما عبّر عنه القديس يوحنا الإنجيلى أنه من جرح طعنة الحربة “خرج دم وماء”.
اهتم القديس يوحنا أن يذكر واقعة خروج الدم والماء، لكى يؤكّد أن السيد المسيح مات ذبحاً. لذلك قال عن واقعة خروج الدم والماء من جنب المخلص “الذى عاين شهد وشهادته حق” (يو19: 35).
من المعتاد أن يموت المصلوب مخنوقاً إذ يصاب بالإعياء الشديد فلا يمكنه رفع جسده إلى أعلى لترتخى يداه ويمكنه الشهيق فى عملية التنفس. وبالنسبة للّصين اللذين صلبا مع السيد المسيح فقد لزم تكسير عظام سيقانهما ليتدليا ولا يمكنهما التنفس. وبهذا ماتا بالخنق. أما السيد المسيح فمات ذبحاً نظراً لغزارة الدم الذى سُفك خارجياً بإكليل الشوك والجلدات المريعة وثقوب المسامير فى يديه ورجليه وداخلياً بتمزيق شرايين القفص الصدرى حتى امتلأ التجويف الصدرى بالدم.
لهذا قال معلمنا بولس الرسول إن “فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبح لأجلنا” (1كو5: 7). ولكن العجيب أن السيد المسيح قد ذُبح من الداخل كما من الخارج أيضاً.
النزيف الحاد الذى تعرض له السيد المسيح، نتج عنه أن كمية الدم المتبقية فى الدورة الدموية صارت تتناقص فى الوقت الذى كان يقوم فيه بمجهود رهيب منذ بدء الجلد وفى طريق الجلجثة ثم وهو مصلوب.
احتاج القلب أن يعمل بسرعة لتعويض الدم المفقود ولبذل الجهد المطلوب. ولكى يعمل القلب بسرعة، يحتاج هو نفسه كعضلة لكمية أكبر من الدم تغذيه عن طريق الشرايين التاجية. ولم يعد بإمكانها أن تقوم بهذا الدور لقلة كمية الدم الواصل إليها بالنسبة لمعدل ضربات القلب بسبب النزيف وبسبب زيادة سرعة ضربات القلب. وإذا كانت سرعة ضربات القلب فى الإنسان الطبيعى هى سبعين نبضة فى الدقيقة، ففى حالات النزيف وزيادة المجهود ترتفع فوق 140 نبضة فى الدقيقة. وكل هذا يجهد عضلة القلب فتصل إلى مرحلة الهبوط الحاد جداً فى الجزء الأيمن منها ويؤدى ذلك إلى الوفاة.
عند هذا الحد استجمع السيد المسيح آخر ما تبقى من قدرة قلبه على العمل وصرخ بصوت عظيم “يا أبتاه فى يديك استودع روحى” (لو23: 46).
موضع الجمجمة
شرح الإنجيل كيف أتوا بالسيد المسيح “إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة” (مت27: 33). وموضع الجمجمة يقال له بالعبرانية “جلجثة” (انظر يو19: 17).
يقول التقليد إن جمجمة آدم كانت مدفونة تحت موضع صلب السيد المسيح مباشرة. وحينما تشققت الصخور سال دم السيد المسيح ووصل حتى جمجمة آدم، ليغسله من خطية العصيان الأولى بدمه الذكى.
وهذا يشرح سبب تسمية ذلك المكان موضع الجمجمة..
ولكن الاسم له دلالته الساطعة على أن السيد المسيح قد صُلب فى موضع الموت. وكثير من الناس يستخدمون صورة الجمجمة وعظمتين متعارضتين، للدلالة على الموت بأجلى معانيه.
لقد صلب السيد المسيح فى أرض الأموات، وتحقق فيه قول المزمور “حسبت مثل المنحدرين إلى الجب. صرتُ كرجل لا قوة له. بين الأموات فراشى، مثل القتلى المضطجعين فى القبر، الذين لا تذكرهم بعد، وهم من يدك انقطعوا” (مز88: 4، 5).
لم يكن مصادفة أن يُصلب السيد المسيح، وأن يموت فى موضع الجمجمة. لأنه جاء خصيصاً لينقل البشرية من الموت إلى الحياة “لأنه كما فى آدم يموت الجميع، هكذا فى المسيح سيحيا الجميع” (1كو15: 22). “ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح” (أف2: 5). ويخاطب معلمنا بولس الرسول أهل كولوسى بقوله: “إذ كنتم أمواتاً فى الخطايا وغلف جسدكم، أحياكم معه، مسامحاً لكم بجميع الخطايا” (كو2: 13).
الصليب وهو من خشب الشجر، كان كشجرة حياة غُرست فى أرض الموت. كقول إشعياء النبى: “نبت قدامه كفرخ، وكعرق من أرض يابسة” (إش53: 2).
لقد صُلب السيد المسيح فى وادى الموت.. خارجاً عن أورشليم.. فى منطقة المقابر التى لا يعيش فيها أحد من الأحياء.
” ومع غنى عند موته ” (إش53: 8، 9)
عن هذا تنبأ إشعياء النبى فقال: “وفى جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. أنه ضُرب من أجل ذنب شعبى. وجُعل مع الأشرار قبره، ومع غنى عند موته” (إش53: 8، 9).
وعبارة “جُعل مع الأشرار قبره، ومع غنى عند موته”، وإن كانت تشير إلى صلب السيد المسيح مع لصين مذنبين، وإعداد مقابر الأشرار لدفنه معهم، كما تشير إلى أنه لم يُدفن فى مقبرة الأشرار ولكن فى مقبرة يوسف الرامى الذى طلب جسد يسوع بعد موته على الصليب من بيلاطس الوالى؛ إلا أن هذه العبارة أيضاً تشير إلى أن السيد المسيح قد حُسب مع الخطاة، وهو يسير فى طريق الموت حاملاً خطايا العالم. لكنه لم يُحسب معهم حينما سلّم روحه الطاهرة فى يدّى الآب عند موته على الصليب (انظر لو23: 46)، لأنه كان باراً وبلا خطية وحده.
ولذلك فعبارة: “مع غنى عند موته” تشير إلى أن الابن الوحيد المتجسد قد سلّم روحه الطاهرة فى يدّى الآب الغنى، الذى منح الحياة للبشرية بعد أن صالح العالم لنفسه فى المسيح (انظر 2كو5: 19).
وأمكن بهذا أن يفتح باب الفردوس، ويذهب منتصراً إلى الجحيم قاهراً الشيطان، وأن يُخرج الذين فى بيت السجن، أى يُخرج آدم وبنيه الذين رقدوا على رجاء الخلاص، ويحضرهم معه إلى الفردوس.
أما أن الفردوس قد فُتح فى ذلك اليوم، فهو واضح من قول السيد المسيح للص اليمين: “الحق أقول لك إنك اليوم تكون معى فى الفردوس” (لو23: 43).
وعن ذهاب السيد المسيح بروحه الإنسانى المتحد باللاهوت إلى الجحيم، فواضح من قول الكتاب “أجعلك عهداً للشعب، ونوراً للأمم. لتفتح عيون العمى. لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين فى الظلمة” (إش42: 6، 7). وأيضاً قول معلمنا بطرس الرسول عن موت السيد المسيح على الصليب: “مماتاً فى الجسد، ولكن محيىً فى الروح. الذى فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن” (1بط3: 18، 19).
ولهذا نصلى فى القداس الإلهى }نزل إلى الجحيم من قِبَل الصليب{ (القداس الباسيلى).
وقد أشرق نور السيد المسيح على الجالسين فى ظلمة الجحيم كقول الكتاب “الشعب السالك فى الظلمة أبصر نوراً عظيماً. الجالسون فى أرض ظلال الموت، أشرق عليهم نور” (إش9: 2).
لقد أشرق السيد المسيح بنوره على السالكين فى ظلمة الخطية فى حياتهم، وقادهم إلى التوبة بنور معرفته، كما أشرق على الذين رقدوا على الرجاء وكانت أرواحهم سالكة فى ظلال الموت على مدى الأجيال، ثم نقلهم إلى أنوار الفردوس المتلألئة.
لهذا كتب معلمنا يوحنا الإنجيلى عن مجيء السيد المسيح فى الجسد: “كان النور الحقيقى الذى ينير كل إنسان آتياً إلى العالم” (يو1: 9).
من أجل الجالسين فى أرض ظلال الموت جميعاً، صُلب السيد المسيح فى موضع الجمجمة. لأن هناك يتحقق قصده المبارك فى مجيئه إلى العالم: أن يموت عوضاً عن الخطاة لينقلهم من الموت إلى الحياة..
آدم الثانى
كان آدم الأول هو رأس الجنس البشرى.. منه خرج جميع البشر، بما فى ذلك حواء نفسها. وذلك بقدرة الله وتدبيره.
البشر جميعاً كانوا فى صُلب أبينا آدم حينما خلقه الله على صورته ومثاله. وخلق له المرأة من جنبه بحيث لا تكون غريبة عن طبيعته البشرية.
وحينما “باركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض” (تك1: 28)، صار بإمكانهما أن ينجبا أولادًا من نفس طبيعتهما المشتركة.
ولأن كل نسل آدم كان فى صُلبه.. لهذا فحينما سقط آدم مع حواء – دخل الموت إلى الجنس البشرى كله.
وقد شرح معلمنا بولس الرسول هذا الأمر فقال: “بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس” (رو5: 12).
وقال أيضاً: “كما فى آدم يموت الجميع، هكذا فى المسيح سيُحيا الجميع” (1كو15: 22).
فكما قاد آدم الأول البشرية إلى الموت، هكذا قاد آدم الثانى أو آدم الجديد (المسيح) البشرية المفتداه إلى الحياة وميراث الملكوت الأبدى.
انتصر السيد المسيح على الموت بكل أبعاده وعوامله فى طبيعتنا البشرية التى أخذها بلا خطية – بفعل الروح القدس من العذراء القديسة مريم.
وكانت قيامة السيد المسيح هى النتيجة الطبيعية لنصرته -كرأس للكنيسة- على مملكة الظلمة الروحية.
وحقق السيد المسيح فى بشريته الكاملة، الشركة الحقيقية مع الله، بعيداً تماماً عن كل تأثير الشركة مع إبليس التى دخل إليها الإنسان بقبوله للغواية التى عرضتها عليه الحية القديمة.
كانت البشرية بالفعل فى احتياج إلى من يستطيع أن ينتشلها من الهوة ومن الفخ، الذى دخلت إليه بانقياد آدم الأول للغواية، ودخوله هو ونسله من بعده تحت سلطان الموت..
وقد أوضح القديس أثناسيوس أن الوحيد الذى كان باستطاعته أن يحرر الإنسان من الموت ويعيده إلى الصورة التى خلق عليها، هو كلمة الله..
فكما خلق الله الإنسان بكلمته على صورته ومثاله، هكذا لم يكن ممكناً أن يعاد خلق الإنسان مرة أخرى، إلا بواسطة نفس أقنوم الكلمة.
وتأكيداً لهذا المعنى قال معلمنا بولس الرسول: “إن كان أحد فى المسيح، فهو خليقة جديدة” (2كو5: 17).
عودة الشركة مع الله
لم يكن ممكناً أن تعود حياة الشركة بين الله والإنسان، إلا فى شخص ربنا يسوع المسيح “كلمة الله المتجسد”.
كذلك لم يكن ممكناً أن تمتد هذه الشركة لتشمل البشر الذين آمنوا به، إن لم يقم السيد المسيح بتقديم كفارة كاملة وكافية عن خطاياهم..
“أى إن الله كان فى المسيح مصالحاً العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم” (2كو5: 19) بتقديم ذبيحة الصليب عوضاً عن هلاك البشر بالموت الذى تملك على الجميع.
فبالتجسد وظهور آدم الجديد الذى بلا خطية عادت الشركة بين الله والإنسان فى شخصه.
وبالصليب صارت المصالحة بين الله والبشر الذين يقبلون الابن المتجسد مخلِّصاً لهم.
وبالقيامة نالت البشرية الحياة الجديدة، فى المسيح يسوع كباكورة للراقدين.
وبالصعود “دخل.. إلى الأقداس فوجد فداءً أبدياً” (عب9: 12)، حيث يمارس عمله كرئيس كهنة يشفع بدمه كل حين من أجل غفران الخطايا.
وبحلول الروح القدس وصلت استحقاقات المصالحة إلى الذين قبلوا المسيح، ونالوا سر العماد المقدس، وصاروا هيكلاً يسكن الله فيه.
وبهذا كله نستطيع أن نرى كيف عادت الشركة مع الله للذين قبلوا السيد المسيح ونالوا العطية الموعود بها من الآب.
لماذا تجسّد من العذراء
لم يتجسد الكلمة من زرع بشر، أى من مشيئة جسد أو من مشيئة رجل، فلو حدث ذلك لكان انتقال الخطية الجدية إلى المولود هو نتيجة طبيعية.
ولهذا فقد تجسد الكلمة بفعل الروح القدس فى أحشاء العذراء مريم، كما قال الملاك: “الذى حبل به فيها هو من الروح القدس” (مت1: 20).
ولم يكن ممكناً أن يتجسد الله الكلمة، دون أن يأخذ طبيعة بشرية حقيقية من أصل الجنس البشرى نفسه. لأنه لو تجسد بطبيعة أخرى مخلوقة خصيصاً لهذا الأمر، لما أمكن أن يخلص البشر، ولما أمكن أن يموت بمحبته عوضاً عنهم، ليوفى العدل الإلهى حقه.
لهذا فقد أخذ بشريته الكاملة جسداً وروحاً من العذراء مريم، بلا خطية، ووحّد هذه الطبيعة البشرية بألوهيته منذ اللحظة الأولى للتجسد.
الموت النيابى
وقد شرح القديس أثناسيوس فكرة تجسد الابن الوحيد وموته النيابى عن البشر فى الفصل التاسع من كتاب تجسد الكلمة فقال: [إن الكلمة إذ لم يكن قادراً أن يموت (بحسب ألوهيته)، أخذ جسداً قابلاً للموت. لكى باتحاده (أى باتحاد هذا الجسد) بالكلمة الذى هو فوق الكل، يصير جديراً بأن يموت نيابة عن الكل].
صارت الذبيحة التى قُدمت على الصليب ذات قيمة غير محدودة، لسبب اتحاد إنسانية المسيح بألوهيته اتحاداً طبيعياً يفوق العقل والإدراك.
فالذى صُلب على الصليب هو هو نفسه الله الكلمة الذى أخذ جسداً، وتألم بالجسد، وذاق الموت بالجسد لأجل خلاصنا.
لماذا كانت ظُلمة؟
“من الساعة السادسة كانت ظُلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة” (مت27: 45).
وقبلها كان السيد المسيح قد قال لليهود ساعة القبض عليه: “هذه ساعتكم وسلطان الظلمة” (لو22: 53).
إن النور يشير إلى الله وملكوته وحياة القداسة والبر.. أما الظلمة فتشير إلى الشيطان وحياة الشر والفساد.
لذلك قال السيد المسيح: “سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيّراً، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مُظلماً فإن كان النور الذى فيك ظلاماً، فالظلام كم يكون؟” (مت6: 22، 23).
وقيل عن الله “الذى وحده له عدم الموت، ساكناً فى نور لا يُدنى منه” (1تى6: 16).
وقال السيد المسيح عن مصير العبد البطّال فى استبعاده من ملكوت الله: “والعبد البطّال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان” (مت25: 30).
وقيل عن الملائكة الذين سقطوا أنهم فى الظلام “والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم، بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام” (يه6). وأيضاً “فى سلاسل الظلام طرحهم فى جهنم، وسلّمهم محروسين للقضاء” (2بط2: 4).
وعن الناس الأشرار قيل إنهم مثل “نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد” (يه13).
وعن الإيمان بالمسيح قال معلمنا بطرس الرسول للمؤمنين: “لكى تخبروا بفضائل الذى دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب” (1بط2: 9). وقال عن الثبات فى المسيح “وعندنا الكلمة النبوية، وهى أثبت، التى تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير فى موضع مُظلم، إلى أن ينفجر النهار، ويطلع كوكب الصبح فى قلوبكم” (2بط1: 19).
وعن الله والحياة معه قال معلمنا يوحنا الرسول: “إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا فى الظلمة، نكذب ولسنا نعمل الحق. ولكن إن سلكنا فى النور كما هو فى النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض” (1يو1: 5-7).
أبناء الظلمة وأبناء النور
قال السيد المسيح لبولس الرسول عن إرساليته عندما دعاه فى الطريق إلى دمشق: “قم وقف على رجليك لأنى لهذا ظهرت لك، لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذاً إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كى يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بى غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين” (أع26: 16-18). كان اليهود والأمم فى ظلمة عدم الإيمان بالمسيح وتحت سلطان الشيطان.
لذلك فعند صلب السيد المسيح كانت ظلمة على كل الأرض لمدة ثلاث ساعات لأن خطايا البشر هى ظُلمة ملأت العالم كله. وقد أظلم عقل اليهود والرومان الذين قاموا بصلب السيد المسيح، وهو البار القدوس الذى بلا خطية وحده.
لقد وضع الآب كل خطايا البشرية على ابنه الوحيد المتجسد، وفيما هو “يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شئ” (رؤ19: 15) أعلنت الطبيعة أن المخلّص يجتاز فى ظلال الموت كنائب عن البشرية لكى يوفى الدين عن الخطاة. وحينما أوفى الدين أبرق بنور لاهوته فى ظلمات الجحيم لينقل الراقدين من الظلمة إلى النور، كما أن الشمس قد عادت لتنير على العالم. وعن ذلك تنبأ إشعياء النبى: “الشعب السالك فى الظلمة أبصر نوراً عظيماً، الجالسون فى أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور” (إش9: 2).
المعمودية استنارة
قال عنها معلمنا بولس الرسول: “الذين استنيروا مرة، وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس، وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتى” (عب6: 4، 5).
وقال السيد المسيح عنها لنيقوديموس: “الحق الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله” (يو3: 3، 5). إن المعمودية تخلق فى الإنسان عينين روحيتين يمكن بهما أن يعاين مجد الله فى ملكوته الأبدى.
عن ذلك قال معلمنا بولس الرسول: “مستنيرة عيون أذهانكم، لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه فى القديسين” (أف1: 18). وقال “وأنير الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فى الله خالق الجميع بيسوع المسيح” (أف3: 9).
فوق الصليب
فوق الصليب كان الذبيح معلقاً رافعاً ذراعيه نحو السماء. لأنه هو الكاهن الأعظم، وقد صعد إلى المذبح ليصلى، وهو يقدِّم ذبيحة نفسه المقبولة أمام الله الآب عن حياة العالم. كان هو الكاهن والذبيحة فى آنٍ واحد.
كان قائماً وهو مذبوح كما رآه يوحنا فى سفر الرؤيا فى وسط العرش (انظر رؤ5: 6).
لم يُذبح السيد المسيح ويُلقى على الأرض، بل كان معلقاً بين الأرض والسماء.. لأنه هو الطريق المؤدّى إلى الآب .. إلى الحياة الأبدية. وهو الشفيع بين الله والناس، بين السماء والأرض.
كل من ينظر إليه بإيمان يستطيع أن يعرف الطريق المؤدى إلى ملكوت الله.
فوق الصليب فتح السيد المسيح كِلتا ذراعيه لكى يُعلن دعوته للأمم كما لليهود، لكى يأتوا إلى أحضان الله ويتمتعوا بالخلاص والراحة الأبدية. ولهذا كان عنوان علته مكتوباً فوق رأسه بأحرف يونانية ولاتينية (رومانية) وعبرية. فالخلاص هو لجميع الشعوب. وقد اشترك الرومان مع اليهود فى صلب السيد المسيح، لأنه مات لسبب خطايا الأمم وخطايا اليهود معاً، ليحرر البشر جميعاً من سلطان الخطية كل من يؤمن ويتوب ويعتمد.
فوق الصليب حمل السيد المسيح لعنة الخطية، لأنه مكتوب “المعلّق ملعون من الله” (تث21: 23)، وبهذا “جعل الذى لم يعرف خطية، خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه” (2كو5 :21).
واحتمل السيد المسيح كل تعييرات الشيطان على فم المعيرين لأنه مكتوب “تعييرات معيّريك وقعت علىَّ” (مز69: 9).
ولكن القيامة من الأموات محت كل آثار التعيير، كما أنها أثبتت أن اللعنة قد مُحيت وزالت لأن الكفارة قد قُبِلت، واستوفى العدل الإلهى حقه بالكامل.
لهذا رأى يوحنا الإنجيلى السيد المسيح بثوب مغموس بالدم، وهو بالعدل يحكم ويحارب، ويُدعى اسمه كلمة الله “وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شئ” (رؤ19: 15).
وسبق أن قال السيد المسيح بفم نبيه إشعياء: “قد دست المعصرة وحدى ومن الشعوب لم يكن معى أحد” (إش63 : 3).
فوق الصليب صعد السيد المسيح إلى عرشه المجيد.. ولهذا تتغنى له الكنيسة بألحان المزمور فى يوم الجمعة العظيمة “كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك” (مز44: 6). وهكذا نرى كيف أن الرب قد ملك على خشبة.
اختفى الشيطان فى الحية القديمة وخدع البشرية لتعصى الوصية المقدسة، وتأكل من شجرة معرفة الخير والشر، إذ نظرت الثمرة شهية للنظر وجيدة للأكل.
وهكذا أخفى السيد المسيح لاهوته عن الشيطان، وإذ وُجد فى الهيئة كإنسان وضع ذاته وأطاع الآب حتى الموت، وكان معلقاً على الشجرة. ورأى الشيطان أن الثمرة المعلقة على الشجرة هى شهية للنظر وجيدة للأكل.. فتجاسر الموت أن يلتهم الحياة.. وبهذا ابتلع ما هو ضده وما هو أقوى منه، فانهزم الموت وأبتُلع الموت من الحياة مثلما تبتلع الظلمة نوراً فإن النور هو الذى يبتلع الظلمة ويبددها. ولم يستطع الجحيم أن يبتلع من له الحياة الإلهية القاهرة للموت.. بل إن الجحيم نفسه قد تحطمت متاريسه بقوة المصلوب..
لهذا كتب القديس يوحنا ذهبى الفم (عندما انحدرت إلى الموت، أيها الحياة الذى لا يموت: حينئذ أمتّ الجحيم ببرق لاهوتك. وعندما أقمت الأموات من تحت الثرى، صرخ نحوك جميع القوات السمائيين: أيها المسيح الإله معطى الحياة المجد لك)
اضطراب الطبيعة لصلب خالقها
كانت دقات المسامير فى يدىّ وقدمىّ السيد المسيح مثل معاول تهدم فى مملكة إبليس.. لأن اليد التى سُمرّت هى تلك اليد المتحدة باللاهوت.. هى يد الله التى قدّمت الخير، كل الخير للخليقة، وهى اليد التى جبلت آدم وحواء كقول المزمور “يداك صنعتانى وجبلتانى” (مز118: 73).
كانت طرقات المطرقة تدوى فوق الجلجثة أثناء تسمير السيد المسيح فوق الصليب، وكانت أيضاً معاول هدم حصون إبليس تدوى فى أسماع الملائكة الذين وقفوا مبهورين من محبة الله الباذلة إلى المنتهى.
لقد ارتبكت الخليقة، واضطربت الأرض، وكأنها قد اقشعرت من القساوة التى عومل بها الله الكلمة المتجسد. ولهذا فقد تزلزلت الأرض والجبال وتشققت الصخور لأن دقات المسامير أفزعتها. وغضبت الطبيعة مما فعله الخطاة بخالق الطبيعة ومبدعها.
وحينما تعرّى الابن الوحيد من ثيابه: أخفت الشمس أشعتها وكأنها تشعر بالخجل من تعرية خالقها الذى ألبس المسكونة جمالاً وبهاءً، حتى زنابق الحقل ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها.
لقد سمح الرب للخليقة غير العاقلة أن تبدو فى اضطراب ليبكّت قساوة الإنسان. فالصخور بدت وكأنها كانت أكثر إحساساً وشعوراً من تلك القلوب القاسية التى صارت أقسى من الصخر لسبب الخطايا والشرور التى أعمت بصيرتها.
وهكذا أرعدت الطبيعة لكى يستفيق قلب الإنسان ويدرك مقدار من هو ذبيح فوق الصليب.. إنه الله الكلمة نفسه الذى تجسد وافتدانا من اللعنة والموت. فما أعجب محبتك غير الموصوفة يا ربنا القدوس؟!!..
لماذا اختار الرب الصليب؟
الصليب له جاذبية خاصة فى الحديث عنه. فقد اختار السيد المسيح أن يعمل فى النجارة لارتباط هذا الأمر بالصليب. وهو مصنوع من خشب الشجر لكى يوضّح الرب أن إبليس إذ استخدم الشجرة لخداع البشرية وسقوط الإنسان فى الفردوس، فإنه هو أيضاً قد استخدم الشجرة لخلاص البشرية ورجوع الإنسان إلى الفردوس، فكل أنواع الخليقة ينبغى أن تستخدم لتمجيد الله. وعلى الشجرة قال للص اليمين: “اليوم تكون معى فى الفردوس”.
لقد اختار السيد المسيح مهنة النجارة فى حياته قبل الصليب.. وهكذا صنع ابن النجار صليباً من خشب الشجر ليخلِّص به العالم. كما قال القديس مار آفرام السريانى {مبارك هو ذلك النجار الذى صنع بصليبه قنطرة لعبور المفديين} ويقصد بذلك أن الصليب قد صار واسطة عبورنا من الهلاك إلى الحياة الأبدية، وعبور الذين رقدوا على الرجاء من الجحيم إلى الفردوس.
يتساءل البعض: لماذا دبر الرب فى خطة الخلاص أن يتم الفداء بذبيحة الصليب، وليس بموت السيد المسيح بطريقة أخرى؟
ونجيب على ذلك بأن هناك أسباباً كثيرة يصعب حصرها ونذكر منها على سبيل المثال:
أولاً: لكى يكون هو الطريق المؤدى إلى السماء
فتعليق السيد المسيح على الصليب ما بين السماء والأرض يذكرنا بسلم يعقوب الذى رآه منصوباً على الأرض ورأسه يمس السماء والرب واقف عليه والملائكة صاعدة ونازلة عليه. وقد قال الرب عن نفسه “أنا هو الطريق والحق والحياة” (يو14: 6).
ثانياً: لكى يكون هو الكاهن وهو الذبيحة فى آنٍ واحد
لأن السيد المسيح كان فاتحاً ذراعيه على الصليب رافعاً إياهما إلى أعلى. وفى نفس الوقت كان مجروحاً ينزف دمه كذبيحة مقبولة عن خلاص جنسنا. وكما قال أحدهم [هو الكاهن الأعظم صعد إلى المذبح ليصلى، وفيما هو يقدّم نفسه ذبيحة؛ دافع عن البشرية الخاطئة (أى تشفع من أجل الخطاة لينالوا الغفران بالتوبة والمعمودية المقدسة)].
ثالثاُ: لكى يكون حملاً مذبوحاً قائماً
رآه يوحنا فى سفر الرؤيا فى وسط العرش حملاً قائماً كأنه مذبوح ولا يمكن أن تكون الذبيحة واقفة وليست منطرحة على الأرض إلا فى وضع الصليب.
رابعاً: كان ينبغى أن يموت مذبوحاً
لأنه “بدون سفك دم لا تحصل مغفرة” (عب9: 22) فلو مات السيد المسيح مخنوقاً أو غريقاً أو بالحرق بالنار لما أمكن أن يقال عنه “لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا” (1كو5: 7).
والسيد المسيح لم تكسر ساقيه على الصليب مثل اللصين اللذين اختنقا عندما تدليا من ذراعيهما. بل سلّم السيد المسيح الروح نتيجة النزيف الحاد من الجراحات الخارجية كالمسامير وإكليل الشوك والجلد، والجراحات الداخلية التى نشأت عن جَلد القفص الصدرى بأعصاب البقر المدلاة فى أطرافها قطع من المعدن أو العظام التى تمزق الشرايين المحيطة بالقفص الصدرى داخلياً تحت الجلد بجوار الضلوع عندما يلتف الكرباج حول الصدر أثناء الجلد على الظهر.
لذلك حينما طعن الجندى السيد المسيح بعد ذلك بالحربة فى جنبه كان صدره ممتلئاً من الدماء والماء. الدم أولاً حيث يترسب الهيموجلوبين، والماء بعد ذلك حيث البلازما، والمياه الناشئة عن الارتشاح (الأوديما).
خامساً: الصليب هو العرش
قال المزمور “الرب قد ملك على خشبة” (مز95: 10) والخشبة هى خشبة الصليب. ويقول المزمور أيضاً “كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك” (مز44: 6) إن قضيب ملكه هو أيضاً خشبة الصليب. والسيد المسيح قد قال: “متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أنى أنا هو” (يو8: 28)، وقال أيضاً: “أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلىّ الجميع” (يو12: 32).
الصليب له أربعة أذرع مثل العرش الإلهى الذى تحيط به الأحياء الأربعة غير المتجسدين؛ شبه الإنسان ويرمز إلى التجسد، وشبه العجل ويرمز إلى الذبيحة (الصلب)، وشبه الأسد ويرمز إلى القيامة، وشبه النسر ويرمز إلى الصعود. كما أنها ترمز إلى الأناجيل الأربعة: متى ولوقا ومرقس ويوحنا بنفس الترتيب المذكور عن الأحياء غير المتجسدين.
فى الصليب نرى بوضوح الذبيحة ولكننا نرى بعين التأمل التجسد والقيامة والصعود. فالمصلوب هو الرب المتجسد، وهو الرب المذبوح، وهو الرب القائم (لأنه مذبوح وقائم على الصليب)، وهو الرب الصاعد (لأنه معلق بين السماء والأرض).
القيامة والصعود لم يكونا قد حدثا بعد ولكننا نراهما فى الصليب بعين التأمل، كما أننا نؤمن بقلوبنا أن المصلوب قد قام وصعد إلى أعلى السماوات.
إن الصليب ذا الأذرع الأربع يشير إلى الخلاص الذى امتد من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب. لذلك نقول فى صلاة الساعة السادسة {صنعت خلاصاً فى وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب}.
إن الصليب هو ينبوع للتأمل، وعليه حمل الرب لعنة خطايانا ومحاها بالصليب إذ أوفى الدين الذى علينا وقدّم نفسه عوضاً عن الجميع.
فما أجمل أن نضع الصليب أمام أعيننا على الدوام لأنه يذكرنا بحب الله الآب الذى بذل ابنه الوحيد لأجل خلاصنا.
الذبيحة المقبولة
قدّم السيد المسيح نفسه على الصليب ذبيحة مقبولة لله أبيه، نسيم رائحة طيبة “لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عِجلَةٍ مرشوشٌ على المنجسين يقدّس إلى طهارة الجسد. فكم بالحرى يكون دم المسيح الذى بروح أزلى قدّم نفسه لله بلا عيب يطهّر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحى” (عب9: 13، 14).
عن هذه الذبيحة المقبولة قال السيد المسيح لنيقوديموس قبل صلبه بمدة طويلة: “لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد الجنس لكى لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية” (يو3: 16).
وقال السيد المسيح أيضاً عن نفسه مشيراً إلى رسالته الخلاصية التى سوف يبذل فيها نفسه عن شعبه: “أنا هو الراعى الصالح. والراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف.. لهذا يحبنى الآب لأنى أضع نفسى لآخذها أيضاً. ليس أحد يأخذها منى، بل أضعها أنا من ذاتى. لى سلطان أن أضعها، ولى سلطان أن آخذها أيضاً. هذه الوصية قبلتها من أبى” (يو10: 11، 17، 18).
والشئ العجيب أن إيلين هوايت نبية السبتيين الأدفنتست المزعومة تدّعى أن السيد المسيح لم يكن واثقاً من قبول الآب لذبيحته على الصليب، وحتى بعد القيامة، وعند صعوده ودخوله إلى السماوات.
ففى كتابها المشهور بعنوان “مشتهى الأجيال” وعلى صفحة 714، صفحة 715 فى الطبعة الثالثة للترجمة العربية والتى طبعت فى مصر، فى الفصل الثامن والسبعين بعنوان “موت على قمة جبل” عن صلب السيد المسيح، كتبت تقول [اعتصر الشيطان بتجاربه القاسية قلب يسوع. ولم يستطع المخلّص أن يخترق ببصره أبواب القبر. ولم يصوّر له الرجاء أنه سيخرج من القبر ظافراً، ولا أخبره عن قبول الآب لذبيحته. وكان يخشى أن تكون الخطية كريهة جداً فى نظر الله بحيث يكون انفصال أحدهما عن الآخر أبدياً.. ذُهل الملائكة وهم يرون عذابات المخلص ويأسه. وحجب الأجناد السماويون وجوههم حتى لا يروا ذلك المنظر المخيف].
وفى حديثها عن قيامة السيد المسيح صفحة 748 [رفض يسوع قبول الولاء من أتباعه حتى أيقن أن الآب قد قبل ذبيحته]. وفى حديثها عن صعود السيد المسيح واشتياق الملائكة للاحتفاء بنصرته وتمجيد مليكهم صفحة 788 [غير أنه يشير عليهم بالتنحى جانباً. لم يأت الوقت بعد. إنه لا يستطيع أن يلبس إكليل المجد أو ثوب الملك].
إن القديس بولس الرسول يتحدث عن وعد الله بإتمام الفداء بأنه أمر لا يمكن تغييره. وأن الرب قد أقسم بنفسه. وأن الله لا يكذب. وأن الرجاء هو كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة. كتب إلى العبرانيين يقول: “فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه.. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيراً لورثة الموعد عدم تغيّر قضائه توسَّط بقسم. حتى بأمرين عديمى التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا؛ الذى هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائراً على رتبة ملكى صادق رئيس كهنة إلى الأبد” (عب6: 13، 17-20).
كيف تدّعى إيلين هوايت أن الرجاء لم يخبر يسوع عن قبول الآب لذبيحته وهو معلق على الصليب؟!!..
إذا كان الله قد أقسم بنفسه على إتمام الفداء فكيف يقال أن السيد المسيح لم يكن واثقاً من هذا الأمر؟!!..
وإذا كان الرجاء هو مرساة للنفس للمؤمن العادى فكيف يقال أن رب المجد يسوع المسيح لم يخبره الرجاء عن قبول الآب لذبيحته؟!!..
إن الهدف الواضح من وراء هذه العبارات البشعة هو تحطيم صورة السيد المسيح باعتبار أنه هو “الله الظاهر فى الجسد”، وأنه هو “رجاء الأمم”.
ويستطرد معلمنا بولس الرسول مؤكداً ارتباط الرجاء بالقَسَم الإلهى فيقول: “فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. إذ الناموس لم يكمل شيئاً. ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم. لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامناً لعهدٍ أفضل” (عب7: 18-22).
هيّأت لى جسداً
إن النبوات التى ذكرت فى ناموس موسى والأنبياء والمزامير، كانت تحمل كثير من البراهين على قبول الآب لذبيحة ابنه الوحيد. بل تكلم المزمور (مز 39) (حسب الترجمة القبطية) على لسان السيد المسيح مؤكداً أن هذا هو مكتوب عنه فى نفس نص النبوة وليس عند أو بعد إتمامها. فعبارة “مكتوب عنى” وردت فى المزمور نفسه. وقد اقتبس القديس بولس الرسول نص المزمور من الترجمة السبعينية فقال عن السيد المسيح: “لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقرباناً لم ترد ولكن هيّأت لى جسداً. بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت هأنذا أجيء فى درج الكتاب مكتوب عنى لأفعل مشيئتك يا الله.. ينزع الأول لكى يثبت الثانى. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة” (عب10: 5-7، 9، 10).
فإذا كان السيد المسيح قد أنبأ فى المزمور أنه بذبيحة جسده سوف يبطل الذبائح الحيوانية التى للعهد القديم لأن الآب لم يسر بهذه الذبائح، بل هيأ له جسداً، فكيف يقال أنه لم يكن واثقاً من قبول الآب لذبيحته؟!!..
ألم يقل إشعياء النبى “كشاة تساق إلى الذبح.. جعل نفسه ذبيحة إثم.. ومسرة الرب بيده تنجح.. من أجل أنه سكب للموت نفسه” (إش53: 7، 10، 12).
العهد الجديد
قال معلمنا بولس الرسول فى رسالته إلى العبرانيين عن السيد المسيح: “ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضاً لعهد أعظم قد تثبّت على مواعيد أفضل” (عب8: 6).
والمقصود بالعهد الأعظم هو العهد الجديد لهذا يقول: “فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثانٍ. لأنه يقول لهم لائماً: هوذا أيام تأتى يقول الرب حين أكمّل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً” (عب8: 7، 8).
إذن فقد ذكر الرب فى أسفار العهد القديم فى نبوة أرميا النبى (انظر أر31: 31) العهد الجديد الذى سوف يصنعه الرب مع شعبه ويختلف عن العهد القديم فى طبيعته وفى مداه ونتائجه.
العهد القديم قام على أساس الرمز فقط بالذبائح الحيوانية. أما العهد الجديد فقد تأسس على ذبيحة المسيح الفائقة القيمة.
العهد القديم تم بدم الذبائح الحيوانية أما العهد الجديد فهو بدم المسيح.
لذلك أكمل معلمنا بولس الرسول كلامه عن السيد المسيح كرئيس كهنة: “ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً أبدياً” (عب 9: 12).
ويشير أيضاً إلى أهمية الدم فى التطهير سواء فى العهد القديم على سبيل الرمز أو فى العهد الجديد على سبيل المرموز إليه والذى به يتم مفعول الرمز على أساس الوعد، فيقول “فمن ثم الأول أيضاً (أى العهد الأول) لم يكرس بلا دم. لأن موسى بعدما كلّم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس، أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفاً قرمزياً وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب. قائلاً هذا هو دم العهد الذى أوصاكم الله به. والمسكن أيضاً وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم. وكل شئ تقريباً يتطهّر حسب الناموس بالدم. وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة” (عب9: 18-22). فكيف رسم السيد المسيح العهد الجديد، وكيف أسسه وأعطاه لكنيسته المحبوبة؟
بالطبع لقد تأسس العهد الجديد على ذبيحة السيد المسيح التى قدّمها على صليب الجلجثة وعلى دمه الذى سفك على الصليب من أجل مغفرة خطايا الكثيرين.
وقد أوضح القديس بولس الرسول ذلك بقوله للعبرانيين: “لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدّس إلى طهارة الجسد. فكم بالحرى دم المسيح، الذى بروح أزلى قدّم نفسه لله بلا عيب يطهّر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحى” (عب9: 13، 14).
العشاء الربانى والقداس الإلهى
وقد ارتبط العشاء الربانى بذبيحة الصليب ارتباطاً وثيقاً، لأنه هو امتداد لذبيحة الصليب فى ليلة الآلام وما بعد قيامة الرب من الأموات. قال السيد المسيح لتلاميذه عن الكأس وقت تأسيس سر الشكر (الإفخارستيا): “هذه الكأس هى العهد الجديد بدمى الذى يسفك عنكم” (لو22: 20).
وهكذا نرى بوضوح ارتباط العهد الجديد بدم المسيح الذى سفك على الصليب. ولكننا ينبغى أن نلاحظ أيضاً كيف ربط السيد المسيح بين كأس الإفخارستيا (سر الشكر) وبين دمه والعهد الجديد إذ قال: “هذه الكأس هى العهد الجديد بدمى” (لو22: 20، 1كو11: 25). إذن فإن استمرارية العهد الجديد تتوقف على استمرارية كأس الإفخارستيا بدم المسيح الحقيقى فى الكنيسة. لأن السيد قال: “هذه الكأس هى العهد الجديد بدمى” ولم يقل فقط “العهد الجديد بدمى”.
فالكنيسة التى لا يوجد فيها دم المسيح الحقيقى الذى سفك على الصليب، لا يصح أن تدّعى أنها تحيا العهد الجديد وتتمتع بفاعليته ونتائجه. لهذا أمر السيد المسيح تلاميذه قائلاً: “اصنعوا هذا كلما شربتم لذكرى” (1كو11: 25). وهو أمر تكليف للآباء الرسل ولجميع كهنة العهد الجديد أن يصنعوا ويقيموا تذكار موت الرب وقيامته فى الإفخارستيا.
وقال معلمنا بولس الرسول: “فإنكم كلّما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء” (1كو11: 26).
إننا فى القداس الإلهى لا نتذكر فقط موت الرب المحيى على الصليب، بل نتذكر أيضاً قيامته المقدسة وصعوده إلى السماوات ومجيئه الثانى فى اليوم الأخير {نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثانى الآتى من السماوات المخوف المملوء مجداً} (القداس الباسيلى). لهذا قال “تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء “وعبارة “يجيء” تشير إلى من قام وصعد حياً وسوف يجيء فى مجده الذى هو أيضاً مجد أبيه.
كهنوت على رتبة ملكى صادق
إن الوعد الإلهى بالنبوة عن كهنوت السيد المسيح هو: “أقسم الرب ولن يندم؛ أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صادق” (عب7: 21). فكيف يكون كهنوته على رتبة ملكى صادق إلا إذا كانت ذبيحة الإفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب ومنها تستمد وجودها وفاعليتها. أى هى امتداد واستعلان سرائرى لذبيحة الصليب التى تم بها الفداء.
إن تقدمة ملكى صادق كانت خبزاً وخمراً وكما قال قداسة البابا شنودة الثالث-أطال الرب حياته- إن كهنوت السيد المسيح لا يمكن أن يكون على طقس وترتيب ملكى صادق إلا إذا كان مرتبطاً بتقدمة الخبز والخمر فى سر الإفخارستيا. وهو أيضاً رئيس كهنة لأن كهنة العهد الجديد يخدمون تقدمة الإفخارستيا فى سر القربان المقدس فى القداس الإلهى. وإلا كيف يكون هو رئيس كهنة بدون كهنة للعهد الجديد؟
هل يحتاج إلى ذبيحة عن نفسه؟!
أبرز القديس بولس الرسول الفرق الشاسع بين كهنوت السيد المسيح والكهنوت اللاوى أى كهنوت رؤساء كهنة اليهود من نسل هارون.
فمن جهة أوضح أن ذبائح العهد القديم الحيوانية لا تستطيع أن تخلّص الإنسان من الهلاك الأبدى. أما ذبيحة السيد المسيح الذى بروح أزلى قدّم نفسه لله بلا عيب فهى القادرة أن تكفّر عن خطايا البشر.
ومن جهة أخرى أوضح أن كهنوت السيد المسيح هو بقسم من الآب وإلى الأبد. أما الكهنوت الهارونى فهو بدون قسم وليس إلى الأبد.
كما أوضح أن رؤساء الكهنة من نسل هارون كانوا “كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء” (عب7: 23)، أما السيد المسيح باعتباره رئيس الكهنة الأعظم فهو حى إلى الأبد ولا يحتاج إلى بديل ليحل محله.
وأوضح أيضاً أن رؤساء كهنة العهد القديم كانوا يقدّمون ذبائح أولاً عن أنفسهم ثم عن خطايا الشعب، أما السيد المسيح فلم يقدّم ذبيحة أولاً عن نفسه ثم ذبائح عن خطايا الشعب، بل قدّم نفسه مرة واحدة ليغفر خطايا شعبه. لأنه هو نفسه لم يكن محتاجاً إلى ذبيحة عن نفسه. ولذلك كتب القديس بولس الرسول يقول فى رسالته إلى العبرانيين عن السيد المسيح: “الذى ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولاً عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة، إذ قدّم نفسه” (عب7: 27). واستطرد قائلاً: “فإن الناموس يقيم أناساً بهم ضعف رؤساء كهنة. وأما كلمة القسم التى بعد الناموس فتقيم ابناً مكملاً إلى الأبد” (عب7: 28).
إذن لم يكن السيد المسيح محتاجاً أن يقدم ذبيحة عن نفسه لأنه هو “قدوس القدوسين” (دا 9: 24) الذى بلا خطية وحده. فهو بالطبع لم يرث خطية آدم، ولم يكن لديه أى ميل للخطية، ولم تكن إمكانية الخطية مفتوحة بالنسبة له على الإطلاق. بل بارك طبيعتنا فيه حينما أخذ ناسوتاً بشرياً من العذراء القديسة مريم بفعل الروح القدس وجعله واحداً مع لاهوته منذ اللحظة الأولى للتجسد الإلهى. وقال لها الملاك: “الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك، فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله” (لو1: 35).
لقد شابهنا السيد المسيح فى كل شئ ما خلا الخطية وحدها. وكانت طاعته الكاملة للآب فى الجانب الإيجابى أى فى أنه حمل خطايا غيره ودفع ثمن عقوبتها وهو برئ “لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين” (عب2: 18). لهذا قال معلمنا بولس الرسول: “فإن الناموس يقيم أُناساً بهم ضعف رؤساء كهنة. وأما كلمة القسم التى بعد الناموس فتُقيم ابناً مكملاً إلى الأبد” (عب7: 28).
أى أن رؤساء كهنة العهد القديم فى الكهنوت الهارونى كان بهم ضعف بسبب وراثتهم الخطية الأصلية من أبوينا الأولين آدم وحواء. ولذلك كان على رئيس الكهنة الهارونى “أن يقدّم ذبائح أولاً عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب” (عب7: 27). أما السيد المسيح فلأنه كان خالياً تماماً من ضعفات الخطية فلم يقدم ذبائح عن نفسه أولاً ثم عن خطايا الشعب، بل قدّم نفسه ذبيحة واحدة كاملة عن خطايا الشعب تكفى للتكفير عن خطايا العالم كله لكل من يؤمن وينال العماد المقدس. لهذا قال عن السيد المسيح: “لأنه فعل هذا مرة واحدة. إذ قدّم نفسه” (عب7: 27).
إن هذه المنظومة الجميلة المتناظرة التى قدّمها بولس الرسول صارت كما يلى:
المسيح ليس فيه ضعف وقدّم نفسه مرة واحدة، أما رؤساء كهنة اليهود فبهم ضعف فيقدمون ذبائح عديدة.
المسيح “حى” (عب7: 25) لذلك فهو رئيس الكهنة الأعظم الدائم إلى الأبد، أما رؤساء كهنة اليهود “قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء” (عب7: 23).
المسيح أخذ كهنوته بقسم على رتبة ملكى صادق، أما رؤساء كهنة اليهود فبدون قسم على رتبة هارون.
المسيح قدّم ذبيحة كاملة “بروح أزلى قدّم نفسه لله بلا عيب” (عب9: 14)، أما رؤساء كهنة اليهود فكانوا يقدمون قرابين وذبائح حيوانية “لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذى يخدم” (عب9:9).
المسيح دخل إلى الأقداس السماوية، أما رؤساء كهنة اليهود فكانوا يخدمون شبه السماويات فى الخيمة أو فى هيكل سليمان.
لهذا قال: “فلو كان بالكهنوت اللاوى كمال -إذ الشعب أخذ الناموس عليه- ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكى صادق، ولا يقال على رتبة هارون” (عب7: 11). هذا هو كهنوت السيد المسيح، كهنوت العهد الجديد الذى يخدم ذبيحة الإفخارستيا بالخبز والخمر على طقس ملكى صادق؛ الذى قدّم خبزاً وخمراً فى زمانه كما قدّم السيد المسيح جسده ودمه لتلاميذه فى ليلة آلامه وقال لهم: “هذا هو جسدى.. هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى يسفك من أجل كثيرين” (مر14: 22، 24)، “اصنعوا هذا لذكرى” (1كو11: 24، لو22: 19). وبهذا الكهنوت فى سر القربان المقدس يكون السيد المسيح هو رئيس الكهنة الأعظم، أما الكهنة فى رتبهم المتنوعة فهم خدام سر الإفخارستيا. وعموماً هم وكلاء أسرار الله. فالسيد المسيح هو رأس الكنيسة الجامعة، أما الآباء البطاركة فهم رؤساء الكنائس المحلية حسب كراسيهم الرسولية.
شمس البر الشافية
قال السيد المسيح: “أنا قد جئت نوراً إلى العالم حتى كل من يؤمن بى لا يمكث فى الظلمة” (يو12: 46) وقال أيضاً: “أنا هو نور العالم. من يتبعنى فلا يمشى فى الظلمة بل يكون له نور الحياة” (يو8: 12). استطاع السيد المسيح أن يغيِّر حياة الكثيرين ويجعلهم يتركون حياة الشر والخطية ويحوّلهم إلى قديسين. وهكذا تغيّرت صورة البشرية من صورة مهلهلة وممزقة وضائعة يسيطر عليها الموت، إلى صورة تنهض لكى تسترد كرامتها مرة أخرى. فيقول الكتاب “أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله” (يو1: 12). مثلما قال إشعياء لأورشليم: “قومى استنيرى لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليكِ” (إش60: 1). وقال ملاخى النبى: “ولكم أيها المتقون اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتها” (مل4: 2). ما هى الشمس التى لها أجنحة شافية؟!.
شمس البر والشفاء فى أجنحتها
ربنا يسوع المسيح الذى كان معلقاً على الصليب وذراعاه ممدودتان كان هو شمس البر المجنحة لليمين ولليسار وهو ينادى قائلاً: “تعالوا إلىَّ يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريحكم” (مت11: 28). فقد كان -على الصليب- يمثل أحضان الله المفتوحة، كما يمثل النور الذى أشرق على عالم مظلم سيطرت عليه الخطية فجاء هو نوراً للعالم وأضاء للخطاة لكى يتوبوا ويبدأوا حياة جديدة مع الله.
التحرر من سيطرة الشيطان
كثير من الخطاة الذين كانت عليهم أرواح شريرة تحرروا من سلطان الشيطان على يدى السيد المسيح. فقد أخرج من مريم المجدلية مثلاً سبعة شياطين.. والمجنون الأعمى والأخرس أخرج منه ستة آلاف شيطان. لأن الشيطان قال: “اسمى لجئون لأننا كثيرون” (مر5: 9). ولجئون معناها كتيبة قوامها ستة آلاف جندى. ولذلك لما خرج هذا اللجئون من الإنسان ودخل فى قطيع الخنازير الضخم، اندفع القطيع من الجرف إلى البحر. وكان نحو ألفين. فاختنق ومات (انظر مر5: 12، 13).
كان هذا لكى نعرف كيف كان للشيطان سلطان على الإنسان المسكين، ذلك الذى جاء السيد المسيح ليحرره. “وكانت شياطين أيضاً تخرج من كثيرين وهى تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله” (لو4: 41) وكانت تصرخ أيضاً قائلة: “مالنا ولك يا يسوع ابن الله. أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا” (مت8: 29). فكانت جحافل الظلمة تهرب من أمام وجهه. ولهذا قال لهم: “إن كنت لست أعمل أعمال أبى فلا تؤمنوا بى” (يو10: 37).
نور أشرق
هو نور، وقد أشرق فعلاً فلا يستطيع أى شيطان أن يقف فى طريقه.. وكان هذا النور يزحف وفى زحفه تهرب الظلمة وتنهزم أمامه. ففى كل مكان كان يذهب إليه السيد المسيح كانت مملكة الشيطان تهتز. ولذلك قال اليهود: “ما هو هذا التعليم الجديد لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه” (مر1: 27).
بهتت الجموع من إخراج الشياطين لأنه لم يقدر أى نبى قبل السيد المسيح أن يخرج شيطاناً من إنسان. لهذا قال السيد المسيح لليهود: “إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله” (مت12: 28).
وقد تاب كثير من الخطاة على يدى السيد المسيح مثل: المرأة الخاطئة التى غسلت رجليه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها (انظر لو7: 36-50). وزكا العشار الظالم المحب للمال (انظر لو19: 1-10). ولاوى الذى كان جالساً عند مكان الجباية “فقال له اتبعنى” (مر2: 14) فقام وتبعه تاركاً كل شئ. والمرأة الزانية التى “أُمسكت وهى تزنى فى ذات الفعل.. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك اذهبى ولا تخطئى أيضاً” (يو8: 4، 11).
إن ما حدث كان عبارة عن حالة زحف عجيب جداً..!! حياة تسرى على وجه الكرة الأرضية مثل نور الصباح إذا أشرقت الشمس، أو مثل النار إذا اشتعلت فى حقل تبن فلا يستطيع أحد أن يطفئها. ولذلك شعر الشيطان إن مملكته أصبحت فى خطر.. فلم يكن أمامه إلا حل واحد فقط وهو أن يتآمر على قتل السيد المسيح.
الحل الوحيد
لم يستطع الشيطان أن يقف صامتاً وهو يرى حصونه المنيعة تدك الواحدة تلو الأخرى. فقد كانت حصونه تنهار وتتساقط، وصورته هو وجنوده الشياطين تهتز فى نظر الجميع، لأنه عجز عن الدفاع عن مملكته. فلم يجد أمامه وقتئذ، إلا حلاً واحداً وهو أن يتآمر على قتل السيد المسيح.. وبالرغم من خوفه هو شخصياً من قتل السيد المسيح لأن النبوات قد أشارت إلى أنه بقتل السيد المسيح يتم الخلاص والفداء إلا أنه لم يجد أمامه حلاً آخر.
بين نارين
كان الشيطان كمن هو قائم بين نارين: نار النبوات التى تقول “الرب وضع عليه إثم جميعنا” (إش53: 6) و”جعل نفسه ذبيحة إثم” (إش53: 10) و”مجروح لأجل معاصينا” (إش53: 5)، ونار الهزيمة التى كان ينهزم بها أمام السيد المسيح.
أما السيد المسيح فقد كان يخفى ألوهيته فى بعض المواقف، ويظهر شيئاً من الضعف البشرى لكى يجعل الشيطان يفقد حذره. فكان يتعب من المشى مثلاً، أو يجوع ويعطش. فحينما كان الشيطان يرى منه ذلك كان يطمئن ويظن أن فى إمكانه التخلّص من السيد المسيح. وإذ رآه يبكى عند قبر لعازر تشجّع أن يكمل المؤامرة التى بدأها.
لماذا يغامر الشرير ؟
لماذا يحب الشرير أن يغامر فى مؤامراته؟.. يغامر الشرير لأن قوة الحقد التى فى داخله أقوى من قوة الحذر المحيطة به. فهو يشعر أنه يخاطر، لكنه لا يستطيع ألا يدخل فى المخاطرة. لأن الغيظ والحقد والكراهية تعمى بصره عن أن يحذر فيما هو مزمع أن يفعله..!!
وهذا ما حدث فعلاً: فقد هيّج الشيطان اليهود وكثير من الأشرار. ووضع فى قلب يهوذا الإسخريوطى أن يسلِّم سيده وتمم المؤامرة وتم الصلب، حيث تم الفداء. فعلى الصليب سحق السيد المسيح كل مملكة الشيطان، وهزمه فى عقر داره. وهناك فى الجحيم حطّم المتاريس وأطلق المسبيين وأصعدهم إلى السماء الثالثة أو الفردوس. ثم عاد من الفردوس ليقوم من الأموات فى اليوم الثالث وظهر لتلاميذه مؤكداً أن قوة الحياة التى فيه هى أقوى من الموت الذى لنا. وقال لتلاميذه إنه سوف يمضى
لكى يعد لهم ملكوتاً أبدياً سوف يستعلن فى مجيئه الثانى، حينما يأتى ليدين العالم كله.
لماذا أخفى السيد المسيح لاهوته عن الشيطان؟
يقول القديس بولس الرسول: “لأن لو عرفوا لَما صلبوا رب المجد” (1كو2: 8).. لو تأكد الشيطان أن يسوع هو الله الظاهر فى الجسد لَما تجاسر أن يصلبه..
لو ظهر السيد المسيح بملء مجده الإلهى لَما احتمل البشر أن يبصروه. لأنه قال لموسى النبى حينما أراد أن يرى ملء مجده: “لا تقدر أن ترى وجهى، لأن الإنسان لا يرانى ويعيش” (خر33: 20). لذلك التحف السيد المسيح بالناسوتية ليخفى مجده حينما تجسد ووُجد فى الهيئة كإنسان.
لقد احتار الشيطان فى فهم سر التجسد بدءًا من إخلاء الله الكلمة لنفسه ليأخذ صورة عبد. ومروراً بكل ما ظهر به السيد المسيح من التواضع فى ميلاده، وهروبه إلى مصر، وحياته البسيطة البعيدة عن مظاهر العظمة، وفى صومه على الجبل، وفى حزنه، وصلاته، وفى أن ينسب لنفسه عدم المعرفة بشأن اليوم الأخير ( بحسب إنسانيته) وهو العالِم بكل شئ (بحسب لاهوته).
لقد أصيب الشيطان بالارتباك فكلما شعر أن السيد المسيح هو ابن الله أو قدوس الله يعود فيحتار من تواضعه العجيب خاصة فى مسألة المعرفة. لهذا فقد تجاسر بحماقته وغامر فى إتمام مؤامرة صلب السيد المسيح وابتلعت السمكة الطُعم المخفى فيه صنارة قوية أنهت جميع أحلامها وتمت المقاصد الإلهية فى فداء وتحرير البشر من سلطان الشيطان.
كيف أخفى السيد المسيح لاهوته عن الشيطان؟
هذا الأمر كان فى كل مراحل حياة السيد المسيح من ميلاده إلى موته على الصليب..
كان الشيطان فى حيرة وارتباك عظيمين منذ ميلاد السيد المسيح وما صاحب هذا الميلاد من مظاهر الاتضاع والعظمة فى آنٍ واحد.
فميلاده من عذراء بسيطة متواضعة فى حظيرة للخراف كطفل مقمّط مضطجع فى مزود؛ كان فى تقديره لا يتناسب مع عظمة الإله الكلمة المتجسد. مجرد ميلاده كطفل محتاج للرعاية كان ضد فكر العظمة لدى الشيطان.
ولكن تسابيح جماهير الملائكة فى السماء بعد ظهور الملاك للرعاة الساهرين، هذه التسابيح قد أربكت الشيطان وشعر أن المولود ليس إنساناً عادياً.
وعموماً فإن فكرة أن يُخلى الابن الوحيد نفسه من مجده الإلهى لكى يتجسد من عذراء، ويأخذ صورة عبد “الذى إذ كان فى صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلاساً لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس وإذ وُجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب” (فى2: 6-8)..
فكرة إخلاء الذات فى حد ذاتها كانت بعيدة جداً عن حسابات الشيطان الممتلئ غروراً وكبرياءً. وحقيقة أن السيد المسيح يخفى مجده المنظور عندما تجسد آخذاً صورة عبد؛ كانت فوق تصوُّر الشيطان. لهذا ارتبك الشيطان عند ميلاد السيد المسيح ولم يقدر أن يحدد طبيعة المولود الحقيقية.
المجوس والنجم وهيرودس
جاء المجوس للسجود للسيد المسيح بإرشاد النجم المعجزى الذى قادهم إلى البيت حيث كان الصبى فسجدوا له وقدّموا هداياهم ذهباً ولباناً ومُرّاً.
كان لتلك الأحداث وقع سيئ على الشيطان الذى بدأ يشعر بخطورة المولود “ملك اليهود” (مت 2: 2).
ولكنه عندما وجد القديس يوسف يأخذ الصبى وأمه ويهرب إلى مصر من وجه هيرودس الملك شعر أن المولود لا يمكن أن يكون هو ملك الملوك ورب الأرباب. لأنه بحسب فكره: كيف يهرب العظيم من أحد عبيده مثل هيرودس الملك؟ هل يمكن أن يهرب الرب الذى الكل خاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه؟ هذا الأمر حيّر الشيطان جداً، إذ لم يفهم أن هروب السيد المسيح إلى مصر كان ضمن خطته الإلهية فى مباركة أرض مصر وشعبها وزعزعة مملكة الشيطان هناك، ولم يفهم أن الهروب إلى مصر كان مرتبطاً بمذبحة أطفال بيت لحم وما قيل عنها من نبوات وما تحمله من رموز، وإن الهروب إلى مصر كان لسبب أن الصليب هو طريق المسيح المولود إلى إتمام الفداء بعد عماده فى نهر الأردن، وبعدما يختار تلاميذه ويعلّمهم ويعلّم الجموع، ويكرز بالإنجيل، ويصنع المعجزات، ويعمل كل ما عمله لتأسيس الكنيسة. فكيف يمكن لطفل مولود أن يفعل كل ذلك ويكون معلّماً وقائداً روحياً، أو أن يحمل الصليب فى الطريق إلى الجلجثة، ولماذا؟
إذن كان من الطبيعى أن يؤجّل السيد المسيح مسألة ذبحه إلى أن يكبر فى السن – بحسب إنسانيته- ويصنع كل ما صنع متمماً نبوات الأنبياء.
إن كنت ابن الله؟
كان الشيطان فى ارتباك –كما قلنا- فى كل مراحل حياة وخدمة السيد المسيح. وظهر ذلك الارتباك أيضاً حينما سمح له السيد المسيح أن يجرّبه بعد صومه الطويل على الجبل فقال له الشيطان: “إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً” (مت4: 3). وقال أيضاً: “إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل” (مت4: 6).
ظل هذا السؤال “إن كنت ابن الله؟” يتردد فى روع الشيطان إما يردده هو، أو يدفع الآخرين لترديده؛ مثلما قال قداسة البابا شنودة الثالث –أطال الرب حياة قداسته- عن هذا السؤال: {ويُرفع المسيح على الصليب والشيطان ما يزال معذباً فى شكوكه، وإذ أخفى الرب عنه قوته ما يزال يسأل سؤاله القديم: “إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب” (مت 27: 40)}.
وبالرغم من أن الشيطان حينما رأى معجزات السيد المسيح قد صرخ قائلاً: “أنا أعرفك من أنت: قدوس الله” (مر1: 24)، إلا أنه عاد فشك فى ذلك حينما كان السيد المسيح يتصرف بطريقة إنسانية طبيعية مثل أنه يصلى إلى الآب، أو أن يحتمل قول اليهود عنه أنه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين، أو أن يتكلم عن آلامه وصلبه وموته بواسطة الأشرار. مثلما كتب قداسة البابا عن شك الشيطان فى لاهوت السيد المسيح بعد أن ادّعى أنه قد عرفه من هو {ولكنه يسمع الرب بعد ذلك مباشرةً يُظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى أورشليم “ويتألم كثيراً من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفى اليوم الثالث يقوم” (مت16: 21) فيتعجب كيف يكون هو ابن الله ويتألم ويُقتل؟!}.
وقد شرح قداسة البابا شنودة الثالث سبب إخفاء السيد المسيح قوة لاهوته عن الشيطان فقال: {فى الواقع إنه من أبرز الأسباب التى تجعل البعض يظن أن السيد المسيح كان ضعيفاً هو أن الرب كان باستمرار يخفى قوته. كان يخفيها من باب الاتضاع، وكان أيضاً يخفيها عن الشيطان لدرجة أن الشيطان كان يقف متحيراً أمام حقيقة المسيح يسأل نفسه أهو حقاً المسيح أم أنه ليس هو؟ “يا ترى هو واللا مش هو؟”. ولم يكن من الصالح أن يعرف الشيطان حقيقة المسيح لئلا يبذل جهده لعرقلة عمل الفداء لأن الشيطان لا يحب خلاص العالم وكان يتمنى أن ذلك لا يتم}.
ثم استطرد قداسة البابا شنودة الثالث –أطال الرب حياة قداسته- وعرض كثير من الأمثلة لهذا الشك الذى وقع فيه الشيطان نتيجة لإخفاء الرب قوته الإلهية عنه وأورد ذلك كله فى كتاب “مجموعة تأملات فى أسبوع الآلام” فى الصفحات من 67 إلى 75 وهى نفسها التى أوردها فى الكتاب الثانى من هذه الكتب بعنوان “لك القوة والمجد” فى الصفحات من 37 إلى 49. وسوف نجد فى هذه الأمثلة الكثير والكثير مما نستفيد منه فى فهم هذا الموضوع العقائدى المهم.