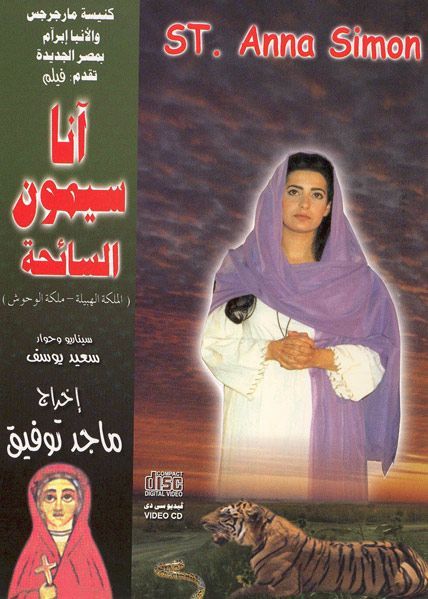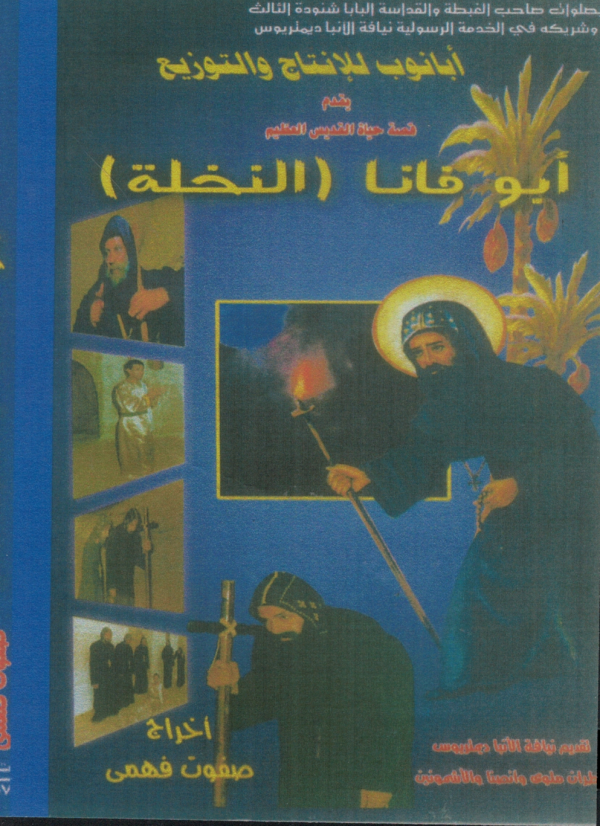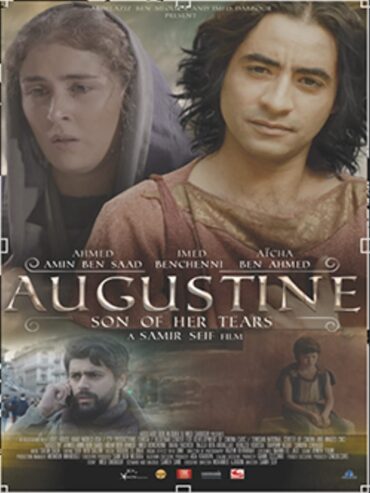سائح
روسى على دروب الرب
هذا
الكتاب الذي نقدم لكم من الكتب الروحية المعروفة، له منزلته ومكانته في الأدب
الديني الحديث.
ترجم
إلى لغات عديدة، منها الإنكليزية والفرنسية والألمانية، وظهرت له عدة طبعات في
أكثر من لغة.
يتألف
هذا الكتاب من سبع قصص. الأربع الأولى منها عثر على أول مخطوطة لها العام 1860 بين
يدي راهبة روسية هي ابنة روحية للستارتس الروسي الشهير الأب أمبروسيوس من دير
اوبتينا. هذه القصص الأربع نشرت لأول مرة في روسيا، وفي مدينة كازان بالذات، حوالي
العام 1865، ثم نشرت ثانية العام 1884، وتجاوزت الحدود الروسية بعد السنة 1920.
أما
القصص الثلاث التالية فد وجد نصها بين أوراق الأب أمبروسيوس فنشرت في روسيا السنة
1911 وفي تشيكوسلوفاكيا السنة 1948.
وقد
جمعت القصص السبع لأول مرة السنة 1948 في طبعة باللغة الروسية صدرت في باريس.
وكما
أشرنا فالكتاب ترجم إلى عدة لغات ومنها العربية حيث ترجم الأستاذ أنطوان جرجي
القصص الأربع الأولى السنة 1964 عن الترجمة الفرنسية لجان غوفان.
والآن
نضع بين أيديكم النص الكامل للكتاب منقولاً إلى العربية. وقد أبقينا على الترجمة
السابقة للقصص الأربع الأولى وأضفنا إليها ترجمة للقصص الثلاث الأخرى، قام بها
أيضاً الأستاذ جرجي تلبية لطلبنا، معتمداً الترجمة الفرنسية التي وضعتها السنة
1973 مجموعة من الشباب الأرثوذكسي في فرنسا.
مقدمة
لا
يعرف مؤلف هذا الكتاب على وجه التأكيد، وقد جاء في مقدمة الطبعة الروسية الصادرة
في العام 1884 أن الأب باييسيوس، رئيس دير الملاك ميخائيل في كازان، قد نسخ النص
المطبوع عن أحد الرهبان الروس في جبل آثوس ولم يذكر اسم هذا الراهب. إلا أن في
الكتاب من الأدلة ما يشير إلى أن ما جاء فيه قد أنشأه أحد الرهبان بعد محادثاته مع
السائح. وهذا الافتراض لا يحرم الكتاب شيئاً من صفات الأصالة التي يتسم بها: فإن
السائح، وكان فلاحاً بسيطاً في الثالثة والثلاثين، لا يجيد الكتابة إلى حد يسمح له
بالتأليف، وغالباً ما كان يروي خبرته إلى أحد الأصدقاء بألفاظ عادية وعبارات
متداولة، فيعمد هذا الصديق المثقف الذكي إلى نقل كلام السائح بأسلوبه الخاص. وقد
حدث هذا بالنسبة للكثيرين من الآباء الروحيين: لم يبلغوا اختبارهم الروحي إلا
بواسطة كاتب كان جل غايته أن يتوارى وراء الأسرار التي يكشف النقاب عنها. وقد يكون
ذلك الصديق ناسكاً من جبل آثوس، وقد يكون الأب أمبروسيوس المتوحد في اوبتينا، معلم
إيفان كيرييفسكي وصديق دوستويفسكي وتولستوي وليونتييف، الذي وجد بين مخطوطاته نص
القصص الثلاث الأخيرة للكتاب.
إن
صح هذا، فالكتاب قد يتصل بالحركة الأدبية في روسيا في القرن التاسع عشر بأصفى ما
فيها وأنقى. في زحمة الكتابات الشعرية والقصصية والثورية التي اصطرعت بها نوازع
المزاج الروسي المتضاربة، جاء هذا الكتاب نغمة بريئة صافية.
يدخل
القارئ مع السائح، وخاصة في قصصه الأربع الأولى، إلى أعماق الحياة في روسيا بعيد
حرب القرم وقبل إلغاء الرق، أي بين 1856 و1861. ويرى معه كل أبطال القصة الروسية
من الأمير الذي يسعى إلى التكفير عن حياة طيش، إلى ناظر المحطة السكير المشاغب،
إلى كاتب المحكمة في الريف ملحداً يناصر الحرية. المحكومون بالأشغال الشاقة قد
يقطعون المراحل في طريقهم إلى سيبيريا. وحاملو الرسائل الإمبراطورية ينهكون جيادهم
على الدروب الطويلة. والجنود الفارون يتيهون في الغابات القصية. النبلاء والفلاحون
والموظفون والمدرسون وكهنة القرى: روسيا الريفية القديمة كلها تبعث أمامنا
بعيوبها، وليس السكر أدناها، وجميل صفاتها وأبهاها المحبة، محبة القريب تنيرها
محبة الله. يحيط بهذا كله الأرض الروسية: السهل الشاسع الذي يتيه النظر في مداه
والغابات الموحشة والفنادق على قارعة الطريق، والكنائس ذات الألوان الزاهية
والأجراس اللامعة. إلا أن الفلاح لا يفيض أبداً في وصف ما يرى من عالم حسي، فهو
مسيحي أرثوذكسي يبحث عن الكمال، وهمه الشاغل ما لا يبلغ إليه.
أما
القصص الثلاث الأخيرة فهي تبرز التساؤلات والشكوك التي كانت تساور المثقفين الروس
في القرن التاسع عشر، وقد احتكوا ببعض الثقافة الغربية. كانت تساؤلاتهم تدور حول
صحة التقاليد الروحية في الكنيسة الشرقية، ولماذا لا يعطى العقل المكانة التي هي
تقليدياً للقلب كمركز للإنسان الروحي؟ وسنلاحظ أن كثيراً من هذه التساؤلات لا يزال
يلح علينا اليوم. ولذلك فالإجابات المعطاة في الكتاب هي أيضاً موجهة إلينا، وهي
تدعونا إلى نفض الغبار عن تراثنا الكنسي الأصيل والعودة إلى عيشه والتزامه في
حياتنا كلها، لكي نغدو نحن أيضاً سياحاً إلى الله لا نبغي سوى وجهه تعالى.
وليس
للسائح دليل في سعيه هذا إلا كتابان: الكتاب المقدس و(الفيلوكاليا) {الكلمة في
اليونانية تعني (محبة الجمال)}.
ما
هي الفيلوكاليا؟ إنها مجموعة نصوص آبائية تقدم لنا الصلاة الداخلية وكيفية
المحافظة على نقاوة القلب. تم جمع هذه النصوص ونشرها لأول مرة العام 1782 في
البندقية، من قبل راهب يوناني في جبل آثوس هو القديس نيقوديموس من ناكسوس والمعروف
بالآثوني. وفي نهاية القرن الثامن عشر (1793)، ترجمها إلى السلافونية الراهب
الروماني باييسي فليتشكوفسكي، ونشرها تحت اسم (الدوبروتوليوبيه)، وهي تعني محبة
الصلاح أو الطيبة. وقد تضمنت هذه الترجمة نصوصاً للآباء لم تكن موجودة في
الفيلوكاليا اليونانية.
وقد
أدى نشر الكتاب هذا في روسيا إلى نهضة روحية واسعة وإلى تأصل في التقليد الروحي
الشرقي. ولم تقتصر مطالعته على الرهبان واللاهوتيين فقط، بل تجاوزتهم إلى أوساط
الشعب، إذ إن شعب الله كله، أساقفة وكهنة ورهباناً وعاميين، مدعو بالقوة نفسها إلى
سلوك دروب القداسة. واللاهوتي الحق، كما يقول الآباء الشرقيون، هو المصلي الحق.
وفي
السنة 1877، ظهرت طبعة جديدة في خمسة أجزاء باللغة الروسية، نشرها ثيوفانوس
المعتزل (1815- 1894). هذه الطبعة لم تكن كسابقاتها تماماً، بل زيد عليها الكثير
واجتزئ منها بعض النصوص. وغدا هذا الكتاب الغذاء الروحي الأساسي والمفضل عند
الرهبان الروس حتى أيامنا هذه.
وفي
أثينا أيضاً ظهرت السنة 1897 طبعة ثانية للفيلوكاليا موسعة وبالغة اليونانية.
ولكن
لم يتوقف (عصر الفيلوكاليا) عند هذا الحد. بل تلقف الكتاب الأب ديمتريوس ستانيلوي
الروماني، وبدأ السنة 1946 بنشر نوع من الموسوعة الفيلوكالية، مع شروحات ودراسات
نقدية. ولكن لم ينته هذا العمل الجبار حتى الآن، لأن الأب المذكور قد أدخل السجون
لسنوات عديدة، إبان الحملة التي شنتها الدولة، ابتداء من السنة 1958، ضد القوى
الكنسية الفاعلة في رومانيا.
وقد
تعدى الاهتمام بالفيلوكاليا حدود البلدان الأرثوذكسية. فصدر في لندن السنة 1951
كتاب يضم مجموعة من النصوص الأساسية للفيلوكاليا. وتبع ذلك صدور مختارات من الكتاب
باللغة الفرنسية السنة 1953. وقد لاقت هذه الترجمات رواجاً منقطع النظير، فغزت
الأوساط المسيحية الغربية، وكانت وسيلة فعالة في تعريف الأرثوذكسيين الذين لا
يحسنون اليونانية ولا الروسية على هذه الكنوز من روحانية كنيستهم.
والآن
وفي عصرنا الحاضر نجد أن الاهتمام بالفيلوكاليا لم ينقص بل ربما ازداد. ومؤشر ذلك
ظهور عدة طبعات جديدة باليونانية، والابتداء بترجمة كاملة بالفرنسية من قبل
الأخوية الأرثوذكسية في فرنسا، كما يصار إلى إعداد ترجمة أخرى في الإنكليزية.
ونأمل أن يوفق الله منشورات النور لنشر ترجمة عربية كاملة في المستقبل القريب.
أما
الخبرة الروحية المقدمة لنا في الفيلوكاليا، فهي عصارة خبرة سنين طوال من الجهاد
الروحي لكبار آباء الكنيسة في الشرق، ابتداء من رهبان صحراء مصر في القرن الرابع،
ومروراً برهبان جبل سيناء وأديرة فلسطين والقسطنطينية، ووصولاً إلى رهبان جبل آثوس
في القرن الخامس عشر.
فالفيلوكاليا
إذن هي بمثابة موسوعة عن الصلاة الأرثوذكسية، وبشكل خاص الصلاة التوحدية. وهي تصبو
إلى إيصالنا، في النهاية، إلى ما يسمى (صلاة القلب) أو (صلاة يسوع)، وقد وصفها
البعض أنها (قلب) الروحانية الأرثوذكسية. وقد سمي هذا التقليد الروحي بالتقليد
الازيخي {من الكلمة اليونانية hésychia التي تعني الهدوء أو السكون}(Hésychasme). ومع أن بعض الآباء قد أعطوا أشكالاً مختلفة لبعض نواحي
ممارستها، بيد أن مبدأ الصلاة المستديمة المتمحورة حول اسم الله المتجسد والمقامة
من قبل الإنسان ككل، جسداً وروحاً، لم يناقش البتة. هذه الصلاة التوحدية لم تبعد
المصلي عن الجماعة الكنسية بل هي وسيلة فعالة لدمجه فيها باستمرار. فالمسيح الذي
يفتش عنه المصلي، واسمه القدوس الذي يردد، لا يمكنهما أن يسكنا فيه إلا بقدر ما
هو، بالمعمودية وسر الشكر، مندمج في جسد الكنيسة. وكما علمنا الآباء، فصلاة يسوع
لا تغني عن النعمة الحاصلة من ممارسة الأسرار الإلهية، بل تساعد على الاستفادة
الكاملة من هذه النعمة. وهكذا يعطي التقليد الازيخي جواباً رصيناً عن مشكلة
التوافق بين التقوى الشخصية والاشتراك بالصلاة الجماعية الليتورجية وبين مساهمة
الروح والجسد في الصلاة. هذا التوافق توصل إليه الآباء نتيجة تبنيهم النظرة الكتابية
للإنسان. فالإنسان (كل)، جسده وروحه متلازمان. وهو يتعامل مع الله ككل، ويصبو إلى
التأله الذي هو غاية وجوده، إذ، كما يقول الآباء، الله صار إنساناً لكي يصير
الإنسان إلهاً. فالإنسان بكليته يستقبل النعمة وليس جزء منه. والإنسان مدعو، كما
بروحه كذلك بجسده، إلى التأله وإلى الشركة مع الله. والنور الإلهي يمكن أن يشع في
جسد الإنسان المتأله على هذه الأرض، وهذا الإشعاع يعطي تذوقاً ويحقق ما سوف يكون
في القيامة العامة. التأله يعني استعادة الصورة الإلهية التي عليها خلق الإنسان.
وسبيل كل مسيحي إلى ذلك – وليس فقط الرهبان – هو في سلوك دروب القداسة، والتزام
نمط الحياة المتقشفة الزاهدة والعيش الدائم في حضرة الله.
هدف
الإنسان إذن التفتيش عن المسيح في كل مواضع سكناه: في الكتاب المقدس، في الأسرار،
في حياة الشركة وممارسة (سر القريب) وأخيراً لا آخراً في ذكر اسم الله المتجسد مع
كل نسمة يتنسمها قائلاً: (يا يسوع ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ). هذه هي صلاة
يسوع، وقد تتلى أيضاً على حبات السبحات التي يحملها الرهبان الأرثوذكسيون.
ولنعد
الآن إلى الكتاب نفسه نجد في القصص الثلاث الأخيرة عرضاً مدروساً لمبادئ التقيد
الروحي الذي ذكرنا، وكذلك لصلاة يسوع. هذا العرض نجده وفقاً للنمط الآبائي في
البحث، أي إنه يتمحور حول موضوع الخلاص بالمحبة وتحقيق ذلك بالصلاة. محبة الله لا
حد لها. والمشكلة هي كيف يتقبل الإنسان هذه المحبة في العمق، لكي يتغير قلبه وتنبت
فيه (ثمار الروح).
أما
القصة الخامسة فتلفتنا أولاً إلى أهمية التوبة التي تعني الانقلاب الداخلي
والتغيير الكلي للذهن والقلب. وتبين لنا أن التوبة الحقيقية هي انكسار القلب أمام
الله واللجوء إليه والارتماء في أحضانه. وتعلمنا أن الصلاة، وهي العلاقة الواعية
مع الله، مهما اتضعت تبقى مفتاح التوبة. وتتابع بشرح واف لصلاة يسوع، من الناحية
الروحية ومن ناحية أسسها الكتابية.
والقصة
السادسة، بعد تأكيدها على التمحور حول الإنجيل الذي يقهر الشيطان (قصة الفرنسي)،
تعود لتذكرنا بنصيب الإنسان من الصلاة والذي يكمن في التكرار و(الكمية). وتشير إلى
أن إمكانية الصلاة متوفرة للإنسان في كل حين أيما وجد، ويمكنها أن ترافقه في كل
عمل يقوم به، مهما صعب، شريطة أن يقيمها في حضرة الله. الصلاة تحيي الإنسان وتعود
به إلى دعوته الأولى إذ تدعوه للوقوف في حضرة الله باستمرار.
وأخيراً
نجد القصة السابعة تؤكد على أهمية الحياة التأملية. وترينا مجانية الصلاة
والعبادة، وكيف أن العالم اليوم هو بحاجة لهذه المجانية وللقديسين، لأن هؤلاء،
بمثلهم الحي وإشعاعهم النابع من علاقتهم الصميمية مع الله، يقودوننا إلى الملكوت
الذي بآن يفوق التاريخ ويحييه.
كذلك
نجد في هذه القصة العديد من الإرشادات العملية يستنير بها الذين يودون سلوك طريق
الصلاة. وتنتهي القصة بصلاة جميلة جداً من أجل القريب، مؤكدة بذلك على أن التقليد
الروحي الازيخي يحرص كل الحرص على أن يترجم الإيمان المعاش في الصلاة إلى محبة
للقريب غير محدودة. وكما يقول الذهبي الفم: إن سر الشكر يدعونا إلى سر القريب. وكل
اتصال أصيل بالرب يجعل منا خداماً للبشر الذين ارتضى المسيح السكنى في قلوبهم.
اطلع
السائح الروسي على التقليد الروحي هذا، لذلك لا يعتقد بأن ممارسة الصلاة وحدها
كافية ليعرف (ما أطيب الرب). ففي تزهده ما يرشده إلى الله. الله دائم التجوال وليس
له حجر يسند إليه رأسه. والصلاة المستديمة، بالنسبة إلى السائح، هي قبل كل شيء،
الوسيلة التي تمكنه من تركيز انتباهه على سر الإيمان.
وليس
إيمان السائح انفعالاً أمام خيالات شعرية، لكنه يغتذي بتعاليم لاهوتية: فنراه يقدم
للذين يتوجهون إليه بالسؤال، نصائح عملية وشروحاً عقائدية، لا وعظاً جميلاً
غامضاً. وهو إذ يعرف الإنسان على ضوء الله، يعلم مكانه ودوره في العالم.
أما
تعاليمه الأخلاقية فليست مجموعة من القواعد المدروسة. فإن أعماله كلها تصدر عن
شوقه إلى الكمال الروحي. والزهد شرط الرؤيا ولا معنى له بحد ذاته. وهكذا يعلمنا
السائح أن الحياة الروحية إنما هي وحدة لا تتجزأ. فالأعمال تأتي من الإيمان، ولكن
ليس من إيمان بلا أعمال. يسير السائح نحو أورشليم الجديدة، وقد أتى من عالم
الخطيئة والجهل والضعف. وسيدخلها جسداً وروحاً في منتهى الدهر، بعد أن يكون قد بدأ
بتذوق هذه الحياة الأبدية منذ الآن من جراء سكنى الله فيه. وقد توصل إلى تجاهل
البرد والجوع والألم وبدت له الطبيعة وكأنها قد تجلت:
(كانت
الأشجار والأعشاب والطيور، والأرض والهواء والنور، كانت كلها تقول لي أنها إنما
وجدت من أجل الإنسان وأنها تشهد بمحبة الله للإنسان: كل شيء كان يصلي ويرنم لله
مجداً).
هذا
هو المدى الرحب الذي يطل عليه من يتبع خطى السائح مستمعاً إليه بإخلاص. أفيجرده من
الطابع الروسي؟ على العكس: فإنما هو نموذج مكتمل للتقوى الأرثوذكسية الروسية، التي
لم تكوّن مدرسة فكر أو مذهباً قائماً بذاته، بل أحييت أصول والعقائد المنقولة عن
بيزنطية وجسدتها في الواقع الروسي.
إن
الشعور الإنساني الذي يتجلى بالتعاطف والشفقة أمام الألم والخطيئة والاقتداء بحياة
المسيح، بالإضافة إلى الصلاة وممارسة الأسرار ومعاشرة الكلمة الإلهية، كل هذه
ميزات الروحانية الأرثوذكسية الأساسية التي يجد لها القارئ، في هذا الكتاب، وصفاُ
عفوياً رائعاً.
تم نسخ الرابط