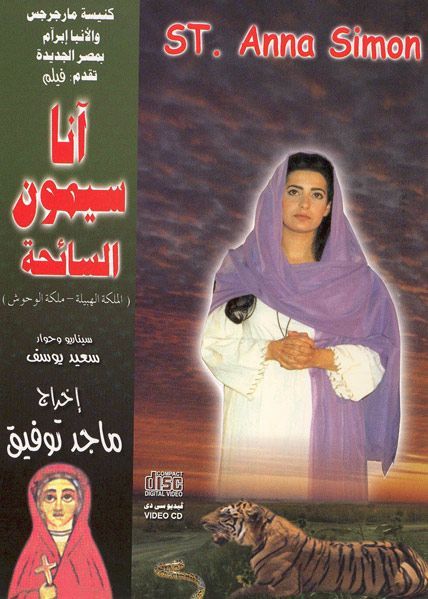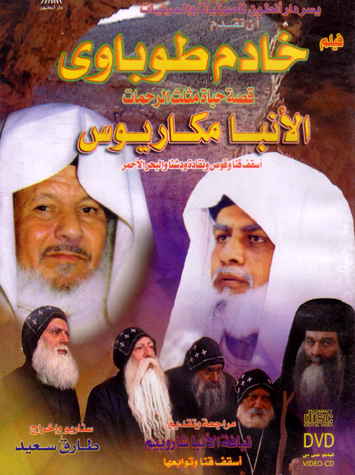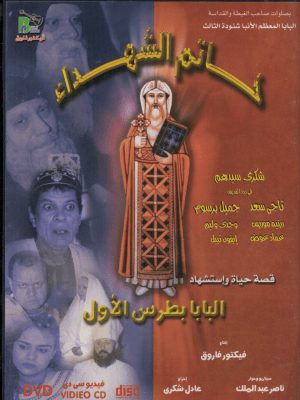صَوْتُ حَبِيبِي.
هُوَذَا آتٍ طَافِرًا عَلَى الْجِبَالِ، قَافِزًا عَلَى التِّلاَلِ
( نشيد 2: 8 )
«صوتُ حبيبي» … كم كان في ذلك الصوت من لطف وجاذبية عندما تكلَّم إلى جميع الذين جاءوا إليه! ومَن يستطيع أن يتصوَّر نغمات صوته المحبوب عندما قال للمفلوج: «ثق يا بُني. مغفورة لكَ خطاياك». عندما قال للمرأة التي وقفت بمفردها في محضره: «ولا أنا أدينك. اذهبي ولا تُخطئي أيضًا». نعم، كم كان ذلك الصوت حنونًا مُواسيًا عندما قال للأرملة: «لا تبكي»، ولتلك التي لمست هُدب ثوبه: «ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاكِ، اذهبي بسلام»!
ذلك الصوت الحنون الذي هدَّأ مخاوف قلوب الخطاة وطمأن خواطر الكثيرين، هو نفس الصوت الذي هدَّأ عجيج أمواج البحر الهائج، وأسكت الريح العاصفة. ذلك الصوت الذي جبَر كسر قلوب الكثيرين، ونادى بالخبر الطيِّب للودعاء والمساكين، هو الذي أمر الأرواح النجسة أن تترك ضحاياها، كما أمر الأموات أن يقوموا من قبورهم.
ذلك الصوت نفسه الذي نطق بأعجب كلمات الحياة والرجاء، والذي في حلاوة نغماته قال: «دعوا الأولاد يأتون إليَّ»، هو الذي نطق بالحكم العادل الحازم على الفريسيين والصدوقيين، فاضحًا رياءهم. فيا لها من رقة وعذوبة! ويا لها من عظمة وقوة!
ثم لنأتِ إلى صوته من وسط آلامه قبيل الصليب. في البستان لما خرَ على الأرض – الأرض الملعونة بسبب خطية الإنسان – نسمع صوت تضرعاته في الصلاة قائلاً: «يا أباتاه، إن شئتَ أن تُجيز عني هذه الكأس. ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك». ومع ذلك نراه ينطق بعد هذا بقليل بتلك الكلمة العظيمة: «أنا هو»، أمام الجمع الخارج عليه، وكان فيها الكفاية لأن تجعلهم يسقطون أمامه.
وعلى الصليب يُسمع صوت المحبة طالبًا الغفران للأعداء، وأيضًا مُعلنًا الوعد اليقين إلى اللص التائب، بالوجود معه في الفردوس، في نفس اليوم. ثم لنسمع صوته من وسط الظلمة – وما أعمق ما تنطوي عليه تلك الصرخات من معنى – إذ يصرخ قائلاً: «إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟». ولكن ذلك الصوت الذي أعلن قيمة كُلفة فدائنا، أعلن أيضًا كمال العمل العظيم «قد أُكمِلَ».
والصوت الذي سكت بالموت نسمعه متكلّمًا مرة أخرى في القيامة. نعم، تكلَّم صوته من على العرش، ولا يزال صوته يتكلَّم أمام العرش كالكاهن والشفيع لشعبه عند الآب. .