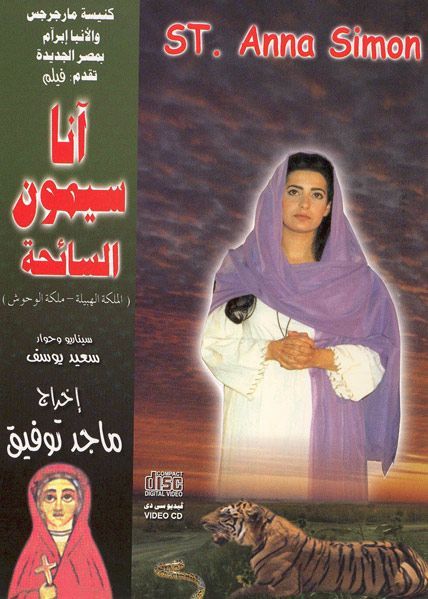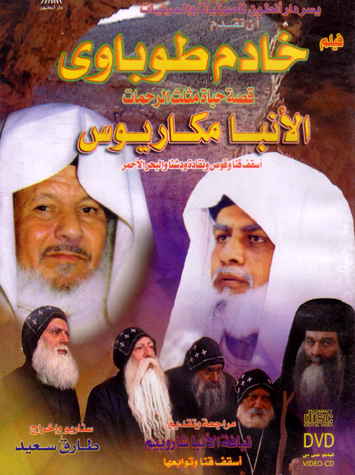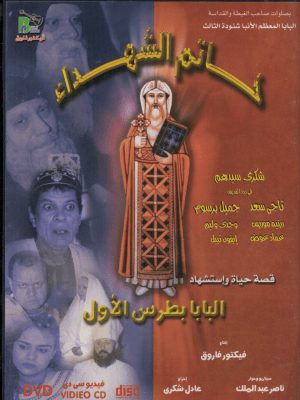5:8- 7
حين قرأنا القصيدة الخامسة، ميّزنا مسيرة رفعتنا شيئًا فشيئًا إلى قمة العاطفة وخاتمة الدراما التي عاشها العريس والعروس. بدأت القصيدة بصورتين عن العروس. الأولى في 6: 4- 12: “جميلة أنت يا رفيقتي، جميلة مثل ترصة”. والثانية في 7: 2- 6: “ما أجمل خطواتك بالحذاء يا بنت الأمير”. وكانت تلميحات إلى المنفى الذي عاشه الشعب بعد أن دمّرت أورشليم (إرجعي فننظر إليك، 7: 1 أ). كما برزت رغبات العريس بما فيها من حبّ ووله (7: 7- 10). وكل هذا انتهى بامتلاك متبادل ونهائي.
منذ بداية القصيدة أحسسنا بالنهاية المنتظرة. لم يعد للعريس أن يبحث عن عروسه، ولا للعروس أن تبحث عن عريسها. فهو لها وهي له. لهذا هتفت “أنا لحبيبي أنا”. وفهمت أنه آتٍ إليها بشوق كبير. فقالت: “إليّ يحمله اشتياقه”. هو الله يذهب إلى الانسان، إلى النفس المؤمنة لكي تكون له بكلّيتها.
(آ 5) “من هذه الطالعة من البريّة”؟ هذا هو الشطر الأول في 3: 6. ولكن هناك دلّت العبارة على مجموعة لا نتميّزها في البداية. أما هنا فالعبارة تدلّ على العروس كما في 6: 10: “من هذه المشرقة كالصبح، الجميلة كالقمر”؟
حاول الشرّاح أن يصحّحوا “م ن. هـ- م د ب ر” (من البريّة، من الصحراء) فقالوا: البهيّة، النقيّة، ورأوا العروس خارجة من خدر أمها ومتوجّهة إلى أورشليم مع عريسها. ورأى آخرون أن عريسها أيقظها في جنّة أمها، فعبرت الصحراء وذهبت معه إلى أورشليم المثالية والمختلفة عن تلك التي عرفت فيها المضايقات (3: 1- 4؛ 5: 2- 8).
أنكون مع الإقامة في كنعان بعد زمن الخروج وعبور البرّية؟ أو بالأحرى نحن أمام تلميح إلى العودة من المنفى إلتي بدت بشكل عبور جديد، لا في البحر الأحمر، بل في البريّة التي تصل إلى أورشليم. لا ننسى أن البرية هي موضع التوبة النهائيّة التي لا رجوع عنها (هو 2: 24- 25). هناك يلد في قلب العروس ومن جديد، حبّ الصبا مع حرارته الأولى. ومن هناك تنطلق العروس بقيادة عريسها فتصل إلى فلسطين.
“م ت ر ف ق ت “: مستندة. رج في العربية “المرفق ” أي الكوع. وترفّق عليه اتكأ. وهناك من قرأ: “م ت ع ن ج ت “، أي تتكئ في غنج ودلال. تستند إلى حبيبها، كالعروس في رفقة عريسها. لقد استيقظت العروس وتركت كل أثر للنوم، أي تابت بكل قلبها. لهذا، فهي تستطيع أن تعود إلى فلسطين مع عريسها. فالذهاب إلى أورشليم هو صعود. وهكذا يدلّ هذا الحدث على تحقيق رغباتها.
ويهتف العريس (آ 5 ب) في خطّ ما قالته الجوقة: “تحت التفاحة نبّهتك”. لا نقول كما قال بعض الشرّاح إن الحبيب ترك الحبيبة نائمة تحت تفاحة البيت الوالدي ثم أيقظها. ولا نقول إن العروس تذكِّرت الزمن الفائت قبل أن تصل إلى تفاحة بيتها. ولا نقول إن التفاحة تدلّ على لذائذ الحبّ، أو تدلّ على العروس. كما في 2: 3. جلست في ظلّه، أي ارتاحت بين ذراعي حبيبها. فإن أيقظها فلكي تتنعّم بملء سعادتها.
في الواقع، التفاحة تدلّ على أرض فلسطين. وهذه الأرض الخصبة تقابل البرية التي طلعت منها العروس في بداية الآية. في 2: 7؛ 3: 5 ؛ 8: 4، نحن أمام يقظة الحبّ النائم. وهذا هو معنى الفعل هنا “ع و ر ر ت ي ك ” (رج أعير في السريانيّة، أيقظ. رج غار في العربيّة: استيقظت الحميّة في الانسان). فالأمّة التي تقيم في فلسطين، قد أيقظها الرب فعادت تحبّه. كانت ندامة العروس ناقصة، ومحاولاتها خيبة أمل لعريسها. ولكن الله هو الذي يحقّق العودة التامّة. هو يتدخّل بشكل مباشر فيحوّل عواطفها تحويلاً تامًا كتهيئة لحدث الخلاص.
إن الرب يقود الخائنة إلى البريّة ويحدّثها إلى قلبها قبل أن يعيد إليها كرومها (هو 2: 16، 21- 22). يعطي شعبه قلبًا جديدًا (إر 24: 7؛ 31: 18، 31- 34 ؛ حز 11: 17- 20 ؛ 36: 25- 29). وهو يقوم بعمل التكفير (حز 16: 63: حين أغفر لكِ جميع ما فعلتِ). هو يخلّص المذنبين لا بالنظر إلى استحقاقاتهم، بل لأجل اسمه (حز 20: 9، 40- 44 ؛ 36: 20- 23، 31- 32، 37- 38؛ 39: 25- 27). والعودة في أشعيا الثاني لا ترتبط بأيّ شرط مسبق (42: 18- 20؛ 43: 8؛ 46: 12-13). فيهوه يعيد المنفيّين من أجل مجده (43: 35؛ 44: 22 ؛ 48: 9- 11) وحبًا بشعبه (8:41- 9؛ 43: 1، 4، 15، 20؛ 44: 2، 21، 22).
“هناك ولدتك أمك “. ما هذه الولادة تحت التفّاحة؟ أتكون الولادة تمّت في بيت زُرعت قربه تفّاحة؟ هناك من أراد أن يصحّح النص الماسوري فتحدّث عن الخراب (ح ب ل، رج في السريانيّة “حبل”) أو عن العقاب الذي سامته الأم لابنتها بسبب حبّها.
ولكن النصّ الماسوري واضح وهو يلتقي مع السبعينيّة والبسيطة (حبلتكى) فيعني “حبل” كما في العربيّة. كما يعني “ولد”. لسنا هنا أمام معنى واقعيّ. بل أمام استعارة وتلميح إلى معطية تاريخيّة نجدها في حز 16. أرانا النبيّ أورشليم التي تمثّل مملكة يهوذا. كان أبوها أموريًا وأمها حثيّة (آ 3). ومنها خرج اسرائيل. وتعود آ 44- 45 إلى هذين الأبوين، إلى ينبوع جميع الخيانات السابقة. ذكّر الرب شعبه بإحساناته إليه، كما ذكّر بخيانات الشعب التي استحقت العقاب. وينتهي هذا الفصل بإعلان احتفاليّ ومكرّر بإعادة العهد إلى ما كان في السابق.
نجد في هذا النصّ فرضيّات نش. أما أم العروس فهي تجسيد لشعوب كنعان حيث تعلّم بنو اسرائيل عبادة الآلهة. فعلى الأرض التي فيها نمت الأمّة وأغاظت عريسها، أعادها هذا العروس إليه وأعطاها ازدهارًا يتفوّق على ازدهار الأزمنة الفائتة. وتتكرّر العبارة فتدلّ على أن ما قاله الله قد تحقّق: “حيث حبلت بك أمك، حبلت من ولدتك “.
(آ 6) هنا تبدأ الحبيبة تتكلّم، فتدل على قوّة الحبّ وعلى الغيرة الذي تجلّى بها هذا الحبّ، كما تعود إلى مفهوم الأمانة. الخاتم (أو: الختم. الجذر هو هو. وكان الختم في الخاتم) يدلّ على صدق عمل من الأعمال المدنيّة، كما يدلّ على إرادة صاحبه بأن يُعطي أو يأمر… كان يُوضع في الرقبة بعد أن يُربط بخيط (تك 38: 18)، أو في الإصبع (إر 22: 24؛ رج تك 41: 41). قد نكون في هذه الآية أمام طريقتين في الانسان بالختم. “إجعلني على قلبك”. هكذا كان يربط الخاتم بخيط ويوضع في الرقبة فيتدلّى على القلب. وكان يوضع في الاصبع الذي يجد امتداده في اليد والذراع.
هنا نتذكّر تث 6: 6- 8؛ 11: 18: أعلن موسى محبّة الله الواحد فقال لشعبه: “ولتكن هذه الوصايا (الكلمات) التي أعطيكم (آمركم بها) اليوم في قلوبكم… اربطوها بأيديكم لتكون لكم علامة”. “فاجعلوا كلامي هذا في قلوبكم وفي نفوسكم، واجعلوه علامة على أيديكم “. إن نص تث يرتبط هنا بما في خر 13: 9: “ويكون هذا كعلامة على يدك “. وأعلن ارميا في معرض حديثه عن العهد: “أجعل شريعتي في ضمائرهم وأكتبها على قلوبهم” (إر 31: 33). وتحدّث أم 3: 3 عن وصايا الحكمة فقال: “لا تترك الرحمة والأمانة، بل اعقدهما قلادة في عنقك، واكتبهما على لوح قلبك “.
إن الفكرة المشتركة بين هذه النصوص هي أن الفرائض الهامّة يجب أن تبقى دومًا أمام عيون المؤمنين كي يتأمّلوا فيها دومًا، ويمارسوها بدقّة. وفي نش، لسنا أمام شريعة، بل أمام ختم (وخاتم) يدلّ على إرادة الحبيب. فعلى العروس أن تجعل دومًا نصب عينيها إرادة الله لكي تنفّذها بدقّة. هذا ما يقابل الحبّ والطاعة كما نقرأ عنهما في تث 6: 5- 6؛ 11: 1: “فأحبّوا الربّ إلهكم واعملوا بسننه وأوامره “.
تريد هذه الكلمات أن تفهمنا قوة الحبّ الذي لا يُقهر ولا يقبل المساومة. وتبيّن لنا أنها تنطبق على كل حبّ بحيث لا نعود نعرف إن كانت العروس تتكلّم أو العريس. تلك هي متطلّبات الرب الذي هو عريس لشعبه.
“الحبّ قويّ كالموت “. الحبّ هو قوّة لا يستطيع شيء في العالم أن يقاومه. وحده الله يستطيع أن يتغلّب عليه. هنا نفهم صلاة التوسّل وفعل الشكر. في أش 38: 20: “يا رب تعال وخلّصني فنغنّي ونسبّح بحمدك كل أيام حياتنا في بيتك يا ربّ “. في هو 13: 14: “أين شوكتك يا موت، أين دمارك يا جحيم”؟ وحين نقول إن الحبّ قويّ كالموت، ندلّ على الصلابة التي بها يدافع عن حقّه، يطالب بحقّه: إنه يريد الكائن المحبوب بكلّيته، ولا يرضى أن يشاركه غريب في حبّه.
ويأتي عنصر موازٍ (رج هو 13: 14) يدلّ على الفكرة عينها. “ق ش ه” أي قاسية، كما في العربيّة. إنها صفة من صفات الغيرة. فهي لا تقبل المشاركة ولا تقبل المساومة في هذا المجال. يغار الرجل حين تخونه امرأته. وقد طبّقت هذه الصفة على الله. فاللاهوت النبويّ نقل هذا المدلول إلى المجال الروحيّ حين تصوّر عهدَ سيناء بشكل زواج بين الله وشعبه، فأفهم خطورة إشراك الله مع أوثان الأمم. ونجد تعبيرًا عن غيرة الله في تث 32: 16، 21 ؛ حز 8: 3، 5؛ 16: 38، 42؛ مز 78: 58. ونتذكّر بشكل خاص تث 4: 24: “فالربّ إلهك نار محرقة، إله غيور” (رج 6: 15؛ يش 24: 19). وهناك عبارة “ا ي ل. ق ن ا” (إله غيور) في خر 20: 5؛ تث 5: 9. ونجد تشديدًا على هذه الغيرة في خر 34: 14: “فالله يدعى الغيور، إنه إله غيور”. نلاحظ أن النصّ (أو السياق) يربط دومًا رفض حبّ الله المطلق لكل مشرك. فمن عبد إلهًا غريبًا عبد زوجًا آخر، والزوج هو “بعل” (هو 18:2).
وتدلّ نهاية الآية (لهيبها لهيب نور وجمرها متّقد) على قوّة الحبّ التي لا تقاوم. إن الضمير في لفظة “ر ش ف ي ه” قد يرتبط بالحبّ أكثر منه بالغيرة. سام الحبّ، لهيب الحبّ. قالت البسيطة: شعاعه (زليقيه). واكيلا: قنديل. إن “ر ش ف ” تعني أولاً البرق (مز 48:78) ثم “السهم ” في أي 7:5: “ب ن ي. ر ش ف ” تعني أبناء البرق أي النسور… إن سهام الحبّ الإلهي هي كنار السماء التي تشعل الموضع الذي تسقط فيه.
“ش ل هـ ب ي ت “. ذاك هو نصّ بن أشير (جمر نار، لظى). أما بن نفتالي وعدد من المخطوطات فيقرأون: “ش ل هـ ب ت. ي هـ ” (أي: يهوه): لهبة الله. نجد في العبرية والآراميّة “ل هـ ب ” قرب “ش ل هـ ب ” في المعنى ذاته كما في العربيّة. أما السريانيّة فلا تمتلك إلا “ش ل هـ ب “.
لهب الله. نار الله (1 مل 18: 38؛ 2 مل 1: 12؛ أي 1: 16). نار السماء، البرق. هذا الكتاب الذي يتكلّم عن الله وحبّ الله، انتظر النهاية ليرفع الستار عن هذا السرّ الرهيب.
(آ 7) تتابع هذه الآية الحديث عن الحبّ بألفاظ عامّة، وفي صورة هي امتداد ما قرأناه في الآية السابقة. ولكننا لسنا أمام ضراوة الحبّ بل أمام الأمانة التي ترافق الحبّ. وهكذا نكون أمام لوحة كاملة لما يجب أن يكون عليه الحبّ المثالي في الزواج.
“م ي م. ر ب ي م ” أي المياه الغزيرة. هي عبارة نجدها 28 مرّة في التوراة وهي تعني البحر والأنهار (أش 23: 3؛ حز 27: 6؛ 31: 5- 7، 5 ؛ مز 29: 3) كما تبدو بشكل استعارة: الاجتياح الذي يهدّد أو الذي قد حصل فترك آثاره (أش 17: 13؛ إر 51: 55) وتنطبق الصورة عينها في المزامير على أعداء المرتّل (32: 6 ؛ 144: 7). وهكذا تعني العبارة هنا المحن الكبرى الممكنة على مستوى الحب، على مستوى الفرد، على مستوى الجماعة (كارثة سنة 587). ولكن مهما عنفت، فهي لا تستطيع أن تتغلّب على الحبّ وما فيه من أمانة وثبات.
“ك ب هـ “. رج في العربيّة: كبت النار أي غطّاها الرماد والجمر تحته. أو خبت النار: خمدت وسكنت وطفئت. لا شيء يطفئ نار الحبّ. وتأتي “الأنهار” (ن هـ ر و ت) في موازاة “المياه الغزيرة”. فتدلّ بشكل خاص على القوى المعادية لاسيّمَا مصر وبابلونية في مقاطع تعلن نجاة المسبيّين، وبشكل عام على أحكام الله (إر 46: 7- 8؛ حز 32: 2، 14؛ أش 42: 15؛ 43: 2؛ 44: 27؛ 47: 2؛ 50: 2 ؛ رج مز 74: 15).
هنا نذكر أش 43: 2 القريب جدًا من نش: “إذا عبرت في المياه فأنا معك، أو في الأنهار فلا تغمرك. إذا سرت في النار فلا تكويك أو في اللهيب فلا يحرقك”. لسنا فقط أمام محن ملموسة، بل أمام صورة تدلّ على اطمئنان وسلام في الأزمنة الاسكاتولوجيّة. وهكذا لا شيء يعكّر تعلّق العروس التي عادت إلى حبيبها، بما فيه من هدوء وعمق.
وتنتهي الآية بقول مأثور: “لو أعطى الانسان ثروة بيته ثمنًا للحبّ لناله الاحتقار”. لو أعطى أي أراد أن يعطي. لو “قدّم” (تك 23: 13). فهذا المال الذي يقدّمه لن يُقبل. “كل غنى بيته “. قالت السبعينيّة: “كل حياته “. نجد هذه العبارة مع بعض ألفاظها في أم 6: 30- 31: “لا يُحتقر السارق إذا سرق… يعطى كل أثاث (غنى) بيته”.
المالي مقابل الحبّ. هناك من فكّر بالمهر. وهناك من جعل العبارة في صيغة الاستفهام: “إذا أعطى الواحد كل ما يملك، فهل يُحتقر”؟ في الواقع، نحن أمام تأكيد بسيط (لا وجود لأداة الاستفهام وإن قال الشرّاح إنها قد تكون سقطت) يعلن فيه الكاتب سموّ الحبّ الذي لا يضاهيه شيء في الدنيا. هو خير لا يُشرى ولا يُباع، بل يقدّم طوعًا.
* من هذه الطالعة من البرية
بعد قمة نش في القصيدة الخامسة، نسمع جوقة الأمم تعلن خاتمة الكتاب: “من هذه الطالعة من البرّية، مستندة إلى حبيبها”؟ هنا نسمع مرة ثالثة هتاف الاعجاب في فم الجوقة. في المرّة الأولى سمعناها في بداية القصيدة الثالثة بعد أن رأت في الأفق عمود الدخان والعطور والمرّ والبخور، الذي يغطّي الحبيب بسرّه. في المرّة الثانية، معناه في القصيدة الخامسة وأمام جمال الحبيبة التي ارتفعت كالكوكب في الأفق. لهذا، عبّرت الجوقة عن ابتهاجها فقالت: “من هذه المشرقة كالصبح، الجميلة كالقمر، البهيّة كالشمس “؟ وهنا نسمع هذا الهتاف للمرة الثالثة، أمام رؤية متنامية. لا رؤيته وحده. ولا رؤيتها وحدها. بل رؤية العروسين معًا بعد أن اجتمعا في عهد مقدّس. أمام هذا المشهد تتساءل الجوقة بدهشة وإعجاب: “من هذه الطالعة من البرّية”؟ إنها مثل عروس تستسلم بوداعة لحبيبها، تستند إليه بعد أن توحّدت به، تماهت معه في وحدة “الزواج “. هكذا تشاهدها الجوقة وتتأمّلها: “هي تستند إلى حبيبها”.
ويتقدّم الاثنان في هذه الساعة الأخيرة من نش، في ذروة حبّهما، كعروسين في يوم أعراسهما. أو بالأحرى كما يتقدّم العروس والعريس في آخر الأسفار المقدسة، في سفر الرؤيا: “لقد جاءت أعراس الحمل، وله تزيّنت عروسه” (رؤ 19: 7). “صعدا” معًا إلى أورشليم. معًا ارتفعا إلى أورشليم الجديدة التي ستكون المدينة النهائيّة لاتّحادهما. في التوراة، يصعد المؤمن دومًا إلى أورشليم. ونحن لا نستطيع إلاّ أن نصعد نحو أورشليم السعادة.
وصل الزوجان من البرية (أو الصحراء). ليست بريّة أيام الخروج، حين كان يشعر الشعب بالتعب في ترحاله بين موع وآخر طلبًا لأرض الموعد. ليست بريّة المنفى ساعة كانت العروس مفصولة عن عريسها بقمم أمانة وشنير وحرمون، بمرابض الأسود النمور (4: 8) التي تأسرها هناك وتهدّدها. فالبريّة في نهاية نش هي هذا العالم الذي فيه يجب على العروس، رغم اتحادها الحاضر بربّها، أن تنتظر أيضاً بصبر طويل، وهي ترتفع يومًا بعد يوم في حبّها (من هذه الطالعة؟). فيجب، بعد أن تقضي هذا القسم الأخير من ليل حياتها على أبواب المدينة المقدّسة، “أورشليم الجديدة” (رؤ 3: 12)، أن يشرق عليها الصبح الذهب فيه يتجاوب الحبيب مع رغبتها العميقة فيدخلها إلى مدينته. “نبيت (الليل) في القرى، وفي الصباح نذهب (نبكّر) إلى الكروم “. إن تريزيا الأفيليّة توسّلت في آخر حياتها: “يا ربيّ وعريسي، ها قد جاءت أخيرًا الساعة التي تشوّقت إليها كثيرًا. الآن، جاء وقت الاتحاد. جاء الوقت الذي فيه نسير ببركة الله “.
غير أن العروس لا تستطيع أن تقوم بهذه الخطوات الأخيرة التي تفصلها عن أورشليم السماويّة، إلا اذا “استندت إلى حبيبها”، إلا إذا اعتمدت على ذراعه. أو كما قال أوريجانس عائدًا إلى نصّ قديم: “إذا استندت إلى قلب حبيبها”. يُقال عن راعي اسرائيل أنه “يحمل الحملان على قلبه” (على صدره) (أش 40: 11). وقيل عن التلميذ في العشاء السريّ أنه استند إلى صدر يسوع (يو 13: 52).
* تحت التفاحة نبّهتك
ولكن الحبيب يقترب على مهل، في هذه المرحلة الأخيرة من طريقهما، ليفتح عينين (هما عينا الحبيبة) لم تتعوّدا بعد على ملء نوره. فيقول: “تحت التفاحة نبّهتك. هناك ولدتك أمك، ولدتك التي حبلت بك ”
فالتفاحة التي جاء العريس تحتها لكي يوقظ الحبيبة، هي تلك الشجرة التي تحتها حبلت بنا بالخطيئة حواء، أمنا بالجسد، وأمنا الأولى. ولكنها الآن تحوّلت تحوّلاً تامًا، بل تجلّت بنور عريسها.
إن التفاحة التي ارتاحت الحبيبة لحظة في ظلّها وذاقت مسبقًا ثمرها الحلو (2: 3) قد تبدّلت الآن. فهي التفاحة الممجّدة، هي شجرة الحياة التي تدلّ بجمالها على الحبيب القائم من بين الأموات والمقيم في جنّة الفردوس. هي الشجرة التي يتأمّل فيها يوحنا “في وسط ساحة المدينة” (رؤ 22: 2).
تحت هذه الشجرة العظيمة جاء العريس ينبّه عروسه، لا من هذا النوم العتيق، نوم التراخي والضعف الذي تركها فيه مدّة طويلة 21: 7 ؛ 3: 5). بل النوم الأخير في ليل هذا العالم (8: 4) الذي يضع حدًّا له إذ يلده إلى نوره وحياته هو القائم من الموت.
“نبّهتك ” (أيقظتك). هي الكلمة التي تشير إلى القيامة. سيقولها يسوع لابن أرملة نائين المحمول في نعشه: “أيها الشاب، لك أقول: قم ” (لو 7: 14). وهي التي تدلّ في أغلب الأحيان على قيامة يسوع (لو 9: 22؛ 24: 6، 34؛ أع 3: 15؛ 4: 10؛ 5: 30) وبطرس وبولس اللذان رأيا في مز 16: 10 (لا تترك نفسي في الجحيم، ولا تدع صفيّك يرى الفساد) نبوءة واضحة عن قيامة يسوع (أع 25:2-28؛ 35:13)، يستطيعان أن يجدا شهادة نبويّة في كلمة نش: “نبّهتك”. قلت لك: إنهضي، قومي. وسيكون كلام أف 5: 14 صدى غير مباشر لهذه الكلمة: “إنهض أيها النائم، وقم من بين الأموات، والمسيح يضيء لك”.
منذ اليوم قد دخلنا في هذا العالم النورانِيّ، عالم قيامة يسوع، الذي يحيّيه يوحنا في رؤ 21: 1 فيقول: “رأيت سماء جديدة وأرضَا جديدة”. ليس هو بعد الزمن الذي سمّاه بولس “الرؤية بالعيان ” (2 كور 5: 7). إنه زمن الإيمان. القيامة هي بداية تجلّي الكون. وهي بداية تجلّينا كما يستشفّها على وجه المسيح الممجّد في قيامته، أولئك الذين يأكلون ويشربون معه بعد قيامته (أع 10: 14). وكما نظن أننا نستطيع أن نستشفّها بشكل شبه ملموس على وجوه أولئك الذين نسمّيهم “قديسين ” في آخر حياتهم، في هذه الساعة التي فيها يشابهون حبيبة نش في نهاية الدراما، فيصبحون شفّافين في نور الملكوت بحيث نتساءل: هل هم من السماء، هل هم من الأرض؟
هذا هو معنى نهاية نش. نحن في الواقع بين الزمن الحاضر، وبين الأبد الذي هو حياة القائمين مع يسوع والمولودين الجدد إلى الحياة (1 بط 2: 2) بانتظار الملكوت.
كم نتأثّر في إطار “الولادة الجديدة” (يو 303) أن نتذكّر تلك الأولى التي أنا مدين لها بالحياة، أن نتذكّر حوّاء التي “حبلت بي وولدتني ” في ظلّ شجرة الخطيئة. ولكنها تبقى أمّي رغم كل شيء. هنا يلفت نظرنا استعادة موضوع الأمم في نش (7 مرات): 6 مرات في علاقة مع أم العروس (1: 6؛ 3: 4؛ 6: 9؛ 8: 1، 2، 5). ومرّة واحدة لتدلّ على أم الحبيب في يوم تتويج ابنها، وهو يوم أعراسه. يسميه نش 3: 11: “يوم فرح قلبه “. ولكننا لا نجد ذكرًا لأب الحبيب أو لأب الحبيبة. فكأني بهذا الاسم لا يُعطى في الحقيقة إلاّ لواحد وهو الآب الذي في السماوات (مت 23: 9). ولكن هذا الاسم لا يمكن أن يُكشف بعد. “فلا أحد يعرف الآب إلاّ الابن، ومن يريد الابن أن يكشف له” (مت 11: 27). وسيقول يسوع في نهاية مهمّته على الأرض: “أيها الآب، أعلنت اسمك للناس” (يو 6:17).
بدأ الحبيب آخر حوار بين العروسين. وها هي الحبيبة التي افتتحت نش بكلامها الحار، تختتمه وحدها دون الصبايا رفيقاتها. فهؤلاء الصبايا قد صرن بعد الآن واحدًا معها في وحدة هذا الحبّ الذي سيكون آخر رغبات الحبيب على الأرض.
* إجعلني خاتمًا على قلبك
قد يكون حلوًا أن نسمع العريس يقول للعروس: “إجعليني خاتمًا على قلبك، خاتمًا على ذراعك”. وهكذا تنطبع صورته بشكل لا يمّحى في قلب صديقته وذراعها. في هذا المعنى قال بولس عن الروح إنه ختم (صورة) الابن الحبيب التي يحفرها الآب في قلب المؤمن (2 كور 1: 22؛ أف 1: 13؛ 4: 30). وسوف يتكلّم يوحنا في رؤ 7: 2- 9 عن ختم الله الحي الذي طُبع على جباه المئة وأربعة وأربعين ألف، على جباه عباد الله. في هذا الخط التفسيري الجميل، نستطيعِ أن نقرأ صلاة تريزيا الطفل يسوع التي سبق وذكرناها: “يا وجه يسوع المعبود. يا جمالا فريدًا يفتن قلبي، تنازل واطبع فيّ صورتك كي لا تستطيع أن تنظر إلى نفس دون أن تنظر إلى نفسك”.
ولكن سياق النص (وما يوازيه من نصوص) يجعلنا نقول إننا نسمع هنا صوت الحبيبة في نهاية نش. هو احتفال بالحبّ المنتصر مع صلاة متوسّلة: “إجعلني خاتمًا على قلبك”.
لقد وعت الحبيبة، حتى وإن كانت في أعلى قمم الاتحاد، أنها سريعة العطب، أن ضعفها يلازمها، يلتصق بها. هي متأكّدة من العريس (وقدرته). ولكنها ليست متأكّدة من نفسها. هذا ما فهمناه في القصيدة الرابعة. وهي تعمل المستحيل لئلا يضعف هذا الحبّ الذي انتصر فيها. هذا لا يعني وجود أي شكّ أو قلق. فحبيبها نفسه قد ثبّت” في الحبّ وفي النعمة (تحت التفاحة نبّهتك). ولكن بدلاً من أن تلتفت إليه فتتمتم له حبها كما في الماضي: “أنا لحبيبي وحبيبي لي”. ها هي تستند إلى حبيبها كعروس متواضعة وتهتف: “اجعلني خاتمًا على قلبك، خاتمًا على ذراعك”. فهي تعرف الآن، ومهما كانت الدرجة التي وصلت إليها، أنها تتلقّى أمانتها فقط من ذلك الذي يسمّيه يوحنا في رؤ 19: 11: “الأمين”.
ولكن ما معنى هذه العبارة: “إجعلني خاتمًا”؟ هي لا تفكّر بشكل مباشر في ختم بالشمع في أسفل وثيقة رسميّة، بل هي تفكّر في الختم أو الخاتم نفسه. فهو يُلزمه، وبالتالي لا يستطيع أن يتخلّى عنه في وقت من الأوقات، وإلاّ ارتكب جهالة.
لجأت التوراة مرارًا إلى صورة الختم قبل أن يدوّن نش. فالرب أجاب أورشليم التي تشكّت بأنها متروكة: “قالت صهيون: الرب تركني، الرب نساني. فأجاب الرب: اتنسى المرأة رضيعها (طفلها الذي ترضعه) فلا ترحم ثمرة بطنها (فلا تعود تحبّه)؟ لكن ولو أنها نسيت، فأنا لا أنساك (يا أورشليم). ها على كفّي رسمتك ” (أش 49: 16). وقال الرب بوضوح لزربابل، صورة المسيح الآتي: “أجعلك خاتمًا” (حج 2: 23). أي كل ما تقوله وتعمله يلزم الله نفسه. فكأنه هو قاله وعمله.
غير أن عروس نش تطلب أكثر من ذلك. ففي جرأة قلبها التي لا حدود لها، تريد حقًا أن تكون الختم الذي يختم “الوثائق”. هي تريد أن تكون ختم حبيبها، وصورتها وعلامتها تكونان على الختم. ماذا تنتظر من كل ذلك؟
بما أنها ستكون ختم حبيبها وخاتمه، فستكون دومًا في إصبعه، في رقبته، على قلبه. نحن الآن أمام أكثر ممّا كان يسبّب فرحها حين كانت تقول: “حبيبي قلادة مرّ لي، بين ثدييّ موضعه ” (13:1). سيكون موضعها هي على الدوام في قلب الحبيب نفسه. وهكذا لن يستطيع لحظة إلاّ أن يفكّر فيها. هي لا تغيب أبدًا عن ذاكرته وتذكّره. بل هي تكون معه دومًا وفي كل مكان، ترافقه في أي وقت وأينما ذهب. فمن يستطيع أن يبعدها عن هذا الموضع الذي تحتلّه الآن؟
وبما أنها ستكون ختمه، فكل ما يفعله في الخلق وتاريخ البشر، ستفعله هي أيضاً معه. وهكذا تشاركه في كل أعماله. وبدونها لا يفعل شيئًا. فيعملان كل شيء معًا، ويلتزمان معًا في كل ما يعملان.
وبما أنها ستكون ختمه، ستكون علامته علامتها، وهويته هويتها، واسمه اسمها. سيكون اسمك اسمي، واسمي اسمك. وهكذا تطبع الحبيبة بختمها ذاك الذي ختمه الآب بختمه (يو 6: 27). وهكذا ينطبع ختمان في بشريّة يسوع: الختم الالهيّ والختم البشريّ.
في سلّم الابتداء في كرمل التجسّد في افيلا (اسبانيا)، التقت تريزيا (كانت بين الثامنة عشرة والعشرين من عمرها) ولدًا ابن عشر سنوات. فدهشت. اقترب منها الولد وسألها: “ما اسمك “؟ أجابت: “تريز يسوع”. ثم سألته: “وأنت ما اسمك”؟ أجاب الولد: “يسوع تريز”. ثم اختفى. تريز يسوع، يسوع تريز. هوية واحدة. اسم واحد. ختم واحد.
توسّلت الحبيبة في نش وقالت: “إجعلني خاتمًا على قلبك “. هي المرّة الوحيدة تتحدّث فيها الحبيبة عن قلب الحبيب. تفجّرت اللفظة من شفتيها في تلك الساعة التي رأت فيها نفسها مقيمة إلى الأبد في هذا الملجأ الاكيد الأمين، “في مكن الصخر” (2: 14). في قلب عريسها الذي هو منزلها الحقيقيّ الوحيد إلى الأبد.
وإذ رأت نفسها ملتصقة بقلبه، لا تنفصل عنه، عرفت أنها تستطيع أن تتصرّف بقوّة ذراعه. “اجعلني كخاتم على ذراعك “. فحين تربح قلب الله تربح قدرته أيضاً. فإن رضي الله أن يجعل النفس الأمينة كخاتم على قلبه، فهو يجعلها أيضاً على ذراعه. قوّة الله وقدرته تصبحان في خدمتها. وإذ تسلّحت الحبيبة بهذا السلام، اقتنعت أن لا شيء فيها أو خارجًا عنها، يستطيع بعد اليوم أن يفصلها عن حبيبها أو يفصل حبيبها عنها. “إنها تعرف بمن آمنت، في من وضعت ثقتها” (2 تم 1 :12).
قد يحصل لذاك الذي استسلم بكلّيته للحب، الذي يعيش منذ الآن حياة الملكوت، قد يحصل له أن يتأكّد من نفسه مثل عروس نش، فيقول أقوالاً قريبة من التحدّي: “على الله أتوكّل، إليه أستند، فلا أخاف شيئًا” (مز 56: 5). وممّ يخاف بعد؟ لا حاجز في العالم، لا انسانًا في البشر، يستطيعان أن يقاوما الحبّ الذي سلّم ذاته إليه.
* الحبّ قويّ كالموت
بعد الاحتفال بالوحدة في الحبّ (إجعلني خاتمًا على قلبك)، ها هي الحبيبة تنشد حبّهما الذي لا يدمّره شيء ولا أحد. “فالمياه الغزيرة لا تستطِيع أن تطفئه (تطفئ نار الحب). والأنهار لا تستطيع أن تغمره “. هكذا نجد اعلانًا مسبقَا عن موضوعين نجدهما في خطبة يسوع بعد العشاء الأخير. “أثبتوا فيّ وأنا فيكم” (يو 15: 4). “فرحكم لا يأخذه أحد منكم ” (يو 16: 22).
لا الموت ولا الجحيم (الشيول أو مثوى الأموات)، لا المياه الغزيرة ولا الأنهار… هكذا تطّلعت الحبيبة إلى كل ما يمكن أن يهدّد حبّها في العالم، إلى كل ما لا يستطيع البشر أن يقاوموه، إلى كل قوى الشرّ والسوء. ولكن لا ننسى أن “المياه الغزيرة” تدلّ على الغمر العظيم الذي يقيم فيها لاويتان (أو: الملتوي) وبهيموت (البهيمة في حدّ ذاتها). الذي تقيم فيه قوى الجحيم. أما الأنهار فترمز إلى الضيق والقلق اللذين تتعرّض لهما النفس في هذه الحياة. وتعلن العروس في اندفاع المحبّ الوله: لا شيء مطلقًا، لا شيء أبدًا يؤثّر على حبّها. فالرب قد قال لها: “إذا عبرت في المياه فأنا معك، أو في الأنهار فلا تغمرك ” (أش 43: 2).
بدأت الحبيبة بالموت الذي هو أخطر عدوّ. ثم انتقلت إلى الشيول، وهو الموضع الذي لا يرجع منه الموتى. فالموت قد ابتُلع بالظفر (1 كور 15: 55). لا شكّ في أن الموت لم يُقهر إلى تلك الساعة. فالعظماء خضعوا هم أيضاً له. غير أن حبّ الحبيب أقوى من الموت. “قوّات الموت لا تقدر عليها” (مت 16: 18). على الكنيسة، عروس المسيح المحبوبة. وأكّد يسوع أن الخراف التي سلّمه إياها الآب، لم يهلك منها أحد. فليس من قوّة في الدنيا تقدر أن تنتزعها من يده (يو 10: 28). لأن الحبّ أقوى من كل شيء.
المرّة الوحيدة التي فيها نرى الموت في حوار الحبيبين، نراه مغلوبًا على أمره مهزومًا، لأنه حاول أن يحارب الحبّ. لقد صار الحبّ في النهاية شخصاً حيًّا تجاه الموت والشيول اللذين جسّدا قوى الشرّ وعالم الظلمة. أجل، لقد واجهت قدرة الحب هاتين القوّتين المعاديتين وانتصرت عليهما. لهذا قال الحبيب في رؤ 1: 18: “بيدي مفاتيح الموت والشيول ” (أو: الجحيم، مركز الاموات).
حين قرأ أوغسطينس هذه الفكرة بأن الحبّ يقاوم الموت هتف: “الحبّ قويّ كالموت. أية كلمة مدهشة، يا إخوتي! الحبّ قويّ كالموت. فقوّة الموت لا تجد عبارة أفضل من هذه: الحبّ قويّ كالموت. إخوتي، من يقاوم الموت؟ اسمعوا لي: قد نقاوم النار، وأمواج البحر، والسيف. قد نقاوم الملوك والسلطات المستبدّة. ولكن حين يأتي الموت، فمن يقاومه؟ لا شيء أقوى منه. فالحب وحده يواجه قوّته. ونستطيع القول إن الحبّ قويّ كالموت “.
وإذا أردنا أن نتحدّث عن “غيرة الشيول الذي لا يرحم “، الذي لا يتخلّى عمّن ابتلعهم، فمن يستطيع أن ينجو من قبضة الموت؟ هذا ما قاله مز 89: 49. فما عساها تكون غيرة الحبيب في نش؟ الله هو إله غيور، كما تقول التوراة مرارًا.
هنا نقرأ خر 20: 5: “أنا الرب إلهك إله غيور، أعاقب ذنوب الآباء في الابناء إلى الجيل الثالث (أبناء الابناء أو الأحفاد) والرابع (أبناء الأحفاد) ممّن يبغضونني”. ولكن غيرة الحبيب في نش (هي المرأة الوحيدة تلفظ كلمة غيرة) هي إيجابيّة في جوهرها. هي لا تتوجّه ضد اللا مؤمن، الخائن، بل تحاول أن تدافع عن الحبيبة وتحميها وتخلّصها. وهكذا انقلب مفهوم الغيرة رأسًا على عقب، ونحن نجد تعبيرًا عنها في كلام مليء بالحنان تلفّظ به يسوع فقال: “يا أورشليم، يا أورشليم، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة صغارها تحت جناحيها” (مت 23: 27).
غيرة الدجاجة التي تسهر على صغارها وتجعلهم حالاً تحت جناحيها حين ينبح الكلب. هذا ما قاله أوغسطينس. غيرة الحبّ الذي يدافع عمن التجأ إليه ويحميه. وسيقول يسوع في نهاية حياته: “لقد حفظت كل الذين أعطيت لي، ولم يهلك منهم أحد” (يو 17: 12). إن غيرة الله عبر نش كله، هي قوّة العريس كما وُضعت في خدمة العروس. قوّة الله في خدمة الكنيسة، في خدمة كل واحد من أتقيائه.
* سهامه سهام نار
وتأتي صورة “سهام النار” (أو: لهيب النار) فتخضع للالهام ذاته. فالحديث عن الحبّ الذي يجرح أو الذي يحرق أمر معروف. ولكن ما تريد ان تقوله العروس هنا حين تتحدّث عن سام النار، هو لهيب نار حبّ حبيبها الذي يدمّر ويحرق حولها كل ما يجرحها أو يصيبها. إن حبّ العريس يرسم دائرة نار حول تلك التي يحبّ كما سبق الربّ ووعد في زك 2: 5: “أكون لها سور نار فأحيط بها”.
وتابعت العروس كلامها: “لهيب يه ” أي لهيب الربّ. إن اسم “يه” الذي نجده مثلاً في “هلويا” (هللوا ليهوه) هو شكل مختصر للفظة “يهوه”. نقرأ مثلاً في أش 26: 4: “توكّلوا دومًا على يه”. ولكن نندهش حين نقرأ هذه اللفظة هنا وللمرّة الأولى. بل هي المرة الوحيدة يرد فيها اسم يوه في نش.
فهذا السفر الذي نرى الله حاضرًا فيه عبر الرموز الكتابيّة: الراعي، الملك، السيّد، الزوج، الهيكل، الكرم… هذا السفر ينتهي بنزع الحجاب عن الربّ، العريس المغرم بشعبه حتى الجنون. هذا الحبّ هو الموضوع الوحيد في نش، وها هو ينكشف لنا بتحفّظ وخفر فيدخلنا في غنى يرتكز على كل الكتاب المقدّس.
إن لفظة “يه” هي في الواقع مفتاح نش كله. فاسم الحبيب يكني كمنارة ليلتي ضوءه على هذه القصائد الخمس. لفظة من حرفين: ي ه. فالذي يحبّ يكتفي بشيء قليل. الحبّ العظيم هو الذي يبقى في السرّ ولا ينكشف إلا في الصمت والكتمان.
ونلاحظ أن النار التي ترتبط بالحبّ في كل حضارات العالم، لا نقرأ عنها إلاّ هنا، لا في مئة مقطع من نش كما كان لنا أن ننتظر. والنار التي هي رمز مميّز لله في الظهورات العظمى في حوريب وجبل الكرمل (كما ستكون في يوم العنصرة) لا تظهر للمرة الاولى إلاّ في أواخر نش وفي اتصال مع اسم “يهوه “. كل هذا من أجل تيوفانية (ظهور الله) الحبّ.
* الحبّ لا تطفئه المياه الغزيرة
لهيب يهوه، نار الروح، نار الحبّ. العروس متأكّدة أن لا شيء يمكنه أن يحصر هذا الحريق أو يوقف اندلاعه. لهذا قالت: “الحبّ لا تطفئه المياه الغزيرة ولا تغمره الأنهار”.
عبر الأدب البيبلي، كانت المياه الغزيرة مرادفة للضيق العظيم. ولكن ماذا تستطيع هذه المياه ضد حبّ الحبيب؟ فهي لا تطفئ الحبّ، بل تزيده اشتعالاً. هي لا تستطيع أن تغمر الحبّ وتغرقه، بل تجعل هذا الحبّ مِشعل العالم بواسطة ذلك الذي “جاء على الأرض ليلتي نارًا” (لو 12: 40).
لا كارثة تخيف حبيبة الله، ولا الغمر العظيم. فهي لا تعرف إلا الغمر العميق، غمر الحبّ الرحيم. أما في ما تبقّى، فالحيّة نفسها، عدوّة المرأة منذ البدء (تك 3: 15)، ستحاول أن “تقذف في إثر المرأة نهر ماء لكي تحملها أمواجُه، ولكن الأرض فتحت فاها وابتلعت الشر الذي قذفه التنين” (رؤ 12: 15- 16). أجل، كل محاولات العدوّ ستكون بلا فائدة. ذاك هو التحدّي العنيف والهادئ الذي تضعه العروس في نهاية نشيدها أمام قوى العالم كله.
وآخر رنّات صوت العروس، نجد صداها في كلام بولس، في نشيده للحب، في روم 8: 35- 39: “فمن يفصلنا عن محبّة المسيح؟ الشدّة أم الضيق، أم الاضطهاد، أم الجوع، أم العري، أم الخطر، أم السيف؟ على ما هو مكتوب: إنّا من أجلك نُمات النهار كله، وقد حُسبنا مثل غنم للذبح. غير أنّا في هذه كلها نغلب بالذي أحبّنا. فإني لواثق بأنه لا موت ولا حياة، لا ملائكة ولا رئاسات، لا حاضر ولا مستقبل ولا قوّات، لا علوّ ولا عمق، ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبّة الله التي في المسيح يسوع ربنا”