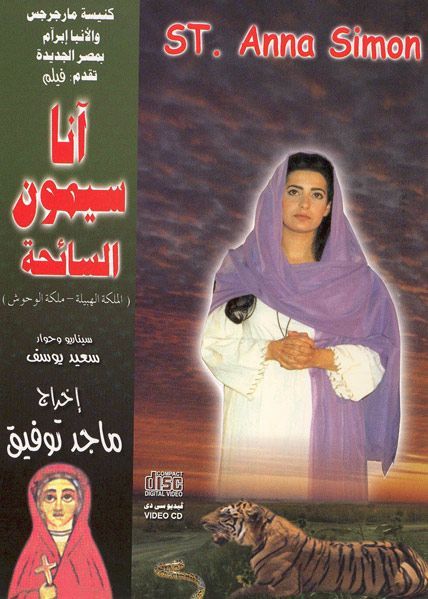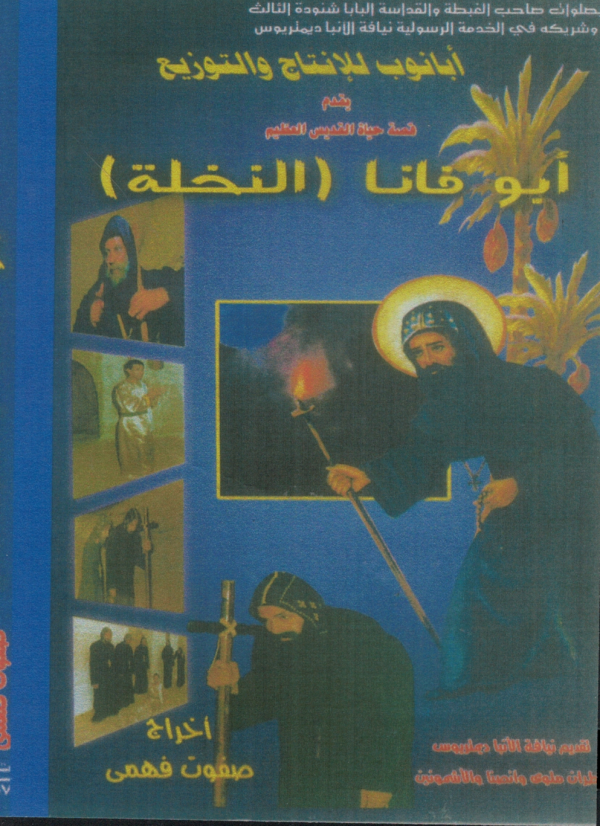الباب الأول
حال إسرائيل
ص1-3

استخدم الله كل تشبيه ممكن للكشف عن علاقته الوطيدة بالبشريّة وحبه لها، وتوضيح مرارة نفسه من جهة كل خطية يرتكبها الإنسان فيجرح بها هذه العلاقة. وقد جاء هذا السفر يدور حول تقديم شعب الله كعروس خائنة لعريسها السماوي، ومع هذا فالعريس يقدم كل إمكانياته الإلهية ليردها إليه بعد تقديسها.

1. مقدمة
إن كان هوشع يعتبر بالأكثر نبيًا لإسرائيل أيّ مملكة الشمال، لكن الكتاب المقدس يحدد تاريخ نبوته بملوك يهوذا ذاكرًا ملكًا واحدًا فقط من ملوك إسرائيل. فإن كان رجل الله قد دُعيَ لخدمة شعب إسرائيل وتحذيرهم وإنذارهم بالسبي، لكن قلبه المتسع بالحب لخلاص الكل، فيفرح بعمل الله مع الجميع حيث يعد الله “ويجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معًا” [ع11]. فمن يخدم الله لا يعرف للحب حدودًا، إنما يشتهي خدمة الكل وخلاص الجميع.
يرى بعض الدارسين أن هوشع لم يذكر من ملوك إسرائيل غير ملك واحد، لأن ملوك إسرائيل كانوا أشرار لا يستحقون الذكر، مكتفيًا بذكر هذا الملك الذي وإن كان شريرًا لكنه تشرف بلقب: “مخلص الشعب” (2 مل 14: 27)، تبعه سلسلة من القلاقل والاغتيالات والفوضى انتهت بالسبي.
يفتتح النبي السفر هكذا: “قول الرب الذي صار لهوشع بن بئيري” [ع1]، وكأنه أراد تأكيد أن ما ورد في السفر ليس من عندياته إنما هو “قول الرب”، وما هو إلاّ بناقل لكلمات الرب وشاهد حق لها.
يذكر النبي نسبِه لوالده “بئيري” التي تعني “بئر”، فإن كان إسرائيل كما وصفه هذا السفر قد صار أرضًا خربة وبرية قفراء، جفت عينه ويبس ينبوعه (13: 15)، فإنه في حاجة إلى الجلوس مع المخلص عند البئر كما حدث مع السامرية لترتوي من ينبوع مياهه الذي لا يجف. ما يقدمه هوشع من كلمات خلاصية إنما هو من البئر الإلهي، من يشرب منه لن يعطش إلى الأبد (يو 4: 14).

2. جومر بنت دبلايم

ربما يدهش البعض كيف يأمر الله نبيه أن يرتبط بامرأة زانية كزوجة له وينجب منها أولاد زنى، إذ يقول له: “اِذهب خذ لنفسك امرأة زنى، لأن الأرض قد زنت زنًا تاركة الرب” [ع2].
أولًا: اختلف البعض في تفسير تعبير “امرأة زنى” (1: 2)، ففي الإنجليزية تترجم harlot وليس adultress ، لذا يرى البعض أنها لا تعني مجرد امرأة زانية بطريقة جسدية حسب المفهوم العام، وإنما تعني إنسانة مكرسة حياتها للبعل، فتحسب زانية من أجل ارتباطها بالبعل، خاصة وأن عبادة البعل ارتبطت بارتكاب الزنا، فقد وجدت نازرات يكرسن حياتهن للبغي لحساب البعل، ولعل جومر بنت دبلايم كانت من فئة هؤلاء الناذرات(12).
في الواقع أن عبادة الوثنية في ذاتها كانت تدعى زنا harlotry، حتى أن مجرد الارتباط بالعابدين للبعل يكفي أن يعطي للإنسان هذا اللقب، حتى وإن لم يمارس الزنى(13). ولعل هذا الرأي أقرب إلى الحقيقة فقد ارتبطت غالبيّة الإسرائيليات في ذلك الحين أن لم يكن كلهن بعبادة الوثن، حتى صار يصعب، وربما يستحيل أن يجد النبي امرأة له إلاّ من عابدات البعل، لكن ليس جميعهن كن يمارسن الزنى جسديًا.
ثانيًا: يرى قلة من الدارسين أن ما ورد في هذا الأصحاح والأصحاح الثالث لم يكن إلاّ مجرد رؤيا أو قصة رمزية، قدمت للشعب للكشف عن بشاعة سقوطهم وانحرافهم عن عبادة الله الحيّ وخيانتهم له عوض الالتزام بالعهد المقدس معه، ومع هذا كله فالله يطلبهم ويود أن يردهم إليه مقدسًا إياهم؛ غير أن غالبيّة الدارسين يرون أن ما جاء هنا هو حقيقة واقعة وأن الله أراد أن يختبر النبي المرارة الشديدة معه بسبب انحراف إسرائيل، ويعلن للبشريّة مدى رعاية الله وحبه للإنسان. وكما يقول الأب شيريمون: [وصفت الكلمة الإلهية اهتمام الله وعنايته بنا على لسان هوشع النبي تحت رمز أورشليم كزانية، التي انحرفت في غيرة مملوءة جحودًا… إنه يقارن أورشليم (النفس البشريّة) بامرأة زانية تطلب رجلًا آخر، ويقارن محبته لنا برجل يموت في محبة عروسه. فصلاح الله ومحبته يعلنهما على الدوام لكل البشر، إنهما لا يغلبان إلاّ بكفِّنا نحن عن الاهتمام بخلاصنا، وهروبنا من اهتمام الله بنا، كما لو أنها قهرت بشرورنا. لذلك فإنها لا تُقارن إلاّ برجل محترق بنيران الحب من أجل امرأته إذ يذوب من أجل محبته لها قدر ما يراها تستخف مستهينة به(14).]
ثالثًا: يرى غالبيّة الدارسين أن النبي تزوج جومر وأحبها جدًا وعندئذ اكتشف ما كانت عليه من زنى (سواء بالمفهوم الجسدي العام أو مجرد الارتباط بعبادة البعل)، فأبقاها له زوجة ولم يطلقها، وإن كان البعض يرى أن النبي قد تزوجها وهو يعلم ماضيها، وأنه ارتضى هذا من أجل الأمر الإلهي محققًا بحياته صورة رمزية لما كان حادثًا بين الله وشعبه.
رابعًا: كلمة “جومر” في العبرية تعني نهاية الكمال خاصة كمال الفشل، أما “دبلايم” فتعني كعكة مزدوجة من التين المضغوط أو أقراص الزبيب. وكان هذا النوع من الكعك يستخدم في الاحتفالات الخاصة بعبادة البعل، إذ قيل عن بني إسرائيل أنهم: “ملتفتون إلى الآلهة الغريبة ومحبون لأقراص الزبيب” (3: 1). وكأن أكل الكعك المحشو بأقراص الزبيب أو التين قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بعبادة الآلهة الغريبة. هكذا زواج هوشع النبي بجومر ابنة دبلايم إنما يشير إلى الارتباط بشعب إسرائيل الذي بلغ كمال الفشل (جومر) المولود عن العبادة الوثنية ورجاساتها (دبلايم)، أو كأن إسرائيل وقد صارت جومر إنما هي ابنة دبلايم، أي ابنة الحفلات الرجسة التي انتشرت في كل البلاد. صارت أشبه بكعكة مقدمة للبعل، طعامًا رجسًا ومائدة نجسة للشيطان وأتباعه!
كما بقيت جومر في شرها تلد أبناء زنا بالرغم من زواجها من رجل طاهر ونبي مبارك هكذا بقى إسرائيل في زناه الروحي بالرغم من إعلانات الله له عن اتحاده معه. لم يتنجس هوشع بسبب جومر بل صارت جومر في دينونة أقسى من أجل زواجها بالنبي ما لم تكن قد ندمت ورجعت بالطهارة إلى رجلها، وهكذا أن لم يرجع إسرائيل بالإيمان إلى الله تكون عقوبته أشد وأمرّ!
يرى القديس جيروم في جومر الزانية صورة رمزية للكنيسة، إذ يقول: [ماذا أقول عن زواج النبي بزانية، هذه التي هي رمز للكنيسة التي جُمعت إما من الأمم أو اليهود؟! فقد أُقيمت أولًا بواسطة إبراهيم من عابدي الأوثان، والآن قد جحدت المخلص فأكدت أنها خائنة له. لهذا فهي تُحرم إلى فترة طويلة من مذبحها وكهنتها وأنبيائها، وتبقى أيامًا طويلة حتى تعود إلى رجلها الأول (2: 7؛ 3: 11)، إذ يكمل الأمم يخلص إسرائيل (رو 11: 25 – 26)(15).]
ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [كما أنه في القديم أخذوا زانيات كزوجات لهم، هكذا قبِل الله الطبيعة التي قامت بدور زانية كعروس له (بلا فساد)، وقد أعلن الأنبياء من البداية أن هذا قد حدث بالنسبة للمجمع اليهودي (إر3؛ حز 23: 4 – 5، 11). لكن هذه العروس كانت جاحدة بالنسبة لرجلها، أما الكنيسة فإذ خلصت من الشرور التي قبلتها عن آبائها استمرت محتضنة عريسها(16).]
يقول الرب لهوشع: “لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب” [ع1]، وجاءت الترجمة اليونانية: “لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب”، وكأن الزنا إنما هو وضع طبيعي للإنسان بتركه الرب وانحلاله عن الاتحاد مع عريس نفسه الأبدي. والعجيب أن الله لا يقول: “لأن إسرائيل” بل يقول: “لأن الأرض”، وكما رأينا في المقدمة أن إسرائيل بانحنائها نحو الأمور الأرضية صارت أرضًا بلا سماء. أقول أننا إذ نلتحم بالتراب نسمع الصوت الإلهي: “لأنك تراب (أرض) وإلى تراب تعود” (تك 3: 19)، نعود إلى حيث اشتهى القلب وتحول إليه. أما إذا خلعنا الإنسان الترابي القديم الذي لبسناه بانتسابنا لآدم الترابي، ولبسنا الإنسان الجديد الذي على صورة يسوعنا السماوي فنسمع الصوت الإلهي: “لأنك سماء وإلى السماء تعود”. لقد حملت فيك السماوي وصار إنسانك الداخلي سماء، لذا تعود إلى حيث اشتهيت وإلى ما صرت عليه، إلى السماء عينها!
إذ صرنا أرضًا بتركنا العريس السماوي، ماذا يفعل معنا هذا العريس المحب لعروسه؟ لقد حمل جسدنا الترابي لكن بغير فساد، ونزل إلى أرضنا التي التصق قلبنا بها دون أن يكون للزمنيات موضع في قلبه، وإنما ليجعل منا “أرضًا جديدة وسماء جديدة” (رؤ 21: 1)، الأرض التي قيل عنها يسكنها البرّ نفسه أيّ الرب السماوي سر تبريرنا.

3. هوشع أولاد زنى

لم يطلب منه الرب أن يتزوج بامرأة زانية فحسب، وإنما ينجب منها أولاد زنى، يحدد الله أسماءهم: يزرعيل ولورحامة ولوعمي. لا يعني هذا أنهم ثمرة زنا، وإنما مجرد ميلادهم من أم زانية كانت مرتبطة بالبعل أو الوثنية حُسبوا أولاد زنى، مع أنهم أبناء النبي(17)، إلى أن يقبلوا رسالة أبيهم ويرفضوا روح أمهم القديم.
أولًا: “يزرعيل تعني “الله يزرع”، الولد الأول لهوشع وجومر، وهو يشير إلى أن ما يزرعه فينا من تأديبات إنما هو ثمر عملنا. يزرعيل يذكرنا بما فعله ياهو مع يورام بن آخاب وإيزابل الشريرة التي قتلت وورثت حقل نابوت اليزرعيلي، فلحست الكلاب دمها في ذات الحقل الذي اغتصبه (1 مل 9-10). لقد طلبت الحقل اغتصابًا وسفكت دمًا بريئًا لنواله، فنالت شهوة قلبها، نالت هلاكًا في نفس الموضع، كثمرة طبيعية لتصرفاتها. يقول الرب عن بني إسرائيل: “صاروا رجسًا كما أحبوا” (9: 10). ما يحبه الإنسان إنما يناله بثماره الطبيعية. من أحب الأرض الزائلة وشهوات الجسد الفاسدة نال فسادًا وصار أرضًا، ومن أحب الله السماوي الأبدي ينعم بالحياة الخالدة.
ثانيًا: “لورحامة” تعني (لا أرحم). عندما لا يرحم الإنسان نفسه يسقط تحت الارتباط بعبادة البعل لا يتوقع رحمة من قبل الله، فإن الاستهانة بطول أناة الله ورحمته يذخر غضبًا في يوم الغضب (رو 2: 5).
يقول الرب: “لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضًا بل أنزعهم نزعًا، وأما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان” [ع6-7].
لقد انغمس إسرائيل في الشر فانسحب عن الله مخلصه، لا يستطيع القوس ولا السيف ولا الخيل ولا الفرسان أن تخلصه، أما يهوذا الذي يشير إلى كنيسة العهد الجديد التي هي جسد المسيح الخارج من سبط يهوذا فخلاصها إنما بالرب إلهها.
يقول عن المخلص: “الرب إلههم”، فمن جهة ينسب نفسه إليهم بكونه إلههم إذا تقدسوا فصار معتزًا بهم كما يدعو نفسه إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب، ولا ينسب نفسه للأشرار، إذ يقول لهم: “وأنا لا أكون لكم” [ع9]، والترجمة اليونانية: “أنا لست يهوه بالنسبة لكم”.
يقول الرب: “أخلصهم بالرب إلههم”، فالمتحدث هو الآب عن الابن المخلص.
وكما يقول الأب نوفاتيان: [إن كان الله يقول أنه يخلص بالله، وإذ هو لا يخلص إلاّ بالمسيح، فلماذا يتردد إنسان ما في دعوة المسيح الله، مادام الآب يعلن ذلك في الكتاب المقدس؟! نعم أن كان الله الآب لا يخلص إلاّ بالله، فلا يستطيع أحد أن يخلص بواسطة الله الآب ما لم يعترف أن المسيح هو الله، الذي فيه وبه يعد الله أن يهب خلاصه(18).]
ثالثًا: “لوعمي” وتعني (ليس عمي) أو (ليس شعبي)، لأن كلمة “عم” في الكلدانية تعني (شعب) أو (قبيلة). فإن كانت الخطية تلد “لا رحمة”، فإن مرارة عدم الرحمة هي حرمان الإنسان من الانتساب لله أو حرمانه من انتساب الله له. فمن كان منتسبًا للبعل كيف يمكن أن ينتسب لله؟ غاية ما ننعم به هو التمتع بأورشليم الجديدة النازلة من السماء (رؤ 21: 2) التي هي “مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبًا والله نفسه يكون معهم إلهًا لهم” (رؤ 21: 3).

4. هوشع شوق للعودة

يمزج الله التأديب بالرجاء، إذ يعلن هنا أن تأديباته ليست مطلقة وأن رفضهم ليس كليًا وإنما إلى حين، فهو ينتظر عودتهم إليه ليردهم في أكثر بهاء ومجد، يردهم مملكة واحدة قوية وعظيمة، متمتعة بالنبوة له مغروسة فيه، ويكون رأسًا لها، إذ يقول: “لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يُكال ولا يُعد، ويكون عوضًا عن أن يُقال لستم شعبي يُقال لهم: أبناء الله الحيّ، ويجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معًا، ويجعلون لأنفسهم رأسًا واحدًا، ويصعدون من الأرض، لأن يوم يزرعيل عظيم” [ع10-11].
وسط التأديب المر يقدم وعدًا جديدًا، يدخل معهم في عهد جديد تحقق لا برجوعهم من السبي بل بالأكثر بتمتعهم بالعصر الميساني، وهذه هي ملامحه:
أولًا: “يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يُكال ولا يُعد”، وكأنه يحقق الوعد الذي سبق فأعلنه لإبراهيم: “وأكثر نسلك تكثيرًا، كالرمل الذي على شاطئ البحر” (تك 22: 17)، الوعد الذي تمسك به يعقوب: “وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة” (تك 32: 12).
حقًا إنه “ولو أحزن (بالتأديبات) فإنه يعود فيرحم حسب كثرة مراحمه” (مرا 3: 32)؛ فبالمسيح يسوع ربنا تتحول النفس الخائرة والعظام اليابسة إلى جيش عظيم جدًا جدًا (حز 37: 10)، تصير لا كأورشليم “مرهبة كجيشٌ بألوية” (نش 6: 4) لا يقدر عدو الخير بكل جيشه وخداعاته أن يقتنصها له، بل تكون كخيل كثيرة قوية تحمل المركبة الإلهية في موكب النصرة، لذا يناجيها عريسها قائلًا: “قد شبهتكِ يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون” (نش 1: 9).
يقول الرسول: “إن يومًا واحدًا عند الرب كألف سنة” (2 بط 3: 8)، والمؤمن أيضًا كاليوم الواحد العابر يصير في المسيح يسوع كألف سنة، يصير حاملًا السمة السماوية (ألفًا) بطاقات قوية وجبارة في الروح، فعوض اليوم يصير سنوات بلا حصر؛ وعوض الضعف البشري يحمل إمكانيات المسيح: فكره وإرادته وسماته ومجده!
هذه هي سمة العصر المسياني الذي حوّل حياتنا البشريّة إلى “حياة في المسيح يسوع”، عوض الهوان صار لنا المجد العلوي الداخلي، وعوض الفكر الزمني صرنا نحيا في السمويات.
ثانيًا: لا تقف الرحمة عند كثرة من جهة العدد، والقوة من جهة الكيف، لكن ما يفرح قلبنا هو انتسابنا لله كأبناء له: “عوضًا عن أن يُقال لستم شعبي يُقال لهم أبناء الله الحيّ”. عوض الرفض نحسب أبناء ورثة الله، ووارِثون مع المسيح الابن الوحيد الجنس! صرنا أولاد الله الحيّ، أحياء بأبينا الحيّ. فقد دعا اليهود البعل الميت أبًا لهم وزوجته عشتاروت أمًا لهم، فحملوا طبيعة والديهم الميتة. هذا الوعد لم يُعطى لليهود فحسب الذين بعد رفضهم سيقبلهم في أواخر الدهور عندما يقبلون المسيا المخلص، وإنما يمس حياتنا نحن الذين من أصل أممي، فقد كنا مرفوضين بسبب رفضنا له، والآن فتح لنا باب البنوة له. وكما يقول القديس أغسطينوس: [حتى الرسول فهم هذا القول كشهادة نبوية عن دعوة الأمم الذين لم يكونوا قبلًا منتسبين لله. وإذ صار هذا الشعب الذي من الأمم أولادًا لإبراهيم روحيًا، لذا دُعوا بحق “إسرائيل” لهذا يكمل قائلًا: “ويُجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معًا ويجعلون لأنفسهم رأسًا واحدًا(19).]
ثالثًا: تُعلن مراحم الله الفائقة في العصر المسياني خلال وحدتنا معًا في المسيح يسوع الرأس الواحد “ويجعلون لأنفسهم رأسًا واحدًا”. بقبولهم الإيمان بالمسيح يسوع والتمتع بالنبوة لله خلال المعمودية يجعلون لأنفسهم رأسًا واحدًا.
لا يقل: “يجتمعون معًا تحت ملك واحد”، إنما يبرز كمال الوحدة بكون المخلص رأسًا لا يمكن للجسد أن ينفصل عنه! إنه حب فائق، ورباط بين الخالق وخليقته المحبوبة لديه لا يمكن التعبير عنه!
رابعًا: نرتبط معًا في الرأس السماوي فنحمل طبيعته العلوية ونصعد عن طبيعتنا الترابية الأرضية، إذ يقول: “ويصعدون من الأرض”. وكما يقول الرسول: “فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض” (كو 3: 1-2)، إذ صرنا لسنا من العالم (يو 15: 19) بل سيرتنا في السموات (في 3: 20).
بالمسيح يسوع نصعد عن طبيعتنا الأرضية القديمة، لننعم بالطبيعة الجديدة السماوية التي على صورة خالقنا، مرنمين بحق: “هلم نصعد إلى جبل الرب”. إنه خروج لا من أرض مصر نحو أرض الموعد، لكنه صعود جديد من الأرض التي استعبدت النفس وقبلت فيها فرعون (إبليس) ملكًا يذل الشعب. صعود تحت قيادة السيد المسيح نفسه، لا لينطلق بنا إلى جبل سيناء حيث البروق والرعود والجبل المدخن، وإنما للاتحاد مع السيد المسيح الجبل المقدس ليدخل بنا بروحه القدوس إلى حضن أبيه.
خامسًا: يختم الوعد بقوله: “لأن يوم يزرعيل عظيم”. بعد أن كان “يزرعيل” يمثل تهديدًا ومرارة حيث يقدم لنا الله ثمر خطايانا تأديبًا لنا، صار “يزرعيل” يمثل وعدًا، إذ تعني الكلمة “الله يزرع”، فيزرعنا بيديه غرسًا جديدًا مقدسًا (إش 6: 13)، يزرعنا أعضاء جسد ابنه الوحيد، نرتوي بمياه الروح القدس ونحمل برّ المسيح فينا. يُطعمنا في الجنب المطعون فنستقي الحياة عينها عوض الموت الذي كان لنا. هذا هو ما يؤكده لنا الله: “وأزرعها لنفسي في الأرض، وأرحم لورحامة وأقول للوعمي أنت شعبي، وهو يقول: أنت إلهي” (2: 23).