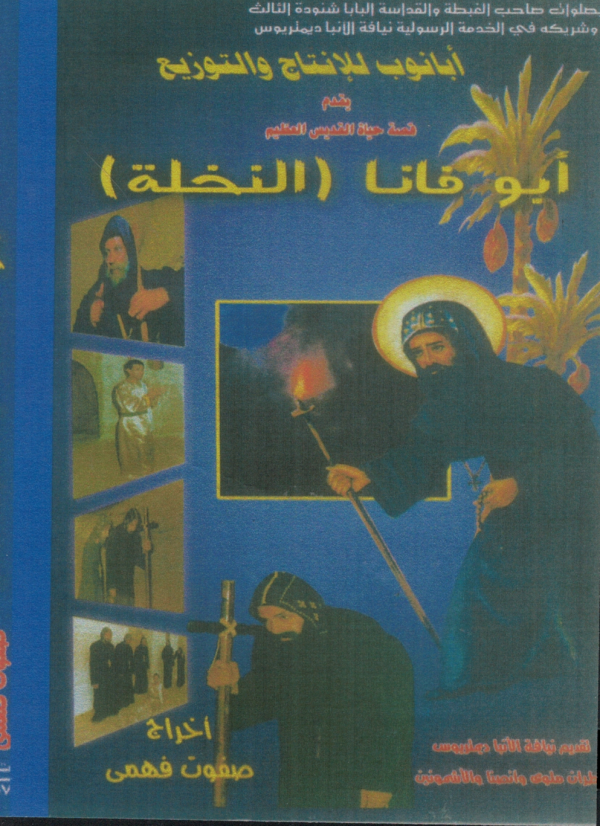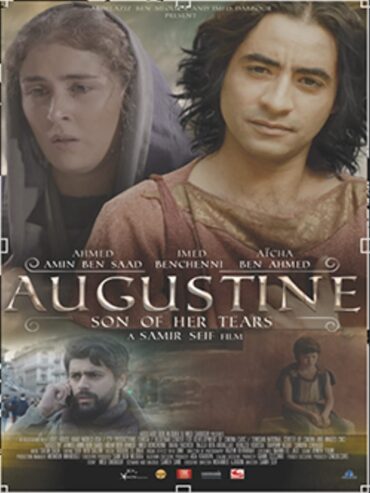تأملنا حتى الآن في ست صفات جميلة للحمام ظهرت بالارتباط بنوح، والآن نتابع الحديث عن الحمام من زاوية أخرى:
(2) الحمامة بين صمتها وهديرها
لكل طائر صوت متميز، حتى أننا يمكننا أن نعرف اسم الطائر من سماع صوته. وما أكثر التباين بين أصوات الطيور، فبينما نجد أصواتًا شجية، تحمل أنغامها معاني الفرح والبهجة، نجد أصواتًا أخرى رتيبة هادئة، تحمل ألحانها معاني الحزن والشجن.
ونحن لسنا بصدد الحديث عن أصوات الطيور المختلفة والمتباينة بصفة عامة، إلا أننا سنتوقف عند صوت الحمامة موضوع تأملاتنا، والذي أُشير إليه أكثر من مرَّة في كلمة الله. وإن كانت آذاننا الطبيعية لا تميز ما تريد الحمامة أن تُعَبر عنه، إلا أن الروح القدس – الكاتب الإلهي لكلمة الله – أشار إلى أكثر من معنى، يمكن أن يُعبِّر عنه صوت أو هدير الحمامة.
بل إننا نرى في صمت الحمامة، عندما تُؤْثِر الصمت، مغزى ومعنى نفهمه من عنوان مزمور 56 .
الحمامة البكماء بين الغرباء
ليس من طابع الحمامة أن تبقى صامتة، فهي تعرف أن تُعبِّر عن مشاعرها من خلال هديرها الهادئ العميق، غير أنه توجد حالة تُبرزها لنا كلمة الله عندها تتوقف الحمامة عن الغناء تمامًا، ولا يُسمع لها أي صوت، وذلك عندما تجد نفسها وحيدة مُحاطة بالغرباء. إنها لا تأنس هذا الجو المشوب بالوحشة، ولا تعرف أن تتآلف أو تتعايش معه. إن الحمامة في طبيعتها رقيقة حسَّاسة، سريعة التأثر، وبصمتها هذا تُعبِّر عن حزنها الداخلي ومشاعرها المرهفة.
وإذ نتفكَّر في صمت الحمامة البليغ، ألا نتذكر شخص الرب يسوع الذي – في أيام تجسده – كان يلزم أحيانًا كثيرة الصمت، إذ يجد نفسه محاطًا بالغرباء والأعداء؟!
انظر إليه وهو أمام بيلاطس وهو يستحثه على أن يتكلم قائلاً له: «من أين أنت؟»، غير أن الكتاب يذكر لنا صراحة «وأما يسوع فلم يعطه جوابًا» (يو19 : 9). حتى أن بيلاطس قال له بعد ذلك بغضبٍ: «أما تُكلمني؟!» (يو19: 10).
وانظر إليه وهو أمام هيرودس الدنس، عندما «سأله بكلام كثير»، آملاً أن يرى آية تُصنع منه، غير أن الكتاب يذكر أيضًا «فلم يجبه بشيء» (لو 8:23، 9). رغم أن الكهنة والكتبة كانوا «يشتكون عليه باشتداد». الأمر الذي جعل هيرودس يحتقره مع عسكره (لو23: 10، 11).
وانظر إليه أيضًا وهو محاط بمجموعة من العسكر الذين كانوا يهزأون ويسخرون به، وانطبقت عليه الكلمات: «صرت لهم مثلاً. يتكلَّم فيَّ الجالسون في الباب وأغاني شرَّابي المسكر» (مز69: 11، 12). وكلمات إشعياء النبي «ظُلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه!!» (إش53 : 7).
لقد تُرك من أحبائه وتلاميذه، الذين هربوا، وها هو وسط الأعداء يُعبِّر عن مشاعره الحزينة بصمت بليغ عميق. فما أحلاه إذا تكلم، وما أمجده إذا صمت، فإنه في صمته يتكلم بشكل أعمق إلى الضمائر ويحركها.
كان طابع الرب في كل هذه المواقف هو الصمت، إلا أنه في مواقف معينة استلزم أن يتكلم، وكان ذلك لهدف معين ومحدد، سواء أمام استحلاف رئيس الكهنة له، أو إعلان حق يخص مجده تبارك اسمه أمام بيلاطس، أن ليس لأحد سلطان عليه. وإذ نتحول عن ذلك القدوس الفريد البديع، الذي حوى جميع أوصاف الكمال، ونتأمل في واقعنا، ونتساءل: هل تتغير حالتنا وتتبدل تبعًا للمناخ الذي يُحيط بنا؟ أنشعر بالوحدة والوحشة في هذا العالم الموضوع في الشرير؟ أندرك أننا غرباء ونزلاء فيه، وعلينا أن لا تستهوينا ملذَّاته أو مسرَّاته، ولا نُجاريه في أحاديثه وتسلياته، بل بالحري ننفر منه، وننفصل عنه، وبصمتنا نوبخه؟
لقد اختار لوط أرض سدوم وعمورة مقامًا ومسكنًا له، باعتبارها كأرض مصر كجنة الرب، متغاضيًا عما فيها من شرور وفساد، آملاً أن يجد فيها الغنى والسعادة. لكن هل استطاع لوط أن يتعايش مع أهل سدوم الأشرار رغم ضعف حالته الروحية؟ وهل استطاع أن يحتفظ بما صار له من غنى وكرامة؟ اسمع ما يقوله الكتاب: «وأنقذ لوطًا البار مغلوبًا من سيرة الأردياء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يُعذِّب يومًا فيومًا نفسه البارة بالأفعال الأثيمة» (2بط2: 7، 8).
نعم لم يستطع لوط، الذي كان كالحمامة الغريبة بين أهل سدوم الأردياء، أن يجد حديثًا مشتركًا بينه وبينهم، فعندما تكلم مرًة مع أهل سدوم الأشرار، أُحتقر ورُذل، وكان جوابهم عليه: «ابعُد إلى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الإنسان ليتغرب، وهو يحكم حكمًا» (تك19: 9). وحينما أراد أن يتكلم مرةً ثانية مع أصهاره المستهترين، «كان كمازح» في أعينهم! (تك19: 14).
ليتنا نُدرك ذلك، ونعلم يقينًا؛ ونحن نعيش في عالم قد وضع في الشرير، أن «كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل» (أم10: 19). فلا نحاول أن نجاري هذا العالم الفاسد الماجن في ضحكاته وهزله وأفراحه الباطلة، بل نستمع إلى نصيحة عاموس: «لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء» (عا5: 13).